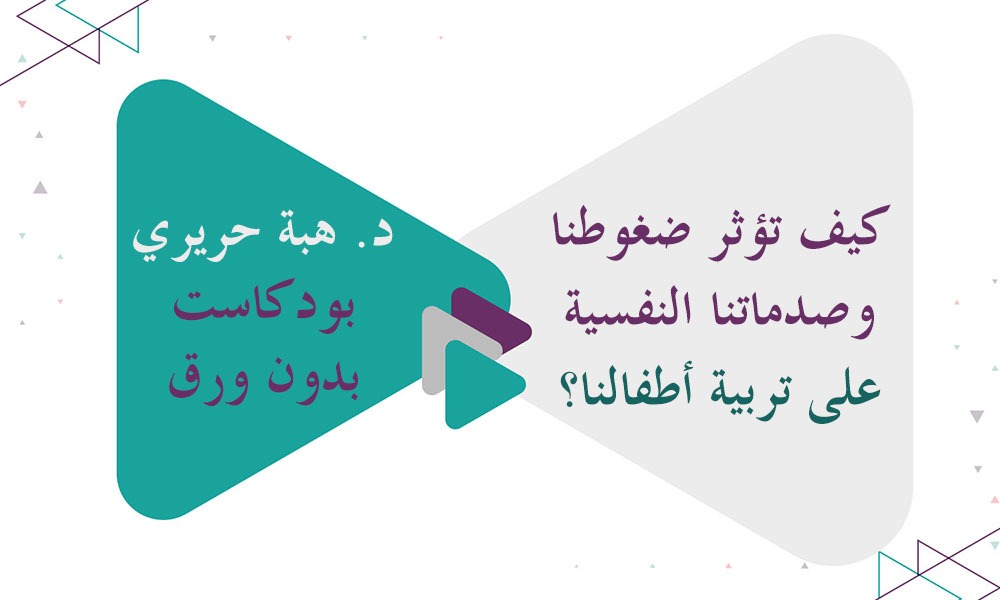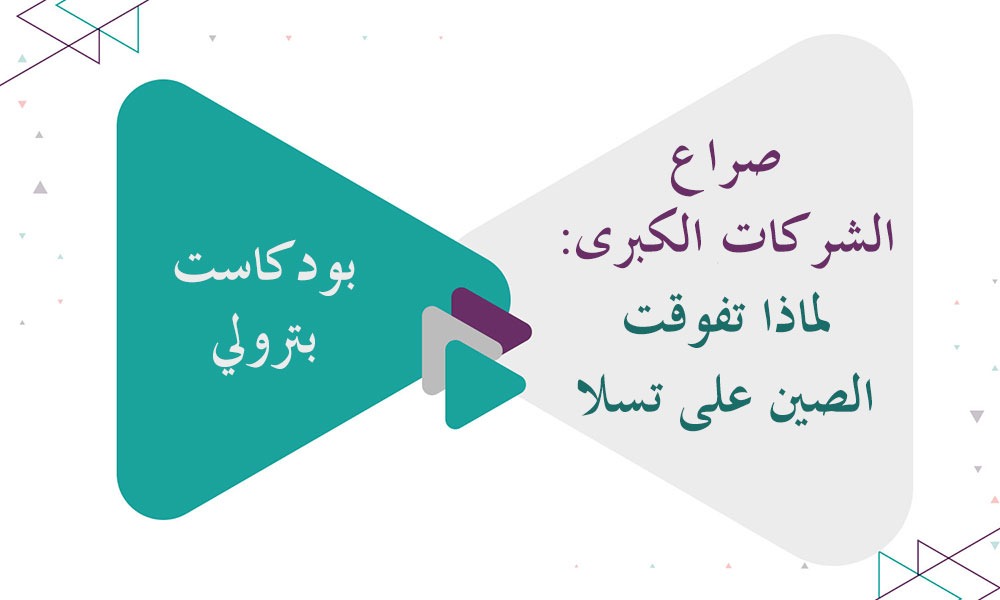تدبر الوعي الحضاري وتحقيق النهضة في القرآن الكريم
د. عبد الكريم بكار
كل نظرية تقود الناس إلى اليأس نظرية خاطئة. كل نظرية تقول للناس: ما في أمل، ارضوا بما هو موجود، ليس هناك فرصة - نظرية خاطئة. الأمم لا تستورد هوياتها؛ لأن الهوية هي الذات، ولذلك تميل الثقافة إلى الثبات، ويعتز الناس بها ويحافظون عليها وينمّونها، ويحاولون وصلها بتاريخهم وبآبائهم وأجدادهم.
كان أبي يقول لي وأنا صغير: اقرأ القرآن وكأنه عليك أُنزل؛ انظر إلى خطابات القرآن كأنها موجّهة لك شخصيًا: تدبّروا، تفكّروا، تسموا به إلى العُلا.
كان أبي يقول لي وأنا صغير: اقرأ القرآن وكأنه عليك أُنزل؛ انظر إلى خطابات القرآن كأنها موجّهة لك شخصيًا: تدبّروا، تفكّروا، تسموا به إلى العُلا.
افتتاح الحلقة
أهلًا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تدبّر في موسمه الخامس. يظلّ الوعي بالحضارة أهمّ الأسلحة لدى الإنسان لفهم طريق النهضة وكيف تنهض الشعوب. الفهم العميق للحضارة والتمييز بينها وبين الثقافة موضوعٌ شديد الأهمية للإنسان كي يعرف كيف يصل إلى النهضة ويحقّقها، وإلى الوعي الحضاري. وإلى جانب استلهام الوعي بالحضارة، تبرز أهمية تدبّر القرآن وكيف يساعدنا في الوصول إلى الوعي الحضاري وتحقيق النهضة.
في هذه الحلقة نناقش موضوع الوعي الحضاري. أهلًا وسهلًا بكم، حيّاكم الله دكتور عبد الكريم بكّار، نوّرتمونا. بدايةً: عندما نتحدّث عن الوعي الحضاري، هل يمكن أن نعرّف الوعي والحضارة؟
في هذه الحلقة نناقش موضوع الوعي الحضاري. أهلًا وسهلًا بكم، حيّاكم الله دكتور عبد الكريم بكّار، نوّرتمونا. بدايةً: عندما نتحدّث عن الوعي الحضاري، هل يمكن أن نعرّف الوعي والحضارة؟
تعريف الوعي
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حيّاكم الله أخي الكريم.
الوعي حقيقةً هو الإدراك العميق، وغالبًا يكون إدراكًا للذات وللأشياء. نقول: وعيٌ اقتصادي، أو وعيٌ دعوي، أو وعيٌ زراعي… أي وعيٌ بالذات وبمحيط الذات أو بالقضيّة موضع الاهتمام.
فلما نقول الوعي الحضاري فالمعنى: الإدراك العميق للحضارة—كيف تنشأ الحضارة؟ كيف تموت الحضارات؟ كيف تنهض الحضارات؟ ما الحضارة في أساسها؟ ما يتّصل بشأنها كلّه.
الوعي حقيقةً هو الإدراك العميق، وغالبًا يكون إدراكًا للذات وللأشياء. نقول: وعيٌ اقتصادي، أو وعيٌ دعوي، أو وعيٌ زراعي… أي وعيٌ بالذات وبمحيط الذات أو بالقضيّة موضع الاهتمام.
فلما نقول الوعي الحضاري فالمعنى: الإدراك العميق للحضارة—كيف تنشأ الحضارة؟ كيف تموت الحضارات؟ كيف تنهض الحضارات؟ ما الحضارة في أساسها؟ ما يتّصل بشأنها كلّه.
تعريف الحضارة
الحضارة عبارة عن نظمٍ مرتقيةٍ ومتقدّمة: نظمٌ اقتصادية وسياسية واجتماعية، ونظمٌ في العلاقات والإنتاج… هذه النظم المرتقية تُسمّى حضارة؛ لأنّ هناك نظمًا بدائيةً موجودةً في كلّ المجالات. وعندما ترتقي الأمم ترتقي النظمُ لديها.
الوعي الحضاري إذن: إدراكٌ عميقٌ لكيفية ارتقاء النظم - كيف نرتقي اجتماعيًا؟ سياسيًا؟ صناعيًا؟ يغلب على مفهوم الحضارة الجانبُ الماديّ، مع أنّها ارتقاءٌ شامل؛ فالإنسان يصعب تجزئته. الحضارة تقدّمٌ شامل يغلب عليه التقدّم الماديّ والمحسوس.
الوعي الحضاري إذن: إدراكٌ عميقٌ لكيفية ارتقاء النظم - كيف نرتقي اجتماعيًا؟ سياسيًا؟ صناعيًا؟ يغلب على مفهوم الحضارة الجانبُ الماديّ، مع أنّها ارتقاءٌ شامل؛ فالإنسان يصعب تجزئته. الحضارة تقدّمٌ شامل يغلب عليه التقدّم الماديّ والمحسوس.
الفرق بين الحضارة والثقافة
نتحدّث كثيرًا عن الثقافة والحضارة. الثقافة تأخذ الجانب الروحيّ والمفاهيميّ والأخلاقيّ والعادات والتقاليد؛ أي إنّها ألصقُ شيءٍ بالهوية.
ولذلك، الأمم تستورد منتجات الحضارة - نستورد السيارة، والميكروفون، والملابس - ولا حرج. أمّا الهويات فلا تُستورد؛ لأنّ الهوية هي الذات. الثقافة تميل إلى الثبات، ويعتز الناس بها ويحافظون عليها وينمونها ويصلونها بتاريخهم وبآبائهم وأجدادهم. تميل الثقافة إلى قدرٍ من الجمود والثبات مع تطوّرٍ بطيء، بينما الحضارة تطوّرٌ وتغيّرٌ مستمران، وهي رحبة. لا حرج في الأخذ والعطاء على الصعيد الحضاري.
ولذلك، الأمم تستورد منتجات الحضارة - نستورد السيارة، والميكروفون، والملابس - ولا حرج. أمّا الهويات فلا تُستورد؛ لأنّ الهوية هي الذات. الثقافة تميل إلى الثبات، ويعتز الناس بها ويحافظون عليها وينمونها ويصلونها بتاريخهم وبآبائهم وأجدادهم. تميل الثقافة إلى قدرٍ من الجمود والثبات مع تطوّرٍ بطيء، بينما الحضارة تطوّرٌ وتغيّرٌ مستمران، وهي رحبة. لا حرج في الأخذ والعطاء على الصعيد الحضاري.
مثال مُبسِّط: السيارة بين الحضارة والثقافة
السيارة كمنتَجٍ: حضارة. دولٌ متخلّفة غارقة في الأميّة والجهل لا تستطيع صناعة سيارات؛ إذ يلزمها درجة من الإبداع وتنظيم حضاري.
قيادة السيارة: ثقافة. الناس يقودون بطرائق مختلفة؛ من يزمّر لأدنى تأخير، ومن يقدّر ظرف غيره. احترام المشاة والالتزام داخل المدن… كلّ ذلك من الثقافة.
وكذلك الملابس: المصنع يصنع موديلات كثيرة (حضارة)، أمّا اختيار طراز معيّن وطريقة اللبس وتناسق الألوان فثقافة. الفنون كالرسم والنحت والشعر—ثقافاتٌ بطابع شخصيٍّ إبداعيّ، بخلاف منطق التراكم التقني في الحضارة.
الحضارة إبداعاتُ مجتمعٍ وأمم، والثقافة إبداعٌ شخصيّ في الغالب.
قيادة السيارة: ثقافة. الناس يقودون بطرائق مختلفة؛ من يزمّر لأدنى تأخير، ومن يقدّر ظرف غيره. احترام المشاة والالتزام داخل المدن… كلّ ذلك من الثقافة.
وكذلك الملابس: المصنع يصنع موديلات كثيرة (حضارة)، أمّا اختيار طراز معيّن وطريقة اللبس وتناسق الألوان فثقافة. الفنون كالرسم والنحت والشعر—ثقافاتٌ بطابع شخصيٍّ إبداعيّ، بخلاف منطق التراكم التقني في الحضارة.
الحضارة إبداعاتُ مجتمعٍ وأمم، والثقافة إبداعٌ شخصيّ في الغالب.
موقع «النهضة» من المفاهيم
النهضة تقدّمٌ شاملٌ في الثقافة والحضارة معًا. خُذ التعليم مثالًا:
مناهج جيّدة، مدرسون جيّدون، إدارة جيّدة… (بعدٌ ثقافي/قيمي/تنظيمي)
مختبرات، مبانٍ جيّدة، ملاعب، تجهيزات… (منتجات حضارية)
لتحقيق نهضة التعليم نحتاج ثقافةً راقية ومنتجات حضارية ونُظُمًا وعلاقاتٍ جيّدة، ووعيًا بهذه العناصر.
لتحقيق نهضة التعليم نحتاج ثقافةً راقية ومنتجات حضارية ونُظُمًا وعلاقاتٍ جيّدة، ووعيًا بهذه العناصر.
معركة الوعي
على صعيد النهضة، معركة الأمة معركة وعي. عندما نعي أهمية شيءٍ ما نعتني بإيجاده. الاهتمام وليد الوعي؛ بعد الوعي يأتي الاهتمام، ثمّ التنفيذ والبحث عن الوسائل والأدوات.
المعركة الثقافية أمام الأمّة: وعيُ أهمية النهضة في الحياة، وأنّ إقامة دينٍ فعّالٍ مُلهِمٍ تتطلّب بيئاتٍ راقيةً حضاريًا وثقافيًا. النهضة عمليةٌ شاملةٌ للمعنويّ والماديّ مع تبادل التأثير بينهما.
المعركة الثقافية أمام الأمّة: وعيُ أهمية النهضة في الحياة، وأنّ إقامة دينٍ فعّالٍ مُلهِمٍ تتطلّب بيئاتٍ راقيةً حضاريًا وثقافيًا. النهضة عمليةٌ شاملةٌ للمعنويّ والماديّ مع تبادل التأثير بينهما.
أمثلة تاريخية وحديثة على أثر الوعي
أمّةُ الإسلام نهضت في بيئاتٍ عربيةٍ قبليةٍ فقيرةٍ جاهلةٍ منهكة، ومع ذلك بَنَت حضارةً قرابة ثمانية قرون، وتغلبت على حضاراتٍ قائمة.
كوريا الجنوبيّة كانت تتلقّى الصدقات، ثمّ ركّزت على التعليم، وأصبحت من مراكز الإبداع عالميًا وتُسجِّل براءات اختراع عديدة، وتُصنَّع أجزاءً من أجهزة عالميّة.
سنغافورة - جزيرة صغيرة - تفوقت دخلًا بأضعافٍ على دولٍ أكبر مساحةً وسكانًا.
خلاصة الرؤية اليابانيّة: الثرواتُ فوق الأكتاف - في العقول - لا تحت الأقدام فقط. والمفهوم الأحدث: مصدر الثروة ما سيكون بعد خمس أو عشر سنوات عندما نمتلك الوعي والاهتمام والإبداع.
كوريا الجنوبيّة كانت تتلقّى الصدقات، ثمّ ركّزت على التعليم، وأصبحت من مراكز الإبداع عالميًا وتُسجِّل براءات اختراع عديدة، وتُصنَّع أجزاءً من أجهزة عالميّة.
سنغافورة - جزيرة صغيرة - تفوقت دخلًا بأضعافٍ على دولٍ أكبر مساحةً وسكانًا.
خلاصة الرؤية اليابانيّة: الثرواتُ فوق الأكتاف - في العقول - لا تحت الأقدام فقط. والمفهوم الأحدث: مصدر الثروة ما سيكون بعد خمس أو عشر سنوات عندما نمتلك الوعي والاهتمام والإبداع.
الثورة التقنية والفرص
التقنية تطوّر أساليب العيش والحياة والعلاقات. نحن نعيش جنون التقنية: كل لحظة منتجٌ جديد أو تطويرٌ لمنتج، وفرصٌ هائلة للتطوّر والإبداع والخلاص من الفقر والجهل.
دخلنا منذ نحو عقد «الثورة الصناعية الرابعة» وثورة الذكاء الاصطناعي التي تتدخّل في كل شيء، وتفتح فرصًا للتغيير والإبداع مع إمكانات قليلة، وتُحسّن ظروفًا كثيرة.
دخلنا منذ نحو عقد «الثورة الصناعية الرابعة» وثورة الذكاء الاصطناعي التي تتدخّل في كل شيء، وتفتح فرصًا للتغيير والإبداع مع إمكانات قليلة، وتُحسّن ظروفًا كثيرة.
قاعدة اليُسر بعد العُسر
كلّ نظريةٍ تقود إلى طريقٍ مسدودٍ نظريةٌ خاطئة. كلّ خطابٍ يشيع اليأس ويصادر الأمل - خطأ. قال تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}. اليُسرُ قائم ويحتاج إلى اكتشاف.
ضعف الحماسة للاكتشاف والاندفاع إليه نتاجٌ تربويّ: مخرجاتُ بيوتٍ ومدارس ومساجد ومجتمعٍ تُشيع عبارة «ليس في الإمكان أبدعُ ممّا كان»، وتُرسِّخ ثقافة العجز. هذا وعيٌ مدمّر.
ضعف الحماسة للاكتشاف والاندفاع إليه نتاجٌ تربويّ: مخرجاتُ بيوتٍ ومدارس ومساجد ومجتمعٍ تُشيع عبارة «ليس في الإمكان أبدعُ ممّا كان»، وتُرسِّخ ثقافة العجز. هذا وعيٌ مدمّر.
جوهر العائق: نفسيّ/فكريّ قبل المادّي
المعوّقات الماديّة موجودة، غير أنّ الجوهريّ منها نفسيٌّ وفكريٌّ وعقليّ: مفاهيم خاطئة وتربية خاطئة وتصوّرات خاطئة وبيئة تخرّج معوَّقين نفسيًا وفكريًا بدل المبدعين والمبادرين والمجتهدين.
الطريق المستقيم ورأس المال القيمي
الطريق الصحيح طريقنا: الأخذ بالأسباب، والرقيّ الروحيّ والنفسيّ والفكريّ والماديّ، ووجهتنا الآخرة. ننجز في الدنيا ونعمرها بإحسانٍ وأمانة، ونُحافظ على الرصيد القيميّ.
لدينا تراكمٌ فكريّ نهضويّ يزيد على قرنين: شروط النهضة، متطلبات الحضارة، عوائق التحضّر… نملك من كل شيءٍ شيءًا، غير أنّ المستوى دون المطلوب: مدارس وجامعات وعلماء وصناعيون وحكّام - جيّدون، لكن بأقل من الحاجة.
لدينا تراكمٌ فكريّ نهضويّ يزيد على قرنين: شروط النهضة، متطلبات الحضارة، عوائق التحضّر… نملك من كل شيءٍ شيءًا، غير أنّ المستوى دون المطلوب: مدارس وجامعات وعلماء وصناعيون وحكّام - جيّدون، لكن بأقل من الحاجة.
التعليم والتربية: الأداة الحاسمة
الطريق المُمَهَّد وحده غير كافٍ ما لم نمتلك «وسيلة النقل»؛ التربية والتعليم هما الأساس:
الأسرة: توعية الأُسَر بأدوارها ووظائفها.
المدرسة الجيّدة: توجيهٌ تربويّ وأخلاقي وبيئةٌ صحيّة تصنع الروّاد والمبدعين وتحفظ الكرامات وتمنح تعليمًا ممتازًا.
هذه المصانع تُنمي الشخصية والوعي والثقافة. كلما تعقّدت الحياة ازدادت الفرص، شريطة إعدادٍ أفضل للأبناء.
هذه المصانع تُنمي الشخصية والوعي والثقافة. كلما تعقّدت الحياة ازدادت الفرص، شريطة إعدادٍ أفضل للأبناء.
القرآن ومنهج إدارة الزمان والخير
القرآن دستورٌ ودليلٌ شامل: أقسم بالفجر والعصر والضحى والليل تنبيهًا لحركة الزمان. ثقافة المسلم تقسيم الوقت واستثماره للعبادة والعلم والعمل والخير.
القيمُ الخيرية راسخة: الصدقات والوقف والمبادرات الصغيرة—روحُ العطاء ممتدّة. {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ}: امتلاء الحياة بالأعمال النافعة، علمًا وعبادةً وخدمةً للناس.
القيمُ الخيرية راسخة: الصدقات والوقف والمبادرات الصغيرة—روحُ العطاء ممتدّة. {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ}: امتلاء الحياة بالأعمال النافعة، علمًا وعبادةً وخدمةً للناس.
التدبر فرضُ منهجٍ لا ترفٌ ذهني
القرآن محفوظٌ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}، والمطلوب التدبّر: فهمٌ عميق، استحضار الخطاب الإلهي كأنه موجّهٌ إليك: أين أنا من هذا المعنى؟ من هذا الخلق؟ من هذا النهي والأمر؟
الواجب الجمع بين الحفظ والتدبّر. يُخصَّص في حلقات القرآن ومدارسه 10–15% للتدبّر: سياق الآية، أسباب النزول، ما الذي سيتغيّر في حياتنا بالعمل بها؟ هكذا يصبح التدبّر قضيةً أساسية تمنح مفاتيح سعادة الدنيا والآخرة.
الواجب الجمع بين الحفظ والتدبّر. يُخصَّص في حلقات القرآن ومدارسه 10–15% للتدبّر: سياق الآية، أسباب النزول، ما الذي سيتغيّر في حياتنا بالعمل بها؟ هكذا يصبح التدبّر قضيةً أساسية تمنح مفاتيح سعادة الدنيا والآخرة.
ورد القرآن وحدٌّ أدنى للاقتداء
الحدّ الأدنى: قراءة جزءٍ يوميًا؛ ختمةٌ شهرية تزيد نور الهداية بالقرآن ومعايشته. يمكن التقدّم مع وردٍ أقلّ، غير أنّ إعراض الأمّة عن الإكثار يُحدث خللًا كبيرًا. المطلوب بقاء الصلة حيّة: تلاوةٌ، وحفظٌ، وتدبّرٌ.
النقد بوصفه رئة الحضارة
النقد تقويمٌ للمخرجات: إبراز محاسن ومساوئ، وقياس نسب الإنجاز، واعتماد «التغذية الراجعة». الناس يسرّون بمن يبيعهم الأوهام، ويتضايقون ممن يخلّصهم منها، مع أنّ النقد رئةُ الحضارات.
علماؤنا أنشؤوا علومًا قائمةً على النقد لصون الحديث: الجرح والتعديل، علم الرجال، علم الإسناد. الإنصاف شرطُ النقد: التاريخ والتراث يُنقدان، أمّا الكتاب والسنّة فحاكمان على التراث. المجتهد المصيب له أجران، والمخطئ له أجر الاجتهاد.
علماؤنا أنشؤوا علومًا قائمةً على النقد لصون الحديث: الجرح والتعديل، علم الرجال، علم الإسناد. الإنصاف شرطُ النقد: التاريخ والتراث يُنقدان، أمّا الكتاب والسنّة فحاكمان على التراث. المجتهد المصيب له أجران، والمخطئ له أجر الاجتهاد.
التغيير السلمي وخيارات النهضة
التغيير السلمي أداةٌ أساسية لبناء الحضارات داخل الدولة والمؤسسات والمجتمع. العنف يحمل روح الإكراه ويعطّل الإبداع الذي ينمو في أجواء الحرية والسلام. تُضيَّق دوائر العنف ما أمكن، ويُتعامَل معه كجراحةٍ دقيقةٍ عند الضرورة القصوى.
دخول قبائل الجزيرة في الإسلام جرى بتضحياتٍ محدودة قياسًا بالمساحة والسكان، لأن التركيز كان على الدعوة والإقناع وتغيير القناعات.
دخول قبائل الجزيرة في الإسلام جرى بتضحياتٍ محدودة قياسًا بالمساحة والسكان، لأن التركيز كان على الدعوة والإقناع وتغيير القناعات.
خطواتٌ عملية نحو الوعي الحضاري وبناء المؤسسات
التغيير السلمي أداةٌ رئيسة في إصلاح الدول والمؤسسات والإدارات والوظائف. العنف يحمل روح الإكراه ويضعف الرغبة في التعلّم والعمل والإبداع. تُعامَل الشدّة باعتبارها «جراحة دقيقة» تُحسن تقديرها وتضييق دائرتها.
شهدت الجزيرة العربية دخولًا واسعًا في الإسلام بتضحيات محدودة قياسًا بالمساحة والسكان؛ لأن التركيز انصبّ على الدعوة والإقناع وتبديل القناعات وتغيير المفاهيم والدلالة على طريق الحق.
شهدت الجزيرة العربية دخولًا واسعًا في الإسلام بتضحيات محدودة قياسًا بالمساحة والسكان؛ لأن التركيز انصبّ على الدعوة والإقناع وتبديل القناعات وتغيير المفاهيم والدلالة على طريق الحق.
في المقابل، تكشف الحروب الحديثة كلفةً بشريةً وماديةً باهظة؛ يبرز لهذا المثال ما جرى في غزة: عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وخسائر هائلة، وكل ذلك يبرهن أنّ طريق البناء الحضاري يتناغم مع السِّلم والحرية والبيئات الآمنة التي تُطلق الطاقات وتوجّه الموارد نحو الإبداع والتحسين.
# الحاجة إلى طبقةٍ من المفكرين الكبار
في المشكلات الحضارية القديمة المتوارثة يظهر وفرةٌ في المتخصصين وندرةٌ في المفكرين. المفكّر يرى الواقع بحجمه الحقيقي، ويقرأ سنن الله في الخلق، ويستوعب تجارب المسلمين والأمم الأخرى ويقترح الأدوية المناسبة.
الدعوة موجّهة إلى القراءة في كتب الفكر وكبار العلماء والمتخصصين، وتجنّب المعلومات السطحية، لبناء عقلٍ استراتيجي يوازن بين المعارف الشرعية والخبرات الإنسانية.
الدعوة موجّهة إلى القراءة في كتب الفكر وكبار العلماء والمتخصصين، وتجنّب المعلومات السطحية، لبناء عقلٍ استراتيجي يوازن بين المعارف الشرعية والخبرات الإنسانية.
# الأسرةُ أوّلُ مصنعٍ للقيم والعقول
توعية الأسر بأدوارها ووظائفها ركيزةٌ لإنشاء شخصيةٍ رائدةٍ قليلة العلل الفكرية والنفسية. وقد خُصِّصت «سلسلة التربية الرشيدة» لتوجيه الأسرة نحو بناء الإيمان والأخلاق والعادات الحسنة ومهارات الحياة، مع عنايةٍ خاصةٍ بالبيئة الهادئة المحفّزة، والقدوة الحسنة، والحوار المربّي.
# رافعتان لا غنى عنهما: السياسة والتعليم
لا تنهض أمةٌ من دون رافعتين تعملان بتكامل:
- السياسة الرشيدة: سيادةُ قانون، ضمانُ الحقوق، حرياتٌ مصونة، انتخاباتٌ نزيهة، تداولٌ سلميٌّ للسلطة، قضاءٌ عادل.
- التعليم الجيد: مدارسُ قوية في جميع المراحل، تجمع بين التوجيه التربوي والأخلاقي والبيئة الصحية التي تصنع الروّاد وتمنح تعليمًا ممتازًا.
- التعليم الجيد: مدارسُ قوية في جميع المراحل، تجمع بين التوجيه التربوي والأخلاقي والبيئة الصحية التي تصنع الروّاد وتمنح تعليمًا ممتازًا.
# رياضُ الأطفال… تأسيسُ الشخصية العميقة
تشير خبرات التربويين إلى أنّ 80% من الخطوط العميقة في شخصية الطفل تُرسَم بين عمر 3–6 سنوات. في هذه المرحلة يتعلّم اللطف أو الخشونة، النظافة أو الفوضى، النظام أو العبث، الأذكار والسنن والآداب، واحترام الوقت. الاستثمار في رياض الأطفال استثمارٌ في تأسيس شخصيات الأبناء وبناء المجتمع.
# لماذا المدرسةُ قناةُ التكوين الأوسع؟
الجميع يمرّ بالمدرسة، فتغدو المكمّل الأساس لدور الأسرة، وتمنح ما تعجز عنه البيوت منفردة: برمجة، ذكاء اصطناعي، ريادة أعمال، علومٌ تجريبية ورياضية ولغوية. لذلك يهدف الإصلاح إلى مدرسةٍ تمزج بين الهوية الراسخة وكفايات العصر ومنهجيّات التعلّم النشط والتقويم البنّاء.
# إدارةُ الزمن وثقافةُ العمل الخيري
يقسم القرآن بالفجر والعصر والضحى والليل تنبيهًا لحركة الزمان. ثقافة المسلم توزيعُ اليوم على عباداتٍ وأعمالٍ نافعةٍ وعلمٍ وخدمةٍ للناس. تُنمّي الشريعة حبَّ الخير والوقف والمبادرة، ويتجلّى ذلك في صورٍ تاريخيةٍ عديدة: التبرّع بالقليل، وإعارة الأدوات، وتأسيس الأوقاف النافعة. قوله تعالى: **{فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ}** يرسّخ امتلاء الحياة بالجدّ والنافع.
# التدبّر… مناهجُ عملية وتطبيقات
القرآن محفوظ بنصّه، والمطلوب تدبّره: فهمٌ عميقٌ يستحضر الخطاب كأنه موجّهٌ إليك.
تُخصَّص في الحِلَق والمدارس نسبةٌ من الوقت (10–15%) لأسئلة التدبّر العملية: في أي سياقٍ نزلت الآية؟ ما أثر العمل بها؟ ما النتائج حين نتخلّى عنها؟
يجمع القارئ بين ختمةِ سَرْدٍ تُغذّي المداومة، وختمةِ تدبّرٍ بطيئةٍ تتوقّف عند كل آية ومعناها ومقاصد السورة. هكذا يمنح القرآن مفاتيح سعادة الدنيا والآخرة.
تُخصَّص في الحِلَق والمدارس نسبةٌ من الوقت (10–15%) لأسئلة التدبّر العملية: في أي سياقٍ نزلت الآية؟ ما أثر العمل بها؟ ما النتائج حين نتخلّى عنها؟
يجمع القارئ بين ختمةِ سَرْدٍ تُغذّي المداومة، وختمةِ تدبّرٍ بطيئةٍ تتوقّف عند كل آية ومعناها ومقاصد السورة. هكذا يمنح القرآن مفاتيح سعادة الدنيا والآخرة.
#النقدُ الحضاري: تقويمٌ لا هدم
النقد تقويمٌ للمخرجات، وإبرازٌ للمحاسن والمثالب معًا، واعتمادٌ للتغذية الراجعة.
صان علماؤنا الحديثَ بعلومٍ قائمةٍ على النقد: **الجرح والتعديل**، **الرجال**، **الإسناد**. التاريخ والتراث يُنقدان بإنصاف؛ أمّا الكتاب والسنّة فحاكمان عليهما.
يخطئ من يخلط بين نقد التراث ونقد الوحي. أعمال البشر—صحابةً وعلماء ومذاهب—تخضع للاجتهاد والتخطئة والتصويب، مع حفظ المقامات والفضائل. المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر الاجتهاد.
صان علماؤنا الحديثَ بعلومٍ قائمةٍ على النقد: **الجرح والتعديل**، **الرجال**، **الإسناد**. التاريخ والتراث يُنقدان بإنصاف؛ أمّا الكتاب والسنّة فحاكمان عليهما.
يخطئ من يخلط بين نقد التراث ونقد الوحي. أعمال البشر—صحابةً وعلماء ومذاهب—تخضع للاجتهاد والتخطئة والتصويب، مع حفظ المقامات والفضائل. المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر الاجتهاد.
# ختامٌ وبرنامجُ عمل
الطريق واضح المعالم:
1. بناء الوعي الجمعي بقيمة النهضة وأثرها.
2. تمكين الأسرة والتربية القيمية.
3. مدرسةٌ حديثةٌ رصينةٌ الهوية عاليةُ الكفايات.
4. بيئةٌ سياسيةٌ عادلةٌ تؤمّن الحقوق والحريات وسيادة القانون.
5. ثقافة إدارة الوقت والعمل الخيري والمبادرات.
6. نقدٌ منهجيٌّ دائمٌ للأعمال والبرامج.
7. قراءةٌ في الفكر العميق ومتابعة تجارب الأمم.
8. استثمارٌ واعٍ في التقنية والذكاء الاصطناعي وتوطين مهارات المستقبل.
2. تمكين الأسرة والتربية القيمية.
3. مدرسةٌ حديثةٌ رصينةٌ الهوية عاليةُ الكفايات.
4. بيئةٌ سياسيةٌ عادلةٌ تؤمّن الحقوق والحريات وسيادة القانون.
5. ثقافة إدارة الوقت والعمل الخيري والمبادرات.
6. نقدٌ منهجيٌّ دائمٌ للأعمال والبرامج.
7. قراءةٌ في الفكر العميق ومتابعة تجارب الأمم.
8. استثمارٌ واعٍ في التقنية والذكاء الاصطناعي وتوطين مهارات المستقبل.
بهذه المنظومة يتولّد الوعي الحضاري، وتتراكم منجزات الثقافة والحضارة معًا، فتتحقق النهضة على أسسٍ معرفيةٍ وقيميةٍ وعمليةٍ راسخة.