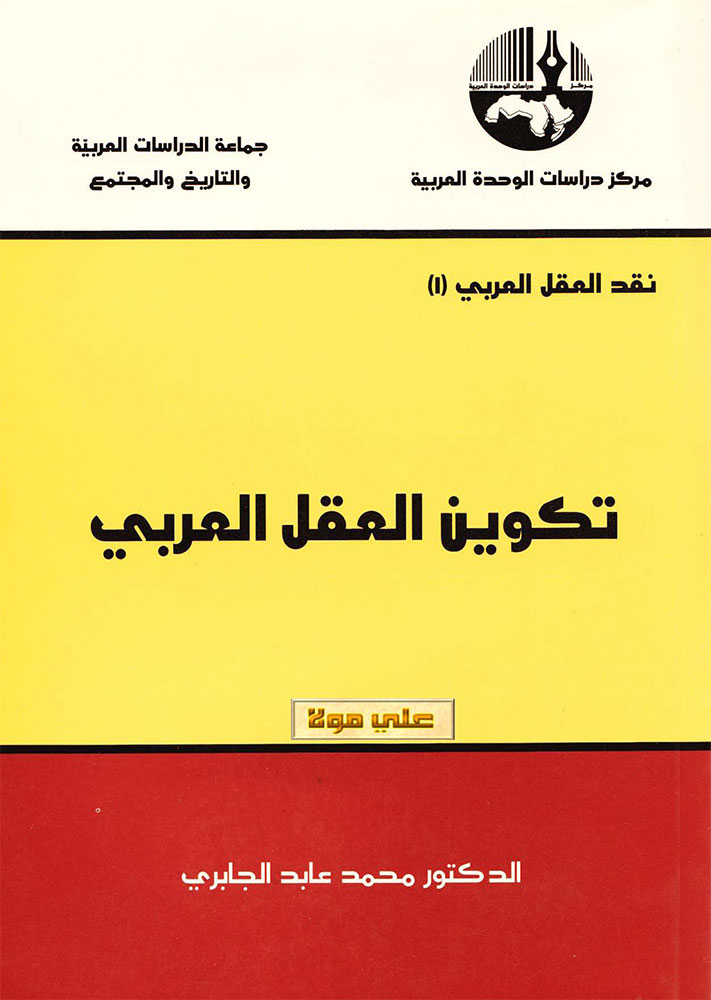تكوين العقل العربي
الدكتور محمد عابد الجابري - مركز دراسات الوحدة العربية
لتحميل الكتاب وقراءته، الرجاء النقر على الرابط التالي:
https://tinyurl.com/5cw9xvsa
يتناول هذا الكتاب موضوعًا كان يجب أن ينطلق القول فيه منذ مائة سنة. إن نقد العقل جزء أساسي وأولي من كل مشروع للنهضة. ولكن نهضتنا العربية الحديثة جرت فيها الأمور على غير هذا المجرى، ولعل ذلك من أهم عوامل تعثرها المستمر إلى الآن. وهل يمكن بناء نهضة بعقل غير ناضج، عقل لم يقم بمراجعة شاملة لآلياته ومفاهيمه وتصوراته ورؤاه؟ كان المفروض إذن أن يكون هذا الكتاب مجرد حلقة في سلسلة طويلة، من الكتب والأبحاث، تمتد على مدى مائة عام. وفي هذه الحال كان سيستفيد حتمًا من الأعمال السابقة له: يتعلم منها ويتجنب تكرار أخطائها ويجتهد في إضافة لبنة إلى صرحها.. وإن هو شعر بأن هذا الصرح في حاجة إلى تفكيك وإعادة بناء، وكان له من الطموح ما يكفي، أقدم على تدشين خطاب جديد في موضوع: لا نقول: جديد، بل متجدد.
ولكن واقع الحال، الآن، عكس ما كان يجب أن يكون، والنتيجة هي أننا في عملنا هذا لا نعاني فقط من غياب محاولات رائدة وأخرى متابعة ومدققة، بل نعاني، وبدرجة أكثر، من آثار هذا الغياب وانعكاساته على الموضوع ذاته. لقد تم خلال المائة سنة الماضية تكريس تصورات وآراء ونظريات، حول الثقافة العربية بمختلف فروعها مما رسم قراءات معينة لتاريخ هذه الثقافة، قراءات استشراقية أو سلفية أو قوموية أو يسراوية توجهها نماذج سابقة، أو شواغل إيديولوجية ظرفية جامعة، مما جعلها لا تهتم إلا بما تريد ان " تكتشفه " أو " تبرهن " عليه. ولما كان العقل العربي الذي نعنيه هنا هو العقل الذي تكون وتشكل داخل الثقافة العربية، في نفس الوقت الذي عمل هو نفسه على انتاجها وإعادة انتاجها، فإن عملية النقد المطلوبة أو على الأقل كما نريدها أن تكون، تتطلب التحرر من أسار القراءات السائدة واستئناف النظر في معطيات الثقافة العربية الإسلامية بمختلف فروعها، دون التقيد بوجهات النظر السائدة.
ومن هنا المهمة المضاعفة التي يطمح هذا المشروع إلى تدشين العمل فيها: استئناف النظر في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية من جهة أولى، وبدء النظر في كيان العقل العربي وآلياته من جهة ثانية. وهكذا انقسم المشروع إلى جزءين منفصلين ولكن متكاملين: جزء يتناول "تكوين العقل العربي"، وجزء يتناول تحليل بنية العقل العربي. الأول يهمين فيه التحليل التكويني، والثاني يسود فيه التحليل البنيوي.
لنلق نظرة خاطفة على هذا الجزء الأول مع الإدلاء بالتوضيحات اللازمة.
يضم هذا الجزء قسمين: الأول مقاربات أولية، فهو شبه المدخل والمقدمات، والثاني تحليل لمكونات الثقافة العربية وبالتالي لتكوين العقل العربي ذاته. لقد كان من الضروري البدء بمقاربات أولية نحدد بواسطتها ومن خلالها تصورنا العام للموضوع: ماذا نعني بـ "العقل العربي؟" ما علاقته بالثقافة العربية؟ ما طبيعة "الحركة" في هذه الثقافة وكيف يتحدد زمنها؟ ثم كيف نفصل في مشكلة البداية: بداية تشكيل العقل العربي والثقافة التي ينتمي إليها؟ وإلى أي إطار مرجعي يجب ربطهما به؟.. يتعلق الأمر إذن بتحديد الموضوع ورسم معالم الرؤية التي نعتمدها، مع التعريف بمضمون بعض المفاهيم الإجرائية الموظفة في البحث.. وقد استغرق الكلام في هذه المسائل الفصول الثلاثة الأولى.
أما في القسم الثاني فقد انصرفنا إلى البحث، في مكونات الثقافة العربية، عن النظم المعرفية التي تؤسسها وتتصادم داخلها. وكان ميداننا في هذه المرحلة الأولى من البحث استخلاص هذه النظم بوصفها مناهج ورؤى، وليس دراستها لذاتها - الشيء الذي سيكون موضوع الجزء الثاني من الكتاب. وفي عملية "الاستخلاص" هذه، سلكنا مسلكًا تكوينيًا، تبنينا "تطور" الثقافة العربية ككل، من البداية التي اخترناها، حريصين على النظر إلى فروع هذه الثقافة (نحو، فقه، كلام، بلاغة، تصوف، فلسفة...) كغرف في قصر واحد، متصلة متراصة، يقود بعضها إلى بعض عبر أبواب ونوافذ... وليس كخيام منعزلة مستقلة منصوبة في ساحة غير ذات سور ولا سياج، كما هو حال النظرة السائدة. لقد قمنا برحلة داخل أروقة الثقافة العربية، رحلة نقدية، انصرف اهتمامنا خلالها إلى أسس هذه الأروقة وأعمدتها، وليس إلى معروضاتها.
ومع ذلك فلقد كان لا بد، ونحن نتحرك في أفق تكويني، من التعامل مع المادة المعرفية وبطانتها الإيديولوجية نوعًا من التعامل. إن البحث في " تكوين العقل العربي "، في موضوع هذا الجزء من الكتاب، يتطلب كما قلنا استئناف النظر في تاريخ الثقافة العربية، في أصولها وفصولها، في أسسها ودروبها. وإذا كانت الثقافة، أية ثقافة، هي في جوهرها عملية سياسية، فإن الثقافة العربية بالذات لم تكن في يوم من الأيام مستقلة ولا متعالية عن الصراعات السياسية والاجتماعية، بل لقد كانت باستمرار الساحة الرئيسية التي تجري فيها هذه الصراعات. إن الهيمنة الثقافية كانت النقطة الأولى، وأحيانًا الوحيدة، المسجلة على جدول أعمال كل حركة سياسية أو دينية بل كل قوة اجتماعية تطمح إلى السيطرة السياسية أو تريد الحفاظ عليها. ومن هنا تلك العلاقة العضوية بين الصراع الإيديولوجي والصدام الإبستيمولوجي في الثقافة العربية، وهي علاقة ما كان يمكن لنا قط إهمالها أو التقليل من أهميتها وفعالها، وإلا فقد التحليل بعده التكويني، أي ما يمنع موضوعه تاريخيته.
ن أخذنا بعين الاعتبار الكامل هذه العلاقة العضوية بين الإيديولوجي والإبستيمولوجي في الثقافة العربية، على الصعيد التكويني، جعلنا نستحضر في كل لحظة أطراف الصراع، الشيء الذي مكّننا، فيما يخيل إلينا، من التحرر من التاريخ "الرسمي" للثقافة العربية الذي يعني فقط بالثقافة التي تشرف عليها الدولة أو تدور في فلكها ويهمل أو يغفل الثقافة "المضادة"، ثقافة المعارضة، وفي أحسن الأحوال يعرضها منفصلة معزولة، على هامش "التاريخ"، هذا في حين أن الواحدة منهما إنما كانت تتحدد، في كل لحظة، من خلال علاقتها مع الأخرى. لقد كان لا بد إذن من النظر إليهما معًا من زاوية الفعل ورد الفعل. وهنا نرجو أن يفهمنا القارئ، المتحزب، أعني الذي ما زال منخرطًا، بصورة أو بأخرى بوعي أو بدون وعي، في صراعات الماضي. لقد تحدثنا هنا بدون عقد، وبدون مسبقات. ولم يكن هدفنا، وليس في نيّتنا أبدًا، الانتصار لطرف على آخر، فنحن نعتبر الماضي ملكًا للجميع ونرى أن صراعاته يجب أن تكون وراء الجميع، لا معهم ولا أمامهم.
وكما أنه ليس من الممكن فصل الثقافة عن السياسة في التجربة الثقافية العربية، وإلا جاء التاريخ لها عرضًا لأشياء متناثرة لا روح فيها ولا حياة، لم يكن من الممكن كذلك، ونحن نبحث في تكوين العقل العربي، إهمال اللامعقول والاهتمام بالمعقول وحده، بل لقد تتبعناهما معًا في نموهما وتأثيرهما المتبادل، وأكثر من ذلك وأهم، في نظرنا، لم نحاول التماس المعقولية، بصورة من الصور، لهذا القطاع أو ذلك من قطاعات اللامعقول في الثقافة العربية، بل لقد احترمنا في كل قطاع طبيعته وربطناه بالبنية - الأم التي منها تفرع وإليها ينتمي.
ولا بد من الإشارة أخيرًا إلى أننا قد اخترنا بوعي التعامل مع الثقافة "العالمية" وحدها، فتركنا جانبًا الثقافة الشعبية من أمثال وقصص وخرافات وأساطير وغيرها، لأن مشروعنا مشروع نقدي، ولأن موضوعنا هو العقل، ولأن قضيتنا التي ننحاز لها هي العقلانية. نحن لا نقف هنا موقف الباحث الأنثروبولوجي الذي يبقى موضوعه ماثلًا أمامه كمضوع باستمرار، بل نحن نقف من موضوعنا موقف الذات الواعية، من نفسها. إن موضوعنا ليس موضوعًا لنا إلا بمقدار ما تكون الذات موضوعًا لنفسها في عملية النقد الذاتي.
مشروعنا هادف إذن، فنحن لا نمارس النقد من أجل النقد، بل من أجل التحرر مما هو ميت أو متخشب في كياننا العقلي وإرثنا الثقافي، والهدف: فسح المجال للحياة كي تستأنف فينا دورتها وتعيد فينا زرعها.. ولعلها تفعل ذلك قريبًا.
الدار البيضاء، شِباط/ فبراير 1983.
محمد عابد الجابري
كلية الآداب - الرباط