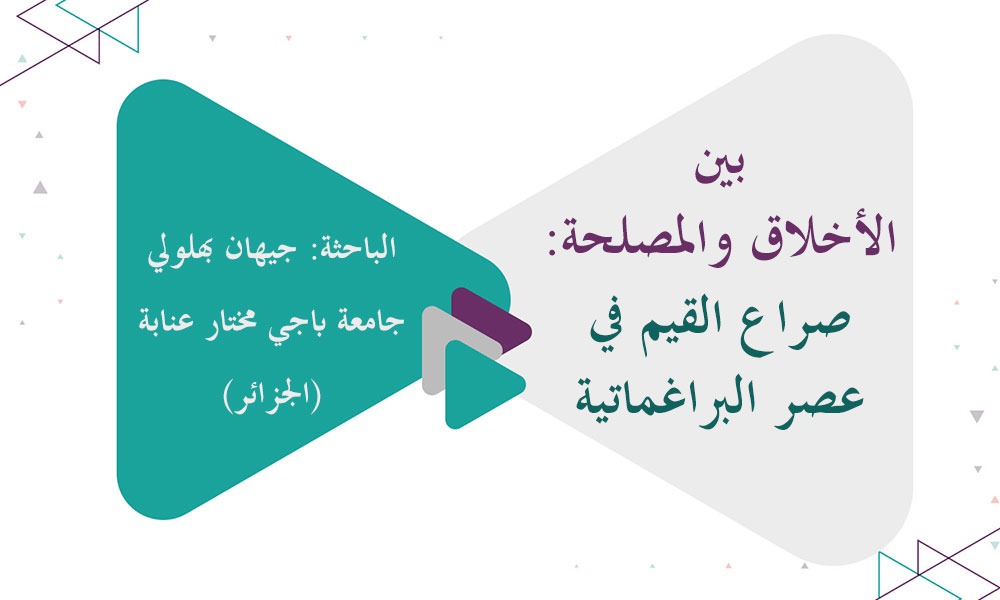ابن الجوزي (1116هـ - 1201م) رائد سيكولوجية النماء الديني
نحو بناء منظور نفسي إسلامي لدراسة النمو الإيماني (الديني) نظرية
مقدمة
يعتبر الإيمان أحد أهم الحقائق الوجودية التي رافقت الإنسان منذ وجوده الأول، واعتبره العلماء في مختلف التخصصات أحد أهم العناصر المركبة لجوهر الإنسان وحقيقته. وبناء عليه، نجد أن الكثير من العلوم الإنسانية خصصت فروعاً معرفية مستقلة تهتم بالدين وفعله في الإنسان جوهراً وسلوكاً. فشكلت ما اصطلح على تسميتها بـ «الدراسات الدينية»، مثل علم النفس الديني، وعلم الاجتماع الديني، وفلسفة الدين، حيث سعت إلى فهم الدين وما ارتبط به من آثار معرفية وسلوكية وعاطفية، على مستوى الإنسان الفردي أو الجماعي أو الوجودي.
وبناء عليه، اجتهد علماء النفس الديني في دراسة الإيمان، باعتباره أحد أهم أسس الدين، وما تجلياته في السلوكات الفردية والجماعية. ومن هذه الدراسات نجد تلك النظريات النفسية التي حاولت وصف التطور والنمو الإيماني للإنسان عبر مختلف المراحل العمرية للإنسان. ومن العجيب أن نجد كل تلك النظريات التي سعت لتحقيق هذا الهدف تنتمي للحضارة الغربية التي يعتبرها البعض أنها حضارة مادية، في حين تغيب مثل هذه الدراسات في العالم الإسلامي الذي يُعتبر أنه الممثل لـــ «حضارة الروح». وهذا بالطبع لا يعكس الواقع الحقيقي لمسار الحضارة الإسلامية، حيث كانت سباقة في الدراسة النفسية والسيوسيولوجية للدين. فنجد إسهامات ابن خلدون في مجال سوسيولوجيا الدين[1]، وإسهامات ابن الجوزي (1116- 1201م) في سياق دراسات سيكولوجية الدين، التي سنقف عندها في هذا المقال[2]. لكن قبل التطرق لنموذج ابن الجوزي حول سيكولوجية النمو الإيماني للإنسان، سنتحدث أولاً عن الخصائص النفس-إجتماعية للإيمان، لكي يتسنى لنا فهم ضرورة الدراسة العلمية للإيمان، ونفهم سبب حرص الأوائل على فهمه ودراسته.
-
"الإيمان" وقفة مع سيكولوجية المفهوم
اختلفت الفرق الكلامية في العالم الإسلامي حول حقيقة الإيمان وتجلياته، فمنها من اعتبرت الإيمان ما وقر في القلب، ومنها من اعتبرته بالإضافة للعمق القلبي، يجب أن تكون له تجليات في الجوارح، ومنها اللسان. لكنَّ الدراسات النفسية الحديثة للإيمان، خلصت إلى أن الإيمان الحق يجب أن تكون له تجليات في مجموعة من العناصر هي[3]:
-
العنصر المعرفي (Intellectual Element) : المضمون المعرفي للإيمان، فلا يمكن أن يكون هناك إيمان دون أن تكون هناك معرفة –ولو كانت محدودة-. [4]
-
العنصر الانفعالي (Emotional Element) : الراحة النفسية ، والتسليم السيكولوجي للبنية المعرفية للدين. فلا يمكن أن نتصور إيماناً دون وجود بُعد عاطفي-انفعالي مميز وعاكس لما يحويه العقل من معارف[5].
-
العنصر الطوعي أو الاختياري (The Volitional Element) : لكون الإيمان اختياراً إرادياً، مما ينعكس على السلوك. فلا يمكن أن يكون الإيمان إلا اختيارياً[6].
-
العنصر السلوكي "الفعلي" (Behavioral Element) : ولا يتحقق الإيمان أيضاً إلا من خلال الإنزال العملي للجوانب السابقة[7].
-
العنصر التعبيري "القولي" ((Linguistical Element: كما أن للإيمان تمظهراً آخر يتمثل في الإقرار القولي، لأن للقول دلالات إيمانية داعمة ومختلفة في الوقت نفسه عن سابقيه من التجليات[8].
-
الخصائص السيكو-سوسيولوجية “للإيمان"
لقد سعت المدارس الكلامية لتحديد الطبيعة السوسيو-نفسية لمفهوم الإيمان، حيث توصلت لحقيقة أنَّ الإيمان يزيد وينقص، وأن الزيادة والنقصان مرهونان بالنشاط الديني الفردي والجماعي الذي يقوم به الإنسان، وغيرها من الخصائص. ونجد أن الدراسات النفس-اجتماعية قد توصلت لمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها في الآتي[9]:
-
الإيمان حالة ديناميكية –متغيِّرة- : وهو ما يتوافق مع فكرة الزيادة والنقصان في الإيمان، وهو يثبت أن هناك عوامل حاكمة لهذه الحركة، وجب على الإنسان معرفتها.
-
يؤثر السياق الاجتماعي بشكل دينامي وفاعل على النمو الديني: هناك بُعد سوسيولوجي حاكم لمسألة الإيمان، لذلك نجد الدين الاسلامي يؤكد على ضرورة الحفاظ على البيئة والمحيط الاجتماعية للإنسان. وهذا الأمر له العديد من الشواهد في القرآن والسنة الشريفة.
-
تشهد مرحلة المراهقة تحولات حادة ونوعية في النمو الديني والإلتزام الإيماني: وهذا من أهم الخصائص المتعلقة بطبيعة الإيمان، إذ تثبت الدراسات أن التغيّرات المعرفية والبيولوجية لها بصمتها في بناء وهدم الإيمان في الكيان البشري. فطبيعة الإيمان، وتجلياته في مرحلة الطفولة، ليست نفسها في مرحلة المراهقة، وبالتأكيد ليست الطبيعة نفسها في المراحل اللاحقة.
-
مرحلة الــــــ (12) سنة الأولى من حياة الإنسان لها قيمة هامة وخاصة: وهو الأمر الذي جعل المدرسة النفسية الغربية تركز على دراسة طبيعة الإيمان وأسسه عبر مختلف مراحل نمو الإنسان، من أجل استخدامها حسب الحاجة، إما في الاتجاه الإيجابي أو السلبي.
-
يرتبط إيمان الإنسان ونموه بالحياة المتفرِّدة والمتميزة له: لا يمكن للناس أن يتطابق إيمانهم، لا من ناحية تجلياته ولا من خلال بنائه بشكل موحد، وهذا راجع للحياة المتفرَّدة لكل إنسان، وراجع أيضاً للاختلافات الفردية من إنسان لآخر.
هذه الخصائص كلها، جعلت كثيراً من العلماء يسعون لتوسيع مداركهم حول تطوُّر ونمو الإيمان عبر المراحل العمرية المختلفة. وهذا يشمل كل التفاعلات البين-شخصية، عبر المستويات الاجتماعية المختلفة. وسنذكر ابتداءً أهم النظريات التي تطرقت إلى هذا الموضوع باختصار، ثم نذكر الاجتهاد الذي اقترحه ابن الجوزي –رحمه الله تعالى.
-
“الإيمان” ضمن سياقه "النفسي – الزمني" وإشكال المفاصل العمرية
-
ﺑﺮوس ﺑﺎورز BRUCE POWERS
بالنسبة له، يعتبر النمو الإيماني للإنسان هو عملية توافق بينه وبين مطالب الحياة. وتتضمن هذه العملية الإدراك العميق بتعاظم الحاجة إلى إعادة إحياء التعاليم الدينية، وفهم الخيارات والاحتمالات الإيمانية المتاحة أمام الفرد، والاقتناع بشعائر معينة، وتطبيق تلك المعارف الدينية وتحويلها إلى سلوك عملي. وهذا عبر مراحل تتمثل في الآتي:
|
36 – فما فوق
|
28 - 35
|
19 - 27
|
7 - 18
|
0 - 6
|
|
التديُّن النشط
تمثل قمة أوج النمو الديني، وفيها يدافع الإنسان عن قناعاته.
|
اتخاذ القرارات
حيث يصبح اعتقاد الفرد مؤسَّساً على قناعة.
|
اختبار الواقع
وفيها اختبار المعتقدات والقيم الدينية في الميدان.
|
الغرس والتلقين
وتمثل مرحلة الاكتساب والسيطرة على محتوى العقيدة أو الإيمان.
|
التنشئة
باعتبارها مرحلة تمثل اكتشاف الطفل لمعنى الحياة. ويكون للوالدين والمعلمين دور هام.
|
-
ﺟﻮن وﻳﺴﺘرهوف JOHN WESTERHOFF
أسس (ويسترهوف) نظريته على تصوره للإيمان بأنَّه: "فعلٌ يتضمن التفكير والانفعال والرغبة، ويزداد قوةً ويتحول ويتسع من خلال تفاعل الإنسان مع مجتمع يعتنق عقيدةً معيَّنة". وينمو هذا الإيمان نمواً تراكمياً، إذ تمهّد كل مرحلةٍ الطريقَ للمرحلة التي تليها. وتتمثل مراحل النمو كالآتي:
|
35 – 70 (الرشد)
|
18 – 35
(المراهقة المـتأخرة)
|
12 – 18 (المراهقة)
|
0 – 12 (الطفولة)
|
|
الإيمان الذاتي –الخاص-
يتقبل الإنسان عقيدته طواعية، ويتعايش معها بسلام.
|
الإيمان البحثي
هناك تؤثر نزعات الشك والارتياب ، وتطرح التساؤلات حول الإرث الإيماني الذي اكتسبه.
|
الإيمان الانتسابي –التابع-
يميز الإيمان في هذه المرحلة بارتباطه القوي بالفئة التي ينتمي إليها.
|
الإيمان التجريبي
وهي مرحلة التأسيس الإيماني من خلال نسخ إيمان الآخرين.
|
-
ﺗﻴﻤﺐ ﺳﺒﺎرﻛﻤﺎن [10]TEMP SPARKMAN
لخَّص مراحل النمو الإيمان للإنسان على النحو التالي:
|
(الرشد)
|
16 – 35
(المراهقة المـتأخرة)
|
6 – 15
(المراهقة)
|
0 – 6
(الطفولة)
|
|
الإنسان المؤتمن
ينتقل الإنسان في هذه المرحلة إلى أن يصبح حارساً وأميناً على الإيمان الذي ينتمي إليه. ويشرح كيف يؤثر هذا النظام الإيماني في النظاميين الطبيعي والاجتماعي والفردي.
|
المؤمن الراسخ
يصبح المراهقون قادرين على إثبات حقائق الإيمان لأنفسهم، ومهمة المحيط الاجتماعي إظهار ضرورة هذا التراث الديني في حياتهم، وإرشاد المراهق في تقييمه ومساعدتهم في الإعلان الشخصي عن إيمانه.
|
الطفل الواعد–الانتماء-
ينمو شعور الانتماء لدى الأطفال إلى الجماعة التي يشارك فيها آباؤهم، وهي مكانة تمنحها لهم الجماعة. تتمثل مهمة الآباء في أن يوضحوا للأطفال، بما يتناسب مع تطورهم العاطفي والفكري والاجتماعي، أهمية تراثهم الإيماني كأساسٍ يبنون عليه هويتهم. ومن خلال ذلك، ينشأ لديهم الشعور بالـ "هوية" (وهي صلتهم الفطرية بخالقهم(.
|
الطفل الملائكي
في المرحلة الأولى عند تِمب سباركمان، يركّز على ترسيخ هوية انتماء إيجابية لدى الطفل منذ الطفولة المبكرة، بحيث يشعر أنه محبوب وله مكانة ثابتة في علاقة مع الله، وهو ما يشكل الأساس لبقية مراحل النمو الإيماني
|
-
ﺟﻴﻤﺲ ﻓﺎوﻟﺮ JAMES FOWLER
من خلال نظريته، حاول "جيمس فولر James Fowler "، معرفة مراحل النمو الديني التي يمر بها الإنسان خلال مختلف مراحل حياته. وقد حاول اكتشاف القوانين الحاكمة لذلك. ومن خلال الاستعانة بمجموعة من النظريات توصل إلى المعطيات التالية:
|
65 – وما بعدها
|
26 - 64
|
20– 25
|
13- 19
|
7 - 12
|
3 - 6
|
0 - 2
|
|
اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
أو مرحلة التنوير لأن الفرد يسمو فوق حاجاته الإنسانية، ويصبح فيها نظامه الديني معقداً ويستوعب جميع القيم الدينية والعالمية.
|
اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻤﺘﺮاﺑﻂ
يدرك في ضوئها الأفراد أفكارهم واندفاعاتهم ومشاعرهم والذكريات الدينية التي قمعوها سابقاً .
|
اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻔﺮدي اﻟﺘﺄﻣﻠﻲ
التحرر من السلطة الاجتماعية والدينية، وتحمل مسؤولية السلوك، ويكون فيها تشكيل قناعات ذاتية.
|
اﻹﻳﻤﺎن اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
وفيها يصبح للدين علاقة بتشكيل هوية الفرد الاجتماعية، من خلال الوعي بالمفاهيم الدينية وتقييمه لها.
|
اﻹﻳﻤﺎن اﻷﺳﻄﻮري اﻟﺤﺮﻓﻲ
وفيها يصبح تفكير الطفل الديني مادياً ومحسوساً. يبدأ الطفل في هذه المرحلة الانتباه إلى العالم الخارجي، والتمييز بين الواقع والخيال.
|
اﻹﻳﻤﺎن اﻟﺤﺪﺳﻲ اﻹﺳﻘﺎﻃﻲ
الإيمان هو نتاج للانطباعات التي يحصل عليها الطفل من الفضاء الذي يعيش فيه.
|
اﻹﻳﻤﺎن اﻷوﻟﻲ
يُؤسَّس بناءً على الخبرات التربوية الأولى في الأسرة
|
بعد العرض السريع والمختصر لأهم النظريات التي حاولت تفسير النمو الإيماني للإنسان عبر مختلف مراحله العمرية، وتداخلاته النفس اجتماعية، نأتي للحديث عن النظرية التي اقترحها ابن الجوزي –رحمه الله تعالى حول النمو الإيماني والتي ظهرت في القرن الثالث عشر (13) ميلادي، التي كانت سابقة لكل ما ذكرناه من النظريات بحوالي سبعة قرون (7) ، كما نذكر أهم المحطات النفس-اجتماعية المصاحبة له.
-
ابن الجوزي (1116- 1201م)
رسم ابن الجوزي –رحمه الله تعالى- معالم النمو الإيماني وفق مفهوم موسَّع للإيمان، وكذلك وفق مسارات متعددة مرتبطة بمتطلبات المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان. حيث نجده في المراحل الأولى من حياة الإنسان، والممتدة من ميلاده إلى سن الخامسة عشر (0 – 15)، والتي ترتكز على المسؤولية الوالدية: يركِّز على ثلاثة مسارات هي:
-
المسار المعرفي العقلي.
-
المسار النفسي.
-
المسار الاجتماعي
أما في المرحلة الثانية، التي تمتد من (16 – 35) سنة، والتي تمثل مرحلة المسؤولية الذاتية، فيوظف أربعة مسارات هي:
-
المسار النفسي.
-
المسار السلوكي.
-
المسار المعرفي التجريبي .
-
المسار الروحي.
وهكذا تتنوع أدوات ومقاصد التربية الإيمانية عند ابن الجوزي، حتى يصل الإنسان إلى آخر مراحل عمره. فعلى غرار التقسيمات السابقة، نجد أن ابن الجوزي، في كتابه المعنون بــــ (تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر)، يقسم مراحل النمو الإيماني، إلى خمسة[11] "مواسم"[12] ، وذكر التفاصيل العمرية وما تشتمل عليه من خصائص وواجبات وسلوكات يجب على الإنسان القيام بها. والملاحظ أنه أسس هذا التقسيم بناء على مجموعة أبعاد، وهي:
-
البعد النفسي البيولوجي: حيث هناك تطورات نفسية وبيولوجية يمر بها الإنسان، ولا يمكن تجاوزها.
-
البعد السوسيولوجي: حيث يشير إلى دور الأسرة أو المحيط الاجتماعي أو الفرد نفسه في آداء الواجبات وأخذ الحقوق.
-
وأخيراً وهو البعد الروحي: وهو الذي نجده غائباً في أغلب النظريات والطروحات النفسية الغربية. حيث جعل الفارق بين مسؤولية الأسرة على أفرادها، ومسؤولية الفرد على نفسه مرتبطة بالتكليف الشرعي. حيث جعل سن الخامسة عشر (15) مفصلاً زمنياً متوسطاً لانتقال المسؤولية من الأسرة إلى الفرد نفسه.
بل نجده قام بالتطرق لتفاصيل أكثر دقة في حديثه على كل مرحلة، ما يجعل عمله أكثر دقة وتمثيلاً لروح المدرسة النفسية الإسلامية. وكما وصفنا سابقاً الإيمان وخصائصه، فقد تطرق ابن الجوزي إلى مسألة الإيمان وتمظهراته العاطفية، والفكرية، والسلوكية، والقولية. بالإضافة إلى ذكره لهذه التمظهرات، أورد ما يجب فعله من أجل تجاوز كل مرحلة عمرية بنجاح.
مراحل النمو الإيماني حسب تصور ابن الجوزي
|
71 – إلى آخر العمر
|
51 - 70
|
36 - 50
|
16 - 35
|
0 - 15
|
|
العيش مع الله/القرآن والاستغفار
|
التعقل والتدبر
|
الغنيمة الإنجازية
|
المسؤولية الذاتية/الرقابة
|
المسؤولية الوالدية /الوقاية
|
وفيما يلي تفاصيل كل مرحلة من المراحل الموضحة في الجدول السابق:
الموسم الأول (0 إلى 15)، وفيه:
-
من 0 إلى 5 سنوات –التمييز- وبداية التأسيس المعرفي للإيمان:[13]
يعتبر ابن الجوزي رحمه الله تعالى هذه المرحلة منطلق التأسيس المعرفي للإنسان، وكما رأينا سابقاً فلا إيمان كاملاً وصحيحاً، دون أن يكون للإنسان رصيد معرفي رصين، حيث نجده يقول في هذا الصدد:
"إنَّ هذا الموسم يتعلق معظمه بالوالدين، فهما يربيانه، ويعلمانه ويحملانه على مصالحه، ولا ينبغي أن يفترا عن تأديبه وتعليمه (فإنَّ التعليم في الصغر كالنقش على الحجر). قال علي –رضي الله عنه- في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 06]: علموهم وأدبوهم. فيعلمانه الطهارة والصلاة .. ويحفظانه القرآن ويسمعانه الحديث وما احتمل من العلم أمراه به"[14].
كما يثير ابن الجوزي نقطةً غاية في الأهمية، ويتقاطع فيها مع أحدث الدراسات المتعلقة بالنمو القيمي والأخلاقي في الدرسات النفسية الحديثة. حيث نجده يؤكد على ضرورة الاهتمام ببناء المنظومة القيمية عند الطفل. إذ تعتبر هذه المرحلة العمرية –أي بين 0 – 5 سنوات- حاسمة في بناء البعد القيمي لدى الطفل[15]، ونجده يحدد ذلك بداية من سن الثالثة (03) . ابن الجوزي، يؤسس لمنظومة الإخلاق الإيمانية. فمن جهة يؤسس للإيمان من خلال العمق المعرفي، كما يتابع ثمرات هذا التعلم والبناء الروحي العميق في انعكاسه على القيم السلوكية لدى الطفل. فهو بطريقة ما، يحاول قياس مدى فاعلية البناء المعرفي من خلال القيم السلوكية. حيث يقول:
" ويقبِّحان عنده ما يقبح، ويحثانه على مكارم الأخلاق ولا يفتران عن تعليمه على قدر ما يتحمل، فإنه موسم الزرع .... وقد يرزق الصبي ذهناً من صغره فيتخيَّر لنفسه كما قال تعالى: ﴿ ۞ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾، فذكر في التفسير أنه كان ابن (3) ثلاث سنين "[16].
بعد هذا التأسيس المعرفي، وتجلياته القيمية الأخلاقية التي تعد مؤشراً على مدى فاعلية التعليم والتربية الإيمانية والمعرفية،
-
من 5 إلى 12 سنة- تجليات التربية الإيمانية: مرحلة التمييز والتميز و علو الهمة[17]
بعد عملية التمهيد المعرفي الإيماني، والمتابعة المستدامة للثمرات الأخلاقية للإنسان خلال سنواته الخمسة الأولى، يصل الطفل إلى مرحلة التمييز مؤهلاً ليحوِّل هذه المرحلة من كونها مرحلة تَميِيز معرفي إلى تَمَيُّز معرفي-روحي. فمن خصائص هذه المرحلة العمرية عند ابن الجوزي، تتمثل في بروز قابلية الفهم والنشاط في الخير، وحسن اختياره ، وابتعاده عن الدناءة، والعكس. –واستدل بقصة عبد الله بن الزبير مع عمر بن الخطاب –رضي الله عنها-: حيث أجاب ابن الزبير عندما سأله عمر –رضي الله عنه، عن سبب عدم هروبه مثل باقي أقرانه، فأجابه قائلاً: "ما الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولا لي ذنب فأخافك". حيث يقول:
"فإذا عبر الصبي خمس سنين بان فهمه ونشاطه في الخير، وحسن اختياره وصرف نفسه عن الدناءة، وعكس ذلك. ... وبين [وعلامة] فهم الصبي باختباره فتبين علو همته وتقصيرها. وقد تجتمع الصبيان للعب فيقول العالي الهمة: من يكون معي؟ ويقول القاصر: مع من أكون؟ ومتى علت همته آثر العلم"[18].
-
من 13 – 15 سنة: المراهقة وصراع البعد الروحي والبيولوجي[19]
لا يتحدث ابن الجوزي عن الإيمان بعيداً عن واقعه الاجتماعي، إذ إن الإيمان مرتبط بسلوكنا الاجتماعي، وما يكون منا من أفعال وأقوال وتصرفات. فالإيمان كما قلنا، يزيد وينقص. فيزيد بأفعالنا الحسنة وينقصه بسبب أفعالنا السيئة. ولعل فترة حياة الإنسان بين 13 و 15، تكون مليئة بالتحديات السلوكية المرتبطة بالتحولات البيولوجية وهي ما يسميها ابن الجوزي بمرحلة (المراهقة). حيث يحاول سد مصدر أكبر تحدي قد يمر به الإنسان خلال هذه المرحلة، وهو علاقته بجنسه المخالف. لذلك نجده يحث الآباء على تزويج المراهق، في حالة أنه كان غير قادر على الصبر وعدم علو همته في طلب العلم. وهذا من أجل حفظ إيمانه ورقيه الروحي. فنجده يقول: "فإذا راهق الصبي[20] فينبغي لأبيه أن يزوجه، ... وينزر من يؤثر العلم على النكاح، ويعلم نفسه الصبر، [حفاظا عليه وعلى نفسه –أي الوالد-]"[21].
الموسم الثاني (16 إلى 35)، –زمن معرفة الله بالدليل- وفيه: [22]
بعد التهيئة المعرفية والنفسية والاجتماعية لبناء منظومة إيمانية قوية، من خلال تعليم الطفل المعلومات والعبادات الأساسية لأصول الدين والإيمان، ودفعه من خلال سرعة ابتدائية لطلب العلم والمعرفة، والبناء النفسي القويم لطلب معالي الأمور، والتهيئة الاجتماعية من خلال بناء حياة اجتماعية سوية، -وهذا كله لبناء قاعدة صلبة- تؤهله لتحمل المهام الإيمانية الرفيعة فيما يلي من حياته، عبر مختلف المحطات العمرية، ينقلنا ابن الجوزي للحديث عن مرحلة عمرية حساسة من حياته الإنسان، حيث وصفها بــ "الموسم الأعظم". فما هي خصائص هذا الموسم ياترى؟
هذا "الموسم الأعظم" كما سماه ابن الجوزي، ذكر رحمه الله مجموعة من المسارات للبناء اللإيماني، مسار نفسي، ومسار سلوكي قيمي، ومسار معرفي تجريبي، ومسار روحي فيما يلي تفاصيل ذلك:
أولاً- المسار النفسي:
يرى ابن الجوزي أنَّ هذه الفترة العمرية، تمثل موسم السيطرة الذاتية على النفس، التي يبدأ فيها البناء الروحي الواعي، والتربية الذاتية بناء على التأسيس الذي أخذه في المراحل السابقة. ففي هذه المرحلة يبدأ الإنسان في مرحلة تربيته الروحية-الإيمانية الذاتية. فبعد أن كان الإنسان تابعاً لأسرته ومدرسته، يجد الآن نفسه مسؤولاً عن نفسه وعن أعماله. وبالتالي يظهر مبدأ جديد في حياته، هو: "الجهاد". ويسلط هذه الميزة النفسية على أهم مصادر الدمار الروحي والإيماني، وهي: النفس، والهوى –الغرائز-، والشيطان. يقول رحمه الله: " هذا الموسم الأعظم الذي يقع فيه الجهاد للنفس والهوى وغلبة الشيطان "[23].
إذا نجح الشاب في هذا التحدي التربوي، من خلال القدرة على السيطرة والتحكم في نفسه وغرائزه، سيحقق أهم مصدر للنمو والرقي الإيماني، وهو "حصول القرب من الله"، يقول رحمه الله: " ... وبصيانته يحصل القرب من الله تعالى، وبالتفريط فيه يقع الخسران العظيم، وبالصبر فيه على الزلل يثني على الصابرين كما أثنى على يوسف عليه السلام"[24].
ثانياً- المسار السلوكي:
يؤكد ابن الجوزي أن البناء الإيماني لا يمكن أن يتم بطريقة سلسة دون اعتبار للجانب السلوكي. حيث نجده يؤكد على ضرورة الممارسة الخيّرة في حياته، يقول في هذا الصدد:
"وكان خلق كثير يتأسفون في حال الكبر على تضييع موسم الشباب فليطل القيام وليكثر الصيام من سيعجز. والناس ثلاثة: من استكثر عمره بالخير ودام فذلك من الفائزين، ومن خلط وقصَّر فذلك من الخاسرين، ومن صاحب التفريط والمعاصي فذلك من الهالكين"[25].
ثالثاً- المسار المعرفي التجريبي:
يذكر ابن الجوزي مجموعة أخرى من من الأدوات المساعدة على النمو الروحي الإيماني السليم، وتتمثل في الأدوات المعرفية العقلية. ووتمثل في معرفة الله تعالى بالدليل لا بالتقليد، والاعتماد على المنهج الاستقرائي التجريبي وذلك من خلال النظر إلى نفسه وما فيه من تراكيب. يقول رحمه الله:
"وليعلم البالغ أنه من يوم بلوغه وجب عليه معرفة الله تعالى بالدليل لا بالتقليد، ويكفيه من الدليل رؤية نفسه، وترتيب أعضائه، فيعلم أنه لا بد لهذا الترتيب من مرتب، كما أنه لابد للبناء من بان"[26].
رابعا- المسار الروحي:
ويكون ذلك من خلال زراعة مبادئ أساسية مثل: مبدأ "الرقابة"، ومبدأ "التوبة". فمن ناحية، نجد مبدأ "الرقابة" يجعله يشعر بأن أفعاله وحركاته متابعة، وأن كل حركة من حركاته مقيَّدة مسجلة، مما يساعده على تجنب المحارم. ومبدأ "التوبة" يساعده من جهة إلى تجديد إيمانه، فالإنسان مهما حرص قد يقع في الأخير في بعض المعاصي. فيأتي مبدأ "التوبة" ليجدد به إيمانه وانطلاقه، يقول رحمه الله:
"ويعلم أنه قد نزل إليه ملكان يصحبانه طول دهره، ويكتبان عمله، ويعرضانه على الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾. ... فلينظر العبد فيما يرتفع من عمله فإن زل فيرفع الزلل بتوبة واستدراك"[27].
ونجد ابن الجوزي يركز بصفة خاصة على خطورة وحساسية هذه الفترة العمرية على الإنسان. وهذا لأنها متربطة بمسؤوليته الفردية. فإذا كانت المراحل السابقة متعلقة بالأسرة، فإن هذا الموسم مرتبط به هو، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها فترة يتميز بها الإنسان بمجموعة من الخصائص النفسية والسلوكية والعقلية، فيجب عليه استغلالها بطريقة صحيحة. يقول رحمه الله:
"قلت يوماً في الوعظ: أيها الشاب أنت في بادية ومعك جواهر نفسية تريد أن تقدم بها على بلد الجرا [دار الآخرة]، فاحذر أن يلقاك غرار الهوى، فيشتري ما معك بدون ثمن، فإنك إذا قدمتَ البلد ورأيت الرابحين قلت: ﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ﴾"[28].
الموسم الثالث (35 إلى 50)، –الكهولة- "الجهاد الحسن والتفكر "، وفيه:[29]
يرى أن أهم مسارين يجب على الإنسان في هذه المرحلة الحفاظ عليهما، هما: "المسار النفسي" و "المسار الروحي" للحفاظ على نموه ورقيه الإيماني. إذ أنَّ الإنسان يمتلك الدلائل العقلية، والسلوكية، التي تمكنه من الحفاظ على إيمانه. لكنَّ التغيرات البيولوجية، قد يكون لها وقع شديد على نفسيته. لذلك فهو يحتاج إلى أن يقوى بعده النفسي والروحي أكثر من خلال استمرار عمله بــ "مبدأ المجاهدة"، ويضيف لها مبدأ "التفكر". يقول رحمه الله:
"هذا الزمان فيه بقية من شباب وللنفس فيه ميل إلى الشهوات، وفيه جهاد حسن. وإن كانت طاقات الشيب ترع [تُفزع] وتزعج من مهاد اللهو، وليكتف الكهل [في التفكر] بنور الشيب الذي أضاء له سبيل الرحيل. وليعامل بالبقية المائلة إلى الهوى يربح لكن لا كربح الشباب"[30].
الموسم الرابع (50 إلى 70 سنة)، –الشيخوخة- (الصبر على الثبات الإيماني)، وفيه:[31]
هذه المرحلة تتطلب من الإنسان التحلي بالمسار السلوكي المتمثل في خلق "الصبر" تحديداً. ويشير ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى نقطة مهمة جداً، التي تتعلق بـــ "بناء العادات". حيث يرى أن المعاصي التي يقوم بها الإنسان في هذه المرحلة مرتبطة "بالتعود" أكثر مما هو مرتبط بالشهوة. يقول ابن الجوزي –رحمه الله-:
"قد يكون في أول الشيخوخة بقية هوى، فيكون الثواب على قدر صبره وكلما قوى الكبر ضعفت الشهوة، فلا يراد الذنب ... . فإذا تعمد الشيخ ذنباً فهو مراغم [ذليل مهان، تعود المعصية والعياذ بالله] إذا الشهوة قد خرست ... . فالويل لمن لم ينهه شيبه عن عيبة؛ ما ذاك إلا لخلل في إيمانه"[32].
الموسم الخامس (ما بعد الــــ 70 سنة)، –الهرم- والعودة "للمسار الروحي"، وفيه:[33]
بعد استنفاذ الإنسان لكل المسارات السلوكية، والعقلية، والفكرية، الاجتماعية، يأتي المبدأ الخالد الذي لا غنى للإنسان عنه، وهو المسار "الروحي". فالإنسان الذي تجاوز السبعين، هو كما يصفه ابن الجوزي، (أسير الله في الأرض). في هذه المرحلة، يلجأ الإنسان إلى الاكثار من الاستغفار، والدعاء، واغتنام الساعات، والتأهب للرحيل. يقول ابن الجوزي رحمه الله:
"في الحديث (ابن الثمانين أسير الله في الأرض)، ولم يتوفَّ زمان الهرم إلا تدارك ما مضى، والاستغفار والدعاء عمل ما يمكن من الخير اغتناماً للساعات، والتأهب للرحيل"[34].
الخاتمة
جاء هذا الجهد المعرفي لإبراز النهج العلمي-الروحي الذي انتهجه علماء الإسلام في فهم سيكولوجية الإيمان، من أجل الاستغلال الحسن لمختلف مراحله وفتراته. وهذا يدل على أن المعرفة الصحيحة لخصائص الإنسان النفسية هي أصل من أصول التدين السليم. لكن العجيب هو اختفاء مثل هذه الدراسات الجادة للإيمان وسيكولوجية التدين والنمو الديني من الدراسات النفسية والدينية الحديثة. ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة من أجل تبيان جهود علماء الإسلام في هذا السياق، لتكون دافعاً للباحثين والأكاديميين المسلمين للاهتمام بهذا المجال المعرفي، من خلال البناء على جهود الأقدمين وتطويرها، من أجل بناء لَبِنات المدرسة النفسية الإسلامية، المتميزة بروحها ومنطلقاتها ومآلاتها.
المراجع
-
أبو الفرج بن الجوزي، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، تحقيق: قسم التحقيق بدار الصحابة للتراث بطنطا، ط1، (طنطا: دار الصحابة للتراث، 1991).
-
عبد الرحمن بن خلدون، رحلة ابن خلدون، تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي، ط3، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2012).
-
مهدي محمد قصاص، علم الاجتماع الديني، (القاهرة: جامعة المنصورة، 2008)، ص 172-177.
-
Loewenthal, K., The Psychology of religion: A short introduction, (England: One World Oxford, 2008), p. 28-29.
-
Temp Sparkman, "Youth and Faith Development," Search (Spring 1985): 22-33.
[1] عبد الرحمن بن خلدون، رحلة ابن خلدون، تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي، ط3، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2012)، ص 6.
[2] أبو الفرج بن الجوزي، تحقيق: قسم التحقيق بدار الصحابة للتراث بطنطا، ط1، (طنطا: دار الصحابة للتراث، 1991).
[3] Loewenthal, K., The Psychology of religion: A short introduction, (England: One World Oxford, 2008), p. 28-29.
[4] وهذا ما يتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم، يقول تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [محمد: 19].
[5] وهذا ما يوافق قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 54].
[6] وهذا ما يدعمه قول الله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 256].
[7] يصدقه قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩﴾ [السجدة: 15].
[8] يقول تعالى، في هذا الصدد: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: 33].
[9] مهدي محمد قصاص، علم الاجتماع الديني، (القاهرة: جامعة المنصورة، 2008)، ص 172-177.
[10] Temp Sparkman, "Youth and Faith Development," Search (Spring 1985): 22-33.
[11] ابن الجوزي، أبو الفرج ، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 14.
[12] واستخدام ابن الجوزي لكلمة "موسم" لما تحويه من معاني إيجابية، فتأليفه للكتاب أساساً كان من أجل تحفيز الإنسان على اغتنام مراحل حياته المختلفة من أجل الوصول إلى مرضاة الله تعالى. فهو يعتبر كل مرحلة من المراحل بمثابة موسم تجنى ثماره الطيبة، وتتجنب آفاته وأدرانه. ولا يحصل المراد، إلا من خلال معرفة الخصائص النفسية والاجتماعية والروحية لكل مرحلة أو موسم من المواسم.
[13] ابن الجوزي، أبو الفرج ، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 15.
[14] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 15.
[15] إبراهيم بوزيداني، رحلة القيم في عقول أبنائنا، (إسطنبول: الصفوة للدراسات الحضارية، 2024)، ص 111.
[16] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 16-17.
[17] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص17.
[18] ابن الجوزي، أبو الفرج ، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص17-18.
[19] ابن الجوزي، أبو الفرج ، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 18.
[20] هناك من ينكر استخدام مصطلح المراهقة، رغم أنها تسمية استخدمها العرب من قديم، وقد اشتُقَّت من المعنى اللغوي، وهو كما جاء في لسان العرب: (وراهق الغلام ، فهو مراهق إذا قارب الاحتلام . والمراهق : الغلام الذي قد قارب الحلم وجارية مراهقة . ويقال : جارية راهقة وغلام راهق ، وذلك ابن العشر إلى إحدى عشرة)، يرجع لــ: ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 246.
[21] ابن الجوزي، أبو الفرج ، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 19.
[22] ابن الجوزي، أبو الفرج ، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 19.
[23] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 19.
[24] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 19.
[25] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 21.
[26] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 20.
[27] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 20.
[28] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 23.
[29] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 24.
[30] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 24.
[31] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 26.
[32] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 26-27.
[33] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 30.
[34] ابن الجوزي، أبو الفرج، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، ص 30.