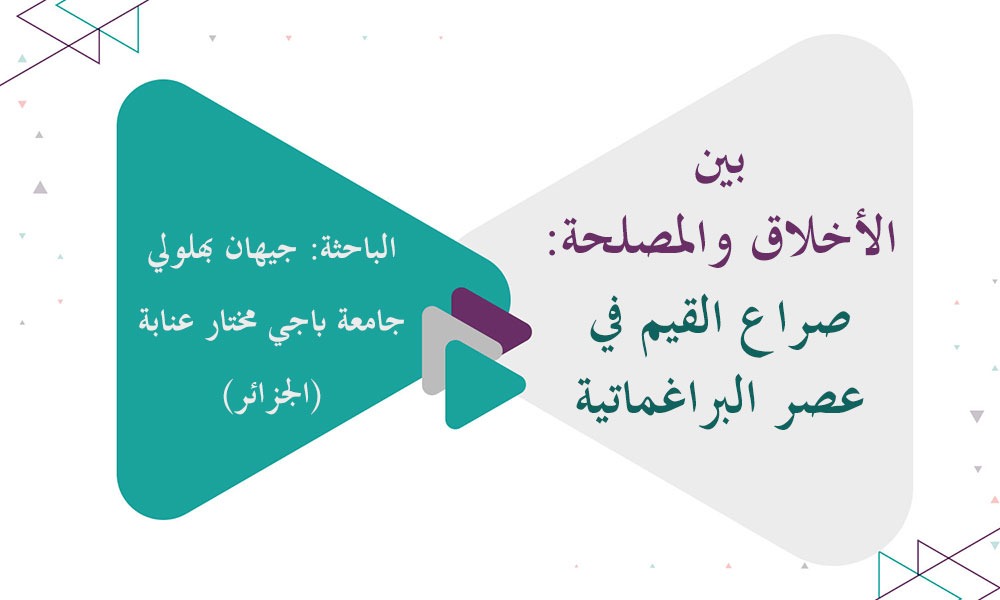شد انتباهي وأنا اقرأ مجموعة من المقترحات البحثية كيفية تعاملنا مع القرآن الكريم. وثار في ذهني سؤال عن ذلك: هل نتعامل معه بوصفه مرجعًا أعلى يُعاد إليه كلُّ تصوّر وقناعة وفكرة ومشروع، فنخضع له تصديقًا وإيمانًا ونجعل له الهيمنة على فكرنا وواقعنا؟ أم نتعامل معه، من حيث لا نشعر أحيانًا، ككتابٍ يُستدعى بعد اكتمال القناعات، ليُنتقى منه ما يوافقنا، ويُهمَل ما يعارضنا، فنقع في التعضية والتجزئة؟
هذا الإشكال هو ما يسعى هذا المقال إلى محاولة الإجابة عنه؛ عبر مناقشة الفرق بين موقف التصديق والهيمنة، وموقف التعضية والانتقاء.
أولًا: القرآن متبوع أم تابع
الأصل في المؤمن أن يتوجّه إلى القرآن الكريم متسائلًا، باحثًا عن منظورٍ كُلِّيّ، أو رؤيةٍ هادية، أو مفاهيمَ ناظمة، أو تصوّراتٍ كونية وإنسانية، أو حقائقَ وإجاباتٍ كلية وجزئية. أي أن يقف أمامه موقف المتعلّم المسترشد، لا موقف صاحب الحكم المسبق الذي ينتظر من النص أن يوافقه.
في هذا الأفق يصبح القرآن مُتَّبَعًا لا تابعًا، ويكون له التصديق؛ أي تصديق خبره، والإذعان لحكمه، والخضوع لسلطانه المعرفي والقيمي. كما تكون له الهيمنة؛ مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾، فالقرآن كما يقول المفسرون في هذه الآية هو الميزان الذي يصدق على الأقوال والأفكار والمواقف والتصرفات ويحكم عليها بالقبول أو الرفض، وهو المهيمن الأمين الشاهد الحافظ؛ بمعنى أنه المعيار الأعلى الذي يُرجَع إليه في تقويم سائر المصادر، فيُصحِّح ما قبله، ويهدي في فهم ما بعده، ويُبطل ما يناقضه أو يحيد عن روحه ومقاصده. وهذا الموقف هو الذي ينسجم مع حقيقة القرآن ذاته؛ إذ هو كتاب هداية وتزكية وبناء إنسان، لا مجرد مرجع استشهادي يوظَّف في سياقاتٍ جدلية أو أيديولوجية ضيّقة.
على الطرف المقابل، يتعامل بعض الأفراد أو التيارات مع القرآن الكريم وهم مثقلون بـ قبليات معرفية وأيديولوجية راسخة؛ انحيازات فكرية أو فلسفية سابقة، أو انتماءات مذهبية أو حزبية، أو تصوّرات اجتماعية وسياسية مكتملة في أذهانهم. ثمّ يُقبلون على القرآن لا ليُراجعوا هذه القبليات في ضوء هدايته، بل ليبحثوا عمّا يبدو موافقًا لها، ويُسقطوا ما سواه أو يُؤوِّلوه تأويلًا قسريًّا. وهكذا يتحوّل القرآن – عمليًّا – إلى تابع للإنسان، بدل أن يكون هو المتبوع والقائد والهادي.
في هذا النمط من القراءة يغدو القرآن خزانًا لِـ"الشواهد" الانتقائية التي تُستخرج لتدعيم موقف جاهز، لا نصًّا مُهيمِنًا يُعاد تشكيل الوعي في كنفه. وهو انقلاب خطير في ترتيب العلاقة مع القرآن الكريم؛ إذ تُستَخدم قناعاتنا المسبقة وأوهامنا وافكارنا حاكمة على القرآن، بدل أن يكون القرآن مصدرًا لبناء القناعات والتصورات والمواقف والمعايير.
ثانيًا: التعضية… حين نُجزِّئ القرآن
ينتهي هذا اللون من التناول، غالبًا، إلى ما يمكن تسميته بـ التعضية؛ أي تجزئة القرآن وأخذه بعضًا وترك بعض، فيوافق ذلك قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾. ولو تأملنا فيما ذكر من معاني التعضية عند المفسرين لوجدنا أن معانيها التعامل مع القرآن تفريقًا وتمزيقًا ومعنويًّا؛ فجعلوه أجزاءً مفكَّكة يؤمنون ببعضها ويكفرون ببعض، وفي الوقت نفسه أحاطوه بألوان من التهم الباطلة: سحر، شعر، كهانة، أساطير… فاجتمع في فعلهم تعضية الكتاب وبهته ووصفه بأصناف من الكذب والافتراء. وهذا لا يبتعد كثيرا عن تعامل كثير من مع القرآن حيث يذهب إلى القرآن وهو محمل بأوهام وأساطير ومواقف مسبقة هي أقرب إلى مواقف الذي وصفهم القرآن بالتعضية عند نول القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا، فالتعضية ليست مجرّد إنكارٍ صريح لبعض الآيات، بل قد تتجلّى في صورٍ أكثر خفاءً، كالتركيز على طائفةٍ من الآيات التي تخدم مشروعًا فكريًّا معيّنًا، مع إهمال آياتٍ أخرى لا تنسجم مع هذا البناء. او التعامل مع بعض التوجيهات القرآنية بوصفها "جوهرية" وأخرى "ثانوية" دون مستند من النصّ، بل انطلاقًا من الهوى أو المصلحة. أو فرض تأويلات متكلّفة على الآيات حتى تُستوعب داخل منظومةٍ مسبقة لا يريد صاحبها مراجعتها. هذا كله لونٌ من ألوان التعضية، وإن لم يُصرّح به صاحبه؛ إذ النتيجة واحدة: صورة قرآنية مجتزأة ومشوهة، لا تعبّر عن الرؤية الكلية التي يحملها الكتاب العزيز.
وهنا يتأسس منطق التبرير؛ حيث ينطلق القارئ من أسئلة من قبيل كيف أجد في القرآن ما يدعم موقفي السابق؟ أين الآيات التي يمكن أن أستثمرها في جدال خصومي؟ وكيف أُسخِّر النص القرآني لتقوية ما أتبنّاه من مشروع أو رؤية؟ هنا لا يعود القرآن مهيمِنًا، بل يصبح أداةً في خدمة رؤية سابقة؛ فيَضيقُ المعنى القرآني في قوالب ضيّقة، ويُحرَم القارئ من الهداية الكاملة التي كان يمكن أن ينالها لو دخل من باب السؤال المتجرّد.
ثالثًا: الافتقار إلى القرآن شرطٌ لانكشاف مكنوناته
فالقرآن الكريم كلام الله الذي يفتح أبوابه لمن قصده مفتقرًا، وأقبل عليه متواضعًا، ومثُل بين يديه مجردًا ذهنه من الغرور المعرفي ما استطاع، ومن أوهامه وقناعاته، ومن القبليات المغلقة. فما لم يشعر الإنسان بحاجته الحقيقيّة إلى هداية القرآن، وبفقره إلى نوره في بناء تصوّراته المختلفة، وما لم يَنزِل عن مقام الاستغناء عن القرآن، فإن كثيرًا من مكنونات القرآن ستبقى عنه محجوبة.
إنه كتابٌ كريم، وكَرَمُه يتجلّى في فيضان معانيه وجواهره لمن أتى إليه بقلبٍ سليم، وعقلٍ منفتح على التعلّم، لا على الانتصار لذاته أو لمشروعه الخاص. ومن هنا تبرز أهمية التجرّد من "القبليات" قدر الطاقة، والنظر إلى القرآن على أنه المانح للمعنى، لا الموطِّد للمعنى الجاهز.
يقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾. ويرى المفسرون أن هذه الآيات تدل على أن القرآن الكريم عظيم الشأن، كثير الخير والعلم، مشرِّف لمن تمسّك به، مكرَّم عند الله وملائكته والمؤمنين. وأنه كتاب مستور محفوظ مُصان عن التلوث والتحريف. فهذه الآيات تدل على شرف القرآن وعلوّ مرتبته، فهو "كريم" في ذاته، "مكنون" محفوظٌ من التلاعب والتحريف في أصله، لا يمسّ حقيقته العليا إلا المطهَّرون.
وفي الوعي التربوي يمكن أن يُستفاد من هذا المعنى أنّ مسّ حقائق القرآن على مستوى الهداية والمعرفة العميقة يتطلّب – إلى جانب الطهارة الحسية – نوعًا من الطهارة الباطنة؛ طهارة القلب من التكبر على الحق، وطهارة العقل من الاستعلاء على القرآن، وطهارة النيّة من توظيف القرآن لأغراضٍ تضاد محكمات القرآن. فمن تطهّر من مسبقاته (المغلقة)، وافتقر إلى القرآن باحثًا عن إجابةٍ لا عن تبريرٍ، انفتحت له – بإذن الله – مكنوناته، وتجلى له من جواهره ما لا يتهيّأ لمن قرأه بعين الخصومة أو الانغلاق.
وهنا يتأسس منطق السؤال أو الافتقار إلى القرآن؛ حيث يتوجّه القارئ إلى القرآن متسائلًا مثلا ما التصوّر القرآني عن الإنسان والمجتمع والعدل والحق والباطل؟ وكيف يريد الله تعالى أن يوجّهني في هذا الباب أو ذاك؟ وبأي صورة يريد القرآن أن يعيد تشكيل وعيي وسلوكي؟ في هذا المنطق، يكون القارئ مستعدًّا لأن يُراجِع ذاته، وأن يُعدّل مواقفه وأفكاره إذا تبيّن له تعارضها مع هداية النص.
رابعًا: كيف نجعل القرآن تابعا لا متبوعا؟
لتحويل علاقتنا بالقرآن من التعضية إلى التصديق والهيمنة، يمكن استحضار مجموعة من الخطوات العملية؛ أولها تعليق القبليات (المغلقة) قدر المستطاع، لا بمعنى إلغاء العقل أو الخبرة أو التراث، بل بمعنى أن يبقى القارئ مستعدًّا لأن يُسائل تلك القبليات، وألا يتعامل معها كمسَلَّماتٍ مطلقة لا تقبل المراجعة في ضوء القرآن. وثانيها التسليم للقرآن ببناء التصوّر لا العكس، وذلك بقبول أن يُغيّر القرآن موازيننا، وأن ينقلنا من منظوماتٍ فكرية أو نفسية ألفناها إلى منظومته هو، حتى لو اقتضى الأمر مراجعةً عميقة للذات والقناعات والمعارف والمشاريع والارتباطات. وثالثها تحري الرؤية الكلية والابتعاد عن الانتقائية، فإذا عولجت قضيةٌ ما، استُقرئَت آي القرآن في سياقها الكلي، بدل البناء على آيةٍ واحدة أو مقطعٍ مجتزأ يفتح باب التفسير المبتور. ورابعها، النيّة؛ بأن يُستحضر أنّ المقصود الأول هو طلب الهداية وبناء التصوّر السديد، لا مجرد جمع الشواهد أو تحصيل تبرير لفكرة ما أو مقف ما.
فنحن أمام طريقين؛ فإمّا أن نقف أمام القرآن موقف التصديق والهيمنة؛ فنُخضِع له أفكارنا ومناهجنا ومشاريعنا، فنُرزق من بركة هدايته واتساع معانيه، وإمّا أن ننزلق – وعيًا أو لا وعيًا – إلى التعضية؛ فنُجزِّئه وننتقي منه، فنفقد أثره وتغيب عنا مكنوناته، وإن أكثرنا من الاستشهاد بألفاظه.
فمن أراد أن يُفتح له من أسرار هذا الكتاب الكريم، فليدخل عليه فقيرًا لا مستغنيًا، متطهّرًا من كبرياء المعرفة ومن ثقل القبليات المغلقة، باحثًا عن إجابةٍ لا عن تبرير؛ عندئذٍ يتجلّى له معنى قوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾.