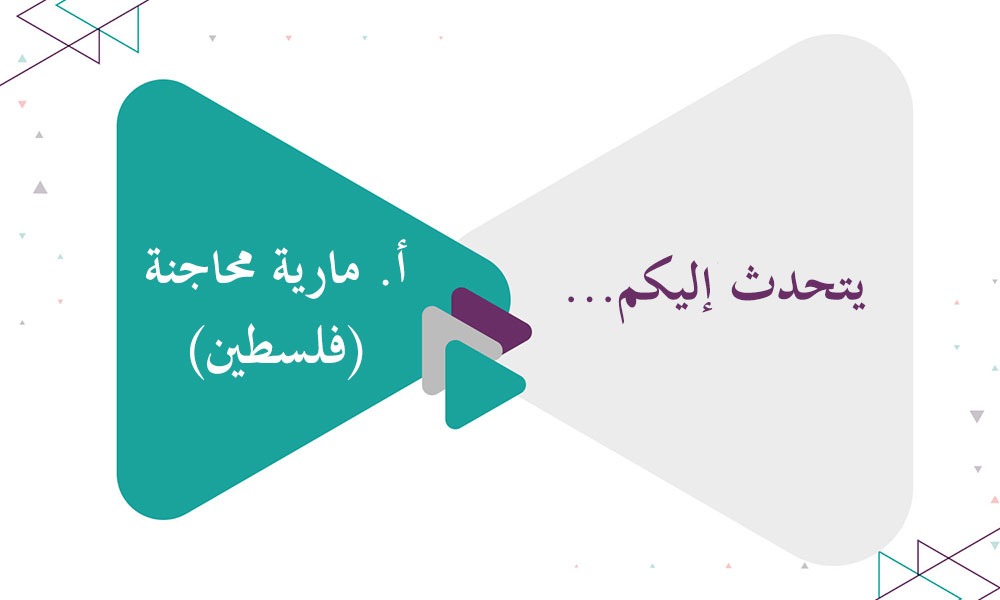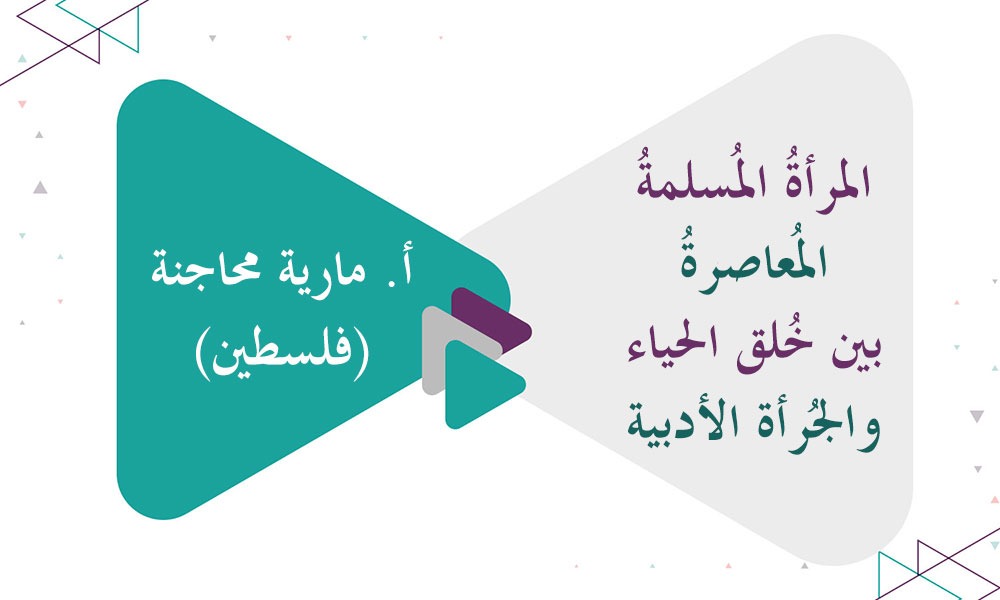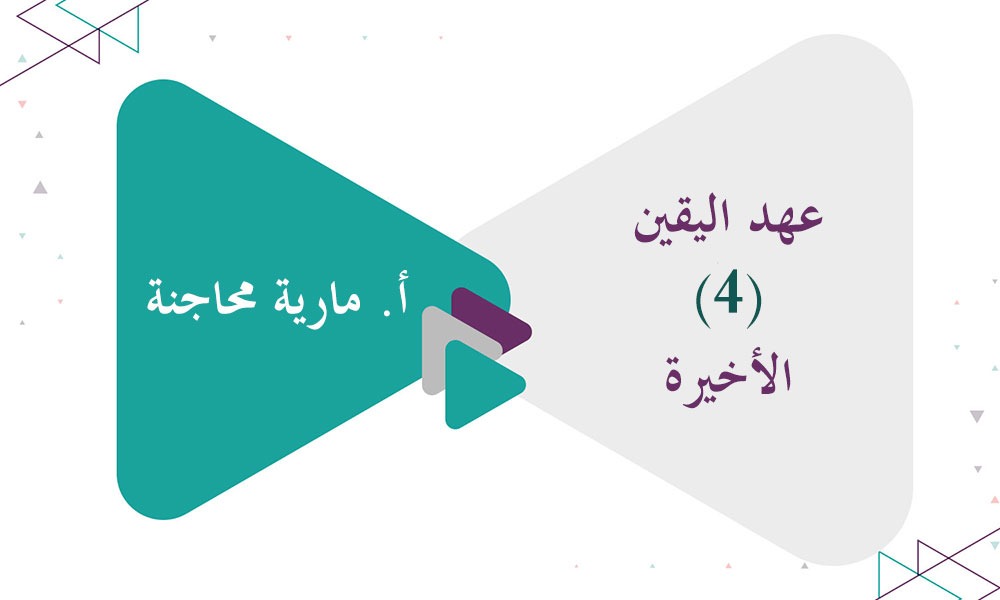الوعي التاريخي النقدي
(المفهوم، المرجعية، والمعايير)
إعداد: عبد الصمد عيسى الخزروني
مقدمة
تخبرنا كتبُ التاريخ أن النهضة الأوروبية قامت بعد أن أعادت قراءة تاريخها الوسيط بعيون نقدية، وتجاوزت السلطة الكنسية التي فرضت احتكارًا على المعرفة. كما تخبرنا أيضا أن ابن خلدون في العالم الإسلامي هو أول من طرح رؤية نقدية للتاريخ، فرّق فيها بين الظاهر من الخبر والباطن منه (العِبَر والعِلل)، مما يُعدّ بذرة وعي نقدي تاريخي مبكر.
نستفيد من الخبرين المهمّين أنه لا نهضة من دون وعي تاريخي نقدي. وأن من لا يقرأ تاريخه بعمق وموضوعية، يظل أسيرًا للماضي أو مكرِّرًا لأخطائه. بينما المجتمعات الناهضة والمهتمّة بالنهوض هي التي تتصالح مع تاريخها عبر التحليل، لا عبر التقديس أو الإلغاء.
في هذا السياق، سأحاول الحديث عن الوعي التاريخي النقدي وأهم عناصره الأساسية، وعن علاقته بالمرجعية، وعن المعايير التي يعتمدها في تناوله للأحداث وتحليلها، ثم أخيرا قبل الخاتمة عن كتاب نموذج للدكتور جاسم سلطان في هذا المجال.
مفهوم الوعي التاريخي النقدي
الوعي التاريخي النقدي هو قدرة الفرد أو الجماعة على فهم الأحداث والظواهر التاريخية فهماً عميقاً، مع تحليلها وتحكيم العقل في تفسيرها، بدل الاكتفاء بقبول الروايات أو التصورات الجاهزة. هذا النوع من الوعي يقوم على التفكير النقدي، أي طرح الأسئلة، والتحقق من المصادر، وفهم السياقات، وربط الماضي بالحاضر والمستقبل.
ويمكن تلخيص عناصره الأساسية في أربعة محاور:
1. فهم السياق التاريخي
إدراك الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي أحاطت بالحدث. وعدم النظر إلى الماضي بعيون الحاضر فقط (تجنّب "الإسقاط الزمني").
2. تحليل المصادر
التفريق بين المصادر الأولية (النصوص والوثائق المعاصرة للحدث) والمصادر الثانوية (كتابات المؤرخين لاحقاً). وتقييم مصداقية المصادر والتحقق من التحيزات المحتملة.
3. المقارنة والتعددية
مقارنة الروايات التاريخية المختلفة حول نفس الحدث. وتقبّل أن التاريخ ليس "قصة واحدة" بل فسيفساء من وجهات نظر متعددة.
4. الربط والنقد
استخلاص العبر والدروس دون تحويل الماضي إلى أداة للتبرير أو التقديس الأعمى. ووعي العلاقة بين الماضي والحاضر، وكيف يمكن للتاريخ أن يوجّه الخيارات المستقبلية.
علاقته بالمرجعية
يُقصد بكلمة المرجعية الجهة أو المصدر أو المنظومة التي يعود إليها الإنسان أو الجماعة في تحديد الموقف، وصناعة القرار، وفهم الواقع. وتختلف طبيعتها حسب المجال: ديني، فكري، سياسي، علمي، قانوني… كما أن المرجعية في إطار الفكر النقدي، يجب أن تكون واضحة ومُعلنة، حتى لا تختلط المواقف أو تتحكم فيها الأهواء.
وعند الربط بين الوعي التاريخي النقدي والمرجعية تكون العلاقة كالآتي:
1. المرجعية تحدد زاوية النظر للتاريخ
إذا كانت المرجعية دينية، فسوف تُقرأ الأحداث في ضوء النصوص المقدسة والقيم الروحية. وإذا كانت المرجعية أيديولوجية، فسيكون التركيز على ما يخدم الفكرة أو المذهب. أما إذا كانت المرجعية علمية-بحثية، فسيكون الاعتماد على الوثائق والتحليل الموضوعي دون الانحياز.
2. الوعي التاريخي النقدي يقيّد المرجعية من الانغلاق
حتى لو كانت المرجعية دينية أو فكرية، الوعي النقدي يمنعها من أن تتحول إلى "نظارة مغلقة" لا ترى إلا ما يؤكدها. النقد يساعد على فرز ما هو ثابت في المرجعية (قيم ومبادئ) وما هو اجتهادي أو قابل للتعديل.
3. التفاعل بينهما
إذا كانت المرجعية تمنح الإطار القيمي للقراءة التاريخية (ما هو حق/باطل، خير/شر)، فإن الوعي النقدي يمنح الأدوات المنهجية للتحقق من صحة الروايات التاريخية وفهم سياقها. ومثالا على ذلك، عند قراءة معركة تاريخية، المرجعية الإسلامية مثلاً قد ترى أن النصر أو الهزيمة له بعد إيماني (النصر من عند الله أو نتيجة للمعصية)، بينما الوعي التاريخي النقدي يضيف إلى ذلك: تحليل الظروف الاقتصادية، الاستراتيجية العسكرية، وحالة المجتمع وقتها. والنتيجة: قراءة شاملة، تجمع بين البعد القيمي والبعد التحليلي.
المعاييرُ المعتمدة
المعايير المعتمدة في الوعي التاريخي النقدي يمكن تلخيصها في مجموعة نقاط منهجية تضمن أن تكون قراءة الماضي دقيقة، متوازنة، وغير خاضعة للتضليل أو التقديس الأعمى، وأجملها كالآتي:
1. معيار التحقق من المصدر
نعني به التمييز بين المصادر الأولية (وثائق، نصوص، شهادات معاصرة للحدث) والمصادر الثانوية (تحليلات المؤرخين لاحقاً). معناه فحص المصداقية: هل الكاتب شاهد مباشر؟ هل لديه تحيز أو مصلحة؟
2. معيار فهم السياق
نعني به قراءة الحدث في إطاره الزماني والمكاني، وفهم الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة به. معناه تجنب الإسقاط الزمني (أي الحكم على الماضي بقيم وأفكار الحاضر فقط).
3. معيار التعددية في الرواية
نقصد به مقارنة أكثر من رواية أو مصدر حول نفس الحدث. بمعنى آخر إدراك أن التاريخ ليس سردية واحدة، بل فسيفساء من وجهات نظر متعددة.
4. معيار الربط والتحليل
نقصد به ربط الحدث بسببه ونتائجه، وعدم عزله عن سلسلة الأحداث التي قبله وبعده. وتحليل العوامل العميقة (اقتصادية، ثقافية، فكرية) لا الاكتفاء بالمظاهر.
5. معيار الفصل بين القيم والوقائع
نشير به إلى التفريق بين الحقائق التاريخية (ما ثبت بالأدلة) والأحكام القيمية (ما نراه نحن صواباً أو خطأ). أي إعطاء القيم مكانها، لكن دون أن تطمس الوقائع.
6. معيار الاستفادة المعاصرة
نعني به استخراج الدروس والعبر من الحدث، مع تجنب تحويل التاريخ إلى أداة للتبرير أو الانتقام. بتعبير آخر فهم العلاقة بين الماضي والحاضر من أجل بناء المستقبل.
الوعي التاريخي النقدي عند جاسم سلطان
لا يمكن تتبع هذا الوعي التاريخي النقدي عند الدكتور جاسم سلطان في كل ما كتبه، فإنه من الصعب جدا فعل ذلك، لأن ما ألّفه من كتب تحتاج إلى جهد كبير ووقت كثير. حسبي في هذا المقال أن نقف عند أهمّ كتاب له في اعتقادي يعالج هذا الموضوع بشكل واضح، وهو كتاب "فلسفة التاريخ: الفكر الاستراتيجي في فهم التاريخ". وسأحاول تقديم عرض مُنظم لمظاهر الوعي التاريخي النّقدي كما تجسّدت في الكتاب، ويمكن إجمالها في ما يلي:
1. الاستفادة من تعددية النظريات
يتناول الكاتب آراء مجموعة متنوعة من المفكرين مثل ابن خلدون، أرنولد توينبي، مالك بن نبي، عماد الدين خليل، ماركس، وهيجل... دون تبنٍّ مطلق لأيّ منها، بل يُبقي على ما هو مفيد منها ضمن "الحكمة ضالّة المؤمن".
2. الانفتاح المنهجي على دلالات الماضي
يُقدِّم الكتاب التاريخ ليس كقصة تُروى فحسب، بل كأداة فلسفية لفهم الحاضر والمستقبل، وسبر سنن الحياة والعبر الكامنة في دورات قيام وسقوط الحضارات.
3. ربط التاريخ بالقيم الدينية والسياق الاستراتيجي
يستشهد الكاتب بآيات قرآنية تحث على التدبّر في أمثال الأمم السابقة، ويؤطر التاريخ ضمن منظومة قيمية تستند إلى سنن ثابتة في الكون، إضافة إلى مقاربة استراتيجية لتاريخ الأمة وبنائها.
4. المرونة النّقدية وعدم رفض الآخر بالكلية
يعتمد سلطان مبدأ "أخذ الصالح من اجتهادات الآخرين"، سواءً من فكر غربي أو إسلامي، دون المساس بجذوره الفكرية، مما يعكس موقفًا نقديًا مرنًا لا يرفض الآخر بالكلية.
5. التركيز على العوامل الديناميكية في التاريخ
يفكّك الكتاب عوامل نهضة الدول وسقوطها، مثل العصبيات في فكر ابن خلدون، وتأثير الأفكار وصراعاتها وفق هيجل، وديناميات الصراع الطبقي عند ماركس، وغيرها من التحاليل العميقة لآليات التغيير الاجتماعي والتاريخي.
جدول توضيحي مختصر لهذه المظاهر كما تجلت في الكتاب مع الوصف:
خاتمة
يمثل الوعي التاريخي النقدي أداة ضرورية لفهم مسار الأمم والشعوب، فهو يجمع بين دقة التحليل ووضوح المرجعية وقدرة الاستفادة من التجارب السابقة. وقد قدّم جاسم سلطان في فلسفة التاريخ نموذجًا تطبيقيًا لهذا الوعي، من خلال انفتاحه على مختلف المدارس التاريخية، وربطه بين العبرة الحضارية والقيم القرآنية، واعتماده منهجًا تحليليًا مرنًا يستفيد من كل فكر نافع دون انغلاق. وهكذا، يصبح التاريخ ليس مجرد سجل للأحداث الماضية، بل بوصلة استراتيجية ترشد الأفراد والمجتمعات نحو البناء والتجديد، وتقيهم الوقوع في أخطاء من سبقهم.