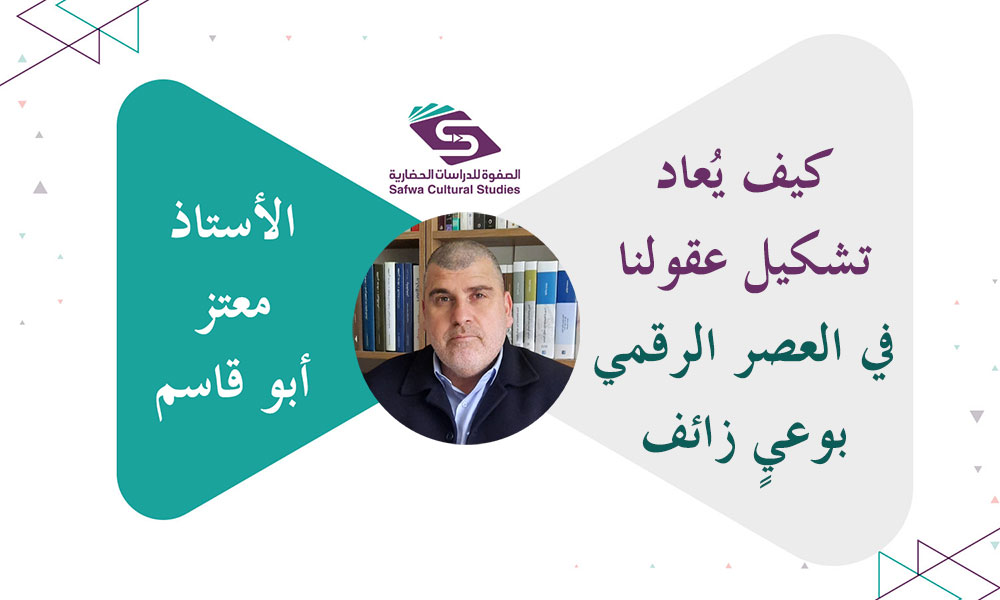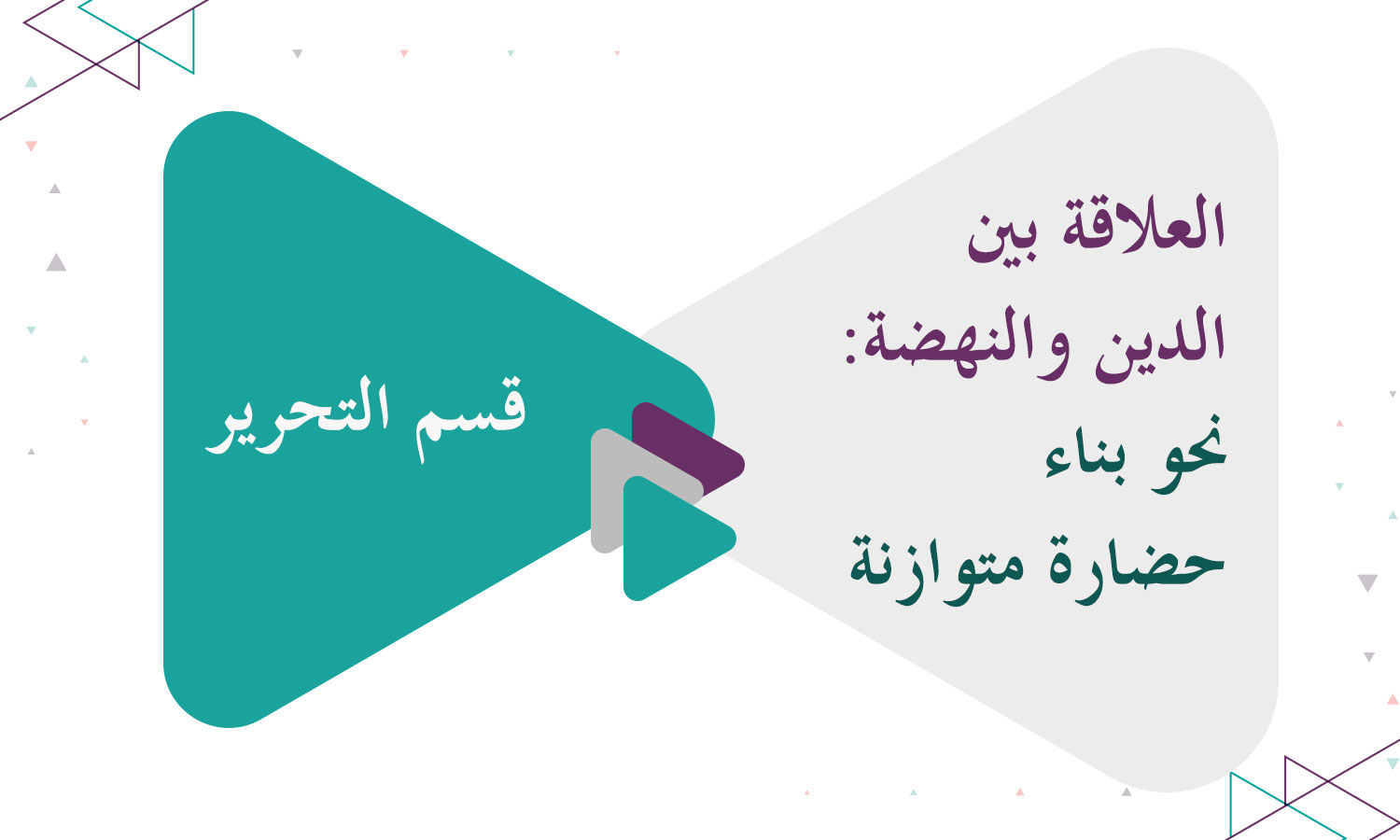أولًا: تحديد المفهومين الرئيسيين
الدين في جوهره منظومة متكاملة من العقائد والقيم والتشريعات التي تهدف إلى توجيه الإنسان نحو غاية وجوده العليا، وتحقيق التوازن بين بعديه الروحي والمادي. وهو رؤية كونية شاملة للعالم والحياة والإنسان، تسعى إلى تحقيق العدل والإصلاح والعمران. فالدين بهذا المعنى يقدّم إطارًا أخلاقيًا وتشريعيًا ينظّم علاقة الإنسان بربه، وبذاته، وبالآخرين، وبالكون من حوله.
أما النهضة، فهي حركة شاملة لإحياء طاقات الإنسان والمجتمع، تستهدف الارتقاء في مجالات الفكر والعلم والسياسة والاقتصاد والثقافة. وهي تُقاس بقدرة الأمة على تحقيق توازن بين الإبداع العلمي والسمو الأخلاقي، وبين الحرية والمسؤولية، وبين الانفتاح على العالم والحفاظ على الهوية. فالنهضة مسار تاريخي نابع من وعي ذاتي ومرجعية قيمية تضمن له الاستمرار.
إن الربط بين الدين والنهضة يقوم على أساس أنّ كليهما مشروع إصلاحي يوجّه الإنسان نحو الكمال؛ فالدين يقدّم البوصلة القيمية والغاية، بينما النهضة تمثّل الحركة الواقعية نحو تلك الغاية. وحين يتكاملان، تنشأ حضارة متوازنة تجمع بين «المعنى» و«البناء»، وبين «الإيمان» و«العمل».
ثانيًا: الأساس القيمي في العلاقة بين الدين والنهضة
يقدّم الدين منظومة قيم وأخلاق تمثّل البنية التحتية لأي نهضة إنسانية أصيلة. فالقيم مثل العدل، الأمانة، الحرية المسؤولة، الإحسان، والرحمة هي مبادئ عملية تنظّم العلاقات داخل المجتمع وتوجّه السلوك البشري.
تاريخيًا، كانت النهضات الكبرى التي عرفها العالم الإسلامي تنطلق من هذا الأساس القيمي؛ فالرسالة النبوية بدأت بتأسيس الإنسان القادر على حمل الرسالة، من خلال قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ" (الرعد: 11).
فهذا التغيير الداخلي هو جوهر النهوض. والدين يزوّد الإنسان بمعيار أخلاقي يوجّهه في اتخاذ القرار، ويمنعه من الانحراف في سعيه إلى التقدّم المادي، فيحفظ التوازن بين الغاية والوسيلة. فالقيم هي ضمانة لاستدامته، إذ تمنع العلم من التحوّل إلى أداة دمار، والسياسة من التحوّل إلى تسلّط.
ثالثًا: الجانب المعرفي في العلاقة بين الدين والنهضة
من الناحية المعرفية، يُعدّ الدين منبعًا لتأسيس رؤية متكاملة للكون والعلم والحياة. فالإسلام - على سبيل المثال - أقرّ منذ بدايته قيمة العلم وجعل طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة، لأنّ المعرفة هي طريق الفهم والعمران. يقول تعالى: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ" (الزمر: 9).
في هذا الإطار، الدين يحرّر العقل من الأوهام، ويؤسّس لتكامل بين المعرفة التجريبية والمعرفة القيمية. فالعقل في التصور الديني أداة للفهم والاكتشاف، لكنه يحتاج إلى نور الوحي ليهتدي في المسار الأخلاقي. وبذلك تنشأ رؤية معرفية تُوازن بين العلم والإيمان، وتعتبر العمل والإتقان نوعًا من العبادة، كما في الحديث الشريف: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه."
وهذا التكامل المعرفي هو ما أتاح للحضارة الإسلامية أن تكون منارة علمية في الطب والفلك والرياضيات والفلسفة دون أن تفقد بعدها الروحي.
رابعًا: البعد الاجتماعي
يسهم الدين في تنظيم العلاقات الاجتماعية على أساس من العدالة والتكافل والتعاون. فالمجتمع في الرؤية الدينية كيان أخلاقي يسعى إلى الخير العام.
قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" (المائدة: 2).
قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" (المائدة: 2).
من هذا المنطلق، يُعتبر التكافل الاجتماعي قيمة تأسيسية للنهضة، إذ لا يمكن لمجتمع يعاني من الظلم والفقر أن ينهض. الدين يضمن التوازن الاجتماعي من خلال تشريعات الزكاة والوقف والعدل في التوزيع، ويحدّ من النزعة الفردية المفرطة التي قد تفرزها الرأسمالية الحديثة.
كما أنّ الدين يرسّخ مفهوم الأخوّة الإنسانية، ويُسهم في بناء الثقة بين مكوّنات المجتمع، ما يجعل التماسك الاجتماعي قاعدة صلبة لأي نهضة حضارية مستدامة.
كما أنّ الدين يرسّخ مفهوم الأخوّة الإنسانية، ويُسهم في بناء الثقة بين مكوّنات المجتمع، ما يجعل التماسك الاجتماعي قاعدة صلبة لأي نهضة حضارية مستدامة.
خامسًا: التأثير السياسي والحضاري
في المجال السياسي، يقدّم الدين رؤية متكاملة للحكم الرشيد تقوم على مبدأ العدل والمسؤولية والشورى. فالدين يضع مبادئ عامة تضمن نزاهة المؤسسات وتحقيق المصلحة العامة، ولا يفرض شكلًا جامدًا للحكم.
إنّ المشروع السياسي في الإسلام، مثلًا، يقوم على أساس خدمة الإنسان لا تسخيره، وعلى تحقيق التوازن بين السلطة والرقابة، وبين الحرية والنظام. هذا ما يجعل الدين رافدًا للحكم الرشيد لا عائقًا له، لأنه يربط ممارسة السلطة بالمحاسبة الأخلاقية والرقابة الإلهية.
ومن ثمّ، فإنّ النهضة الحضارية التي تنفصل عن القيم الدينية قد تنتج تقدمًا ماديًا، لكنها تفقد التوازن الروحي والأخلاقي. بينما الدين يضمن أن تبقى الغاية من القوة والعلم هي خدمة الإنسان لا السيطرة عليه.
ومن ثمّ، فإنّ النهضة الحضارية التي تنفصل عن القيم الدينية قد تنتج تقدمًا ماديًا، لكنها تفقد التوازن الروحي والأخلاقي. بينما الدين يضمن أن تبقى الغاية من القوة والعلم هي خدمة الإنسان لا السيطرة عليه.
سادسًا: أمثلة تاريخية من الحضارة الإسلامية
شهد التاريخ الإسلامي تجارب باهرة جسّدت التفاعل الخلّاق بين الدين والنهضة. ففي العصر العباسي، مثّل بيت الحكمة في بغداد نموذجًا فريدًا لتكامل الإيمان والعلم؛ فقد كان العلماء يترجمون كتب الفلسفة والطب والرياضيات انطلاقًا من مبدأ ديني يرى في طلب العلم عبادة.
وفي الأندلس الإسلامية، ظهرت مدن مثل قرطبة وغرناطة كمراكز علمية وفكرية جمعت بين التقدّم العلمي والجمال العمراني وروح التسامح الديني، مما جعلها منارات للحضارة الإنسانية.
كما أسهم الفقهاء والعلماء في بناء منظومات قانونية وتنظيمية متقدّمة، تُعلي من قيمة العدالة وتحفظ الحقوق، مثل نظام الوقف الذي دعم التعليم والمستشفيات ورعاية الفقراء لقرون طويلة. كلّ ذلك يُظهر أنّ الدين، حين يُفهم بوصفه حافزًا للعمران، يفتح أمام المجتمعات أبواب الإبداع والتقدّم.
سابعًا: التوازن بين الدين والتحديث
لا يوجد تعارض جوهري بين الدين والتحديث، بل التعارض ينشأ حين يُفهم الدين فهمًا جامدًا أو يُمارس التحديث بلا ضوابط أخلاقية. فالدين يمكن أن يكون قوة دافعة لتبنّي التكنولوجيا والعلوم الحديثة، شرط أن تُستخدم في خدمة الإنسان والعدالة، لا في تكريس الهيمنة أو الترف.
النهضة المتوازنة هي تلك التي تستفيد من منجزات العلم، ولكنها تحتفظ بقيمها الروحية والإنسانية. فالإبداع في ظلّ الدين ليس تقييدًا للعقل، بل توجيه له نحو الخير. وقد أثبتت تجارب دول عديدة أنّ الجمع بين القيم الدينية والنظم العلمية الحديثة ممكن ومثمر، حين يُبنى على فهم حضاري مرن وواعي.
ثامنًا: النتائج والاستنتاجات
من خلال هذا التحليل، يتّضح أنّ العلاقة بين الدين والنهضة ليست علاقة تناقض، بل علاقة تكامل وظيفي وتفاعل إيجابي. فالدين يقدّم المعنى والنهضة توفّر الوسيلة، والدين يحدّد الغاية الإنسانية بينما النهضة تبتكر الوسائل العملية لتحقيقها.
إنّ الحضارة المتوازنة هي تلك التي تقوم على:
- مرجعية قيمية تُنظّم مسار التقدّم.
- رؤية معرفية تجمع بين العقل والوحي.
- نظام اجتماعي عادل يقوم على التكافل والمساواة.
- بنية سياسية رشيدة تُحقق المصلحة العامة.
- سلوك حضاري أخلاقي يضبط استخدام القوة والعلم.
بهذا المعنى، الدين روح النهضة الضامنة وضميرها الأخلاقي. ومن دون هذا البعد القيمي، يفقد التقدّم معناه الإنساني، ويتحوّل العلم إلى أداة هيمنة، والسياسة إلى صراع مصالح.
أما حين يكون الدين موجّهًا للضمير ومُلهمًا للعقل ومؤطّرًا للقيم، فإنّ الحضارة تُصبح مشروعًا إنسانيًا شاملًا يوازن بين الروح والمادة، بين الفرد والمجتمع، وبين الإيمان والعلم.
أما حين يكون الدين موجّهًا للضمير ومُلهمًا للعقل ومؤطّرًا للقيم، فإنّ الحضارة تُصبح مشروعًا إنسانيًا شاملًا يوازن بين الروح والمادة، بين الفرد والمجتمع، وبين الإيمان والعلم.