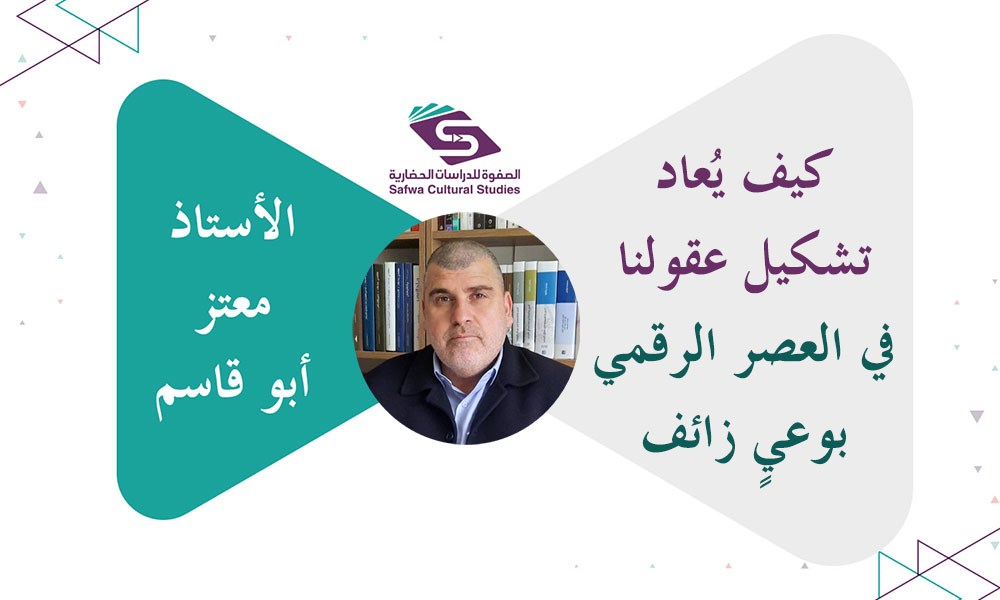الــفــيــلــســوف: إنــســان الــنُــقــصــان، نــحــو مُــســاءلــة نــقــديــة لأحــكــام الــنـَّـسَــف
الــحــرب فــي غــزّة حُــجّــة
شهرزاد حمدي، جامعة محمد لمين دباغين سطيف2، الجزائر
تخصّص: فلسفة عامة
_ مُفْتَتَحْ:
إنّ من أبرز الصِّفات التي فُطِر عليها الإنسان هي النُقصان، تِلك التي تجعله يغفل، يتعثّر ويُخطئ، هي تعبير صَريح عن النُقصان فينَا، نَعيبه إذا تجاوز الحدّ وتحوّل إلى عُقدة النُقص، فتُحاكِم بظُلم، نعترِف بنُقصاننا ولكن لا نرتهِن له. وسَيّرًا على خُطى هذه الطبيعة البشرية يكون الفيلسوف الصوت النقدي، بمَا هو إنسان، إنسان النُقصان، يتفاعَل مع الحدث تفكيكًا وبناءً، وينسج حوله مواقفه وتقديراته، التي تكون مَدَار تحليل ومُناقَشة من طرف القُرّاء والمُتتبّعين لِخَرَجَات الفلاسِفة، تَبَعًا للخُصوصية الفلسفية الجريئة، إمّا جُرأة الحقّ أو جُرأة التغّطية عليه. ولهذا فإنّ المطلب في أن تترافَقَ الجُرأة مع البراءة، سَعّيًا.
يتركّز موضوع ورقتنا في إيضاح كيف يكون الفيلسوف إنسان النُقصان، وفي مُحاولة إقامة مُساءلة نقدية للأحكام الناسِفة، مُتّخذين من الحرب في غزّة مِعيارًا للنظر. وعليه: إذا كان الفيلسوف في نهايته إنسان النُقصان، فهل يحِقّ لنا الحُكم على مواقفه حُكْمًا بالنَّسّفِ؟ وإذا كان الجواب بالنَفّي، ما طبيعة الأحكام المشروعة التي ينبغي أن نُطلِقها إذن؟ وكيف صَنَعت الحرب في غزّة حُجّة لبحث ذلك؟
1_ الحرب في غزّة واستدعاء الفلسفة للنظر
تتقدّم اليوم وفي هذه اللحظات التي سترتبِط بالآن والهُنا لكلّ من يقرأ هذه الحُروف، الحرب المُشنّة من طرف الكيان الإسرائيلي الغاشم ضِدّ الشعب الفلسطيني كحالة صادِقة وعيّنة حيّة من عيّنات توحّش الغرب ومنزعه الوجودي الإبادي. فمُنذ تاريخ السابع من أكتوبر ضِمن أزمنة العام الجاري، وإسرائيل بمُساندة بعض الأطراف الخائِنة لكلّ مبدأ شريف، للإنسانية بالدرجة الأولى، تُهاجم غزّة الجريحة المُمزّقة روحها وجسدها، بالتفجير والتخريب، وتعذيب الإنسان فيها وقتله وتشريده، وتدمير المَرافِق الضرورية من مُستشفيات ومدارس، فالأولى تُعيد الحياة بعد أن يأذن الخالق بذلك، والثانية تنسج خيوط الوعي الرَفيعة لتشكيل شعب ثائر ضِدّ الاغتصاب. إنّها حرب غازية ترمي إلى إبادة الآخر وامتلاك الوجود والحُدود، ولعلّ هذا الإجراء تعبير صريح عن تجذّر منطق التعقّل الأداتي النفعي، الذي فهِم أن تحصيل المنفعة يتحقّق بإلغاء كلّ القيم وإن كانت سامية، والقيمة المطلوبة والمرغوبة هي نجاعة الوسيلة رُغم شيّطنتها، فالغاية ستُبرِّر لها. وأن مُشاركة المنافِع سيُفقِدها لذّتها، ولهذا كانت الدافِع المُتغلّغِل في إنكار الغير تحسُّبًا لمركزية الأنا. ولعلّ حال الواقع المَعيش أكثر إقناعًا ولو جاء ضِدّ مأمولنا ومَسْعى معمولنا، وكمَا يُقال: العين أصدق أنباءً من الكتب، فالمشاهد الإجرامية تطرح نفسها يوميًا كمُجريات واقعية يُعانيها قطاع غزّة. ولأن الفلسفة كأسلوب مُتميّز في التفكير ومنهج عَميق، يخترِق المنقول ويُسائل المُعطى، ويتحرّى عن الأسباب الأولى والمرجعيات المُحرّكة، يتمتّع بحِسّ نقدي لا يُجامِل ولكن يُثمّن كلّ ماهو مِقدام لم يتورّط، فإنّه لا يُمكن أن يُفوِّت فُرصة النظر، ومُناسبة التفكّر بالتحليل والنقد والأشكلة والمحاجّة، مع تقديم المواقف بمُبرّراتها. ويأتي هذا الحُضور الفلسفي المُستمر، حُضورًا فاعِلاً بطُروحاته ومفاهيمه وأفكاره، وأدواته المنهجية الهادِفة إلى اجتراح الرؤى بما هي تفسيرات والأكثر طُموحًا لتغيير العالَم، كردّ فِعل ناقِد لكلّ من يدّعي موت الفلسفة من حيث تراجُع موضوعاتها المُفضّلة، ومن حيث انعزالها وتفلّسفها في أبراجٍ عاجية، والحقّ أنها لا تنفصِل عن ضَجيج الحياة كمَدار استشكالي واستدلالي حراري. ومَهْمَا اختلفت هذه الرؤى من عِدّة نواحٍ، وأثارت ضَجّة بخُصوص تصريحات الفلاسِفة من ضَجّة صاحِبة داعِمة، وأخرى رافِضة مُتذمِّرة، فإنّ للفلسفة كلمتها.
2_ مواقف الفلاسِفة من حالة الحرب في غزّة
بطبيعة الوضع، سيُتابِع الفلاسِفة الأحياء الذين يُزاولون نشاطهم الوجودي والأخلاقي والمعرفي في هذه الحياة حدث الحرب في غزّة، ويتصدّرون منابر الخِطاب، ويحضُرون اللقاءات الصُحفية من أجل الإدلاء برأيهم ونقل مواقفهم بشأنها. ومن بين هذه المواقف نجد الموقِف الذي خلّف موجة من النقد الشديد لفيلسوف التواصلية وأخلاق النقاش، الألماني "يورغن هابرماس" Jürgen Habermas (1929م) الذي أعلن في بيان تمت ترجمته إلى اللغة العربية، أنه يستنكِر خلفية التمييز العنصري وقضية مُعاداة السامية، ولم يُسجِّل الاستنكار ذاته فيمَا تعلّق بالهُجومات المُتوحِّشة الصهيونية ضِدّ الشعب الفلسطيني. وأضاف أن العِلة الجوهرية في تأزّم الوضع القائِم حاليًا تتعيّن في الهُجوم البربري لحركة حماس، الذي أعقبه ردّ فِعل إسرائيلي. فالمجزرة التي ارتكبتها حماس والمَرفوقة بِنِيَّتها المكشوفة لإبادة الوجود اليهودي بصِفة عامة، كانت سببًا في شحن إسرائيل ودفعها إلى الانتقام عن طريق هُجوم مُضاد. ما يُمكن التعليق به حول هذا الموقف، أنه موقف جاحِد لم يُوضِّح جميع أركان الحقيقة، وأنه مُنحاز إلى الكيان الإسرائيلي باعتباره نتيجة استفزاز حركة حماس. إنه موقف تبريري على أساس أن هُجومات إسرائيل هي هُجومات للدِفاع عن نفسها وعن شعبها، وكأنّ لسان الأمر يقول: لولاَ فِعل حماس الإجرامي لما كانت هُناك حرب!
يُضاف إليه، ما عبّر عنه الفيلسوف السلوفيني "سلافوي جيجيك" Slavoj ŽiŽek )1949م) "وجهان لعُملة واحِدة"، وذلك بتاريخ السابع عشر من أكتوبر الماضي، في حفل افتتاح الدورة الخامسة والسبعين من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، حيث استغرب من خِلال كلمته - التي خلّفت تضايُق الحُضور منها في بعض الأحيان - أنه في اللحظة التي يُحاول فيها أيّ شخص تبيين ضرورة تحليل الخلفية المُعقّدة للوضع، فإنّه يُتهم كمبدأ عام بدعم أو تسويغ إرهاب حماس. ومُنذ بِداية تفجّر هُجوم طوفان الأقصى، شبّه حركة حماس باليمين الإسرائيلي الحاكم في الفترة الراهِنة. وأن هذه الحركة والمُتشدّدون الإسرائيليون وجهان لعُملة واحدة، وفي نهاية قوله، أكّد على ضرورة دعم من دون قيد ولا شرط الحقّ الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه من مَدّ الهجمات الإرهابية، مع وجوب التعاطُف أيضًا من دون قيد ولا شرط مع الأوضاع المُزرية حقًا التي يُعانيها الفلسطينيون في غزّة والأراضي المُحتلّة.
رُغم أن "جيجيك" يبدو وَسَطيًا في رأيه، إلاّ أن توصيفه لحركة حماس جاء توصيفًا تعسّفيًا، على اعتبار أنها تُساوي المُتشدِّدة الإسرائيلية، في تهميش عَلَني لخاصّية المقاومة ولإرادة التحرّر التي تستحِق التنويه نظرًا لكونها تحمِل هَمًّا مصيريًا ورسالة شعب يتطلّع للعيش بكرامة وحُرّية.
وبالنِسبة لفيلسوف التعقيد Complexity والفكر المُركبComplex Thought ، الفرنسي "إدغار موران" Edgar Morin (1921م) فصرّح تصريحًا يأتي غريبًا مُقارنة بتقاليده الدِفاعية عن حقّ غزّة في تقرير المصير وتهكّمه باستغلال خلفية المحرقة اليهودية من قِبل الكيان الإسرائيلي([1]). ينقُل لنا رُعبه على إثر المَجازر الفَظيعة التي ارتكبتها حركة حماس في حقّ إسرائيل بتاريخ السابع من أكتوبر الفارِط، وأن إرهاب هذه الحركة قد أخفى رُعب دولة ردّت على الجماعة المُتعصِّبة الفاقِدة للرحمة بطريقة مُروِّعة. دائِمًا مع تنصيب حماس مُذّنِبًا ومُتَسَبِّبًا في حالة الحرب، وتبرئة إسرائيل بالوقوف إلى جانبها بحُجّة أنها عانت الرُعب من هذا التفجير، وبالتالي كانت هجماتها المُضادّة حقّ دِفاعي.
فِعلاً إنّ الأمر مُثير للدهشة من فيلسوف عوّدنا مِرارًا على النظر إليه بوصّفه فيلسوف الإنسانية قبل كلّ شيء، الذي لا يرتهن لأصله اليهودي بهدف التشريع للاضطهاد المُمارس من طرف إسرائيل في حقّ الشعب الفلسطيني، بل على النقيض يُجرِّم هذا الفِعل ويمنح بقية المحارق الحقّ في الاعتراف بها.
بيد أن واقع الحال بمُقتضى التصريحات والمواقف، يُظهر أن "موران" قد انزلق عن مَسَاره المعهود، نرى أن الإيطالي "جورجيو أغامبين" Giorgio Agamben (1942م) نحى مَنْحى مُختلِفًا، فقد وصف الظُروف القائِمة بصمت غزّة، في تدوينه له على موقعه الإلكتروني؛ حيث كتب التالي: "أعلن عُلماء من كُلّية عُلوم النبات في جامعة تل أبيب في الأيام الأخيرة، أنهم سَجّلوا بميكروفونات خاصّة حسّاسَة بالموجات فوق الصوتية صرخات الألم التي تصدرها النباتات عند قطعها أو عندما تفتقر إلى الماء. في غزّة لا توجد ميكروفونات!". يُظهِر هذا النصّ حجم الاضطهاد الذي يتعرّض له سُكان غزّة في ظلّ صمت رهيب عَمْدي، من دون رحمة وكأنهم جماد – رُبما لو كان الأمر مُرتبِط بالحجر لأوقفوا تحطيمه باعتباره فِعلاً من أفعال المُنكر- كمَا يُبيّن لنا "أغامبين" من خِلال هذه التدوينة، أنه يمتعِضّ سياسة الكيان الإسرائيلي وذلك بعرض نتائج عُلماء كُلّية النبات بتل أبيب التي تُبدي شفقة بخُصوص النبات فما بالُهم بالإنسان، الإنسان الغزّاوي، التي تغيب عنه الشفقة في صمتٍ قاتِل.
تتّبعُه في ذلك تقريبًا، الفيلسوفة الأمريكية "جوديث بتلر" Judith Butler (1956م)، عندما أكّدت على لُزوم اتّخاذ تعبير: "إبادة جماعية" على محمل الجِدّ، لأنه أبلغ توصيف لما يجري، فالهجمات لا تتصيّد المُقاتلين فقط، بل المدنيين والسُكان في غزّة أيضًا الذين يتعرّضون للقصف والنفي. هذا، وقد دَعَت مع عشرات الكتّاب والفنانين اليهود الأمريكيين في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى وقف إطلاق النار في غزّة. وهي عُضوة في المجلس الاستشاري لمُنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام. فضلاً عن قولها بوجود خُطط توضع بُغية نقل سكّان غزّة من منازلهم ومسح غزّة بأكملها، وذلك في مُقابلة لها مع منصة الديمقراطية الآن Democracy Now. بالإضافة إلى إصرارها على إبراز أهمية وضع سياق تاريخي لأحداث السابع من أكتوبر. وأنه من أجل فهم كيفية وقوع حدث مُعيّن، أو ما معناه، ينبغي علينا أن نتعلّم من التاريخ؛ أيّ توسيع رؤيتنا إلى ماوراء اللحظة الراهِنة المُروِّعة، من دون إنكار رُعبها، في الوقت ذاته عدم السماح لأن يختزل هذا الرُعب كلّ الرُعب الموجود([2]). إنه موقف فيه ضرب من الخوف على الإنسانية أن تُهلك في غياهب السُكوت أو الانحياز، وفيه نوع من الاعتراف بمَا يجري من محرقة ضِدّ شعب غزّة.
وبالمُجمل كانت هذه أبرز مواقف الفلاسِفة المعاصرين المُواكبين للحرب في غزّة، التي لم تكُن مُنصِفة ومُناصِرة في مُنتهاها لحقّ الشعب في غزّة في دفع الاحتلال عنه والنظر إلى مُقاومة حركة حماس بحسبِها مُقاومة عادِلة تُعبِّر عن إرادة الشُعوب في التحرّر والعيش في سلام وحُرّية Freedom من دون تضييق ولا تهديد، فكانت أغلبها مُنحازة إلى الكيان الإسرائيلي ومُسوِّغة لأفعاله الإجرامية بوصّفِها هُجومًا مُضادّ.
ولكن هل يُعقل أن نتوجّه إلى هؤلاء الفلاسِفة بعيّن النقد اللاذِع التهديمي لمشاريعهم التي كرّسوا حياتهم في التنظير لها؟ أليس بالإمكان القول بأن ما ننتظرُه من الفيلسوف في عُموم الشأن أمرًا مُبالغًا فيه وكأنه معصومًا من الزللّ؟
تحت أيّ لواء من المشروعية نمتلِكه حتى نُجرّم مواقف هؤلاء؟ إنّ القضية مُعقّدة ولا يُمكن اختزالها في منظور واحِد ولا حُكم مُعيّن يبدو أنه من قبيل الجاهز الذي يُطلقه أيّ شخص اليوم على تتبّع للحرب وأهوالها وتداعياتها وردود الأفعال الفلسفية التي تُثيرها، بالأخصّ إن كان ينتمي إلى الفلسفة من خِلال صِلة التدريس والبحث في موضوعاتها.
3_ ما الذي يُنتظر دائِمًا من الفيلسوف؟
إنّ الفيلسوف هو الصوت النقدي الحيّ، الذي يمتلِك نظرة شامِلة كلّية، تُفكّر في مَنْحَى عَميق، تتميّز بقُدرتها على مُداواة الإنسان الفرد والإنسان المُجتمع، لأنه يتوجّه إليه توجُّهًا مُتعدِّد الأبعاد، بالاهتمام بانشغالاته الأخلاقية وانشغالاته الوجودية وانشغالاته المعرفية، وإنّ حدث أن سيّطرت الرؤية الاختزالية في بعض الفترات.
سوف نلحظ في عُموم الشأن أن ما يُنتظر دومًا من الفيلسوف وما يأمله المُتتبّع لأثره، أن يكون بمثابة المُخلِّص الذي يتولّى مُهمّة تحرير الشُعوب من قيود الوصاية وأسر الأوهام، والمُتبصِّر ثاقِب النظر، والعقل الحكيم العادِل الذي لا ينطِق إلاّ الحقّ ولو ضِدّ قبيلته وفصيلته، وكأنه مُنزّه عن الخطأ. تكون مواقِفه لأجل الإنسانية جمعاء بصرف الانتباه إلى لونها، جُغرافيتها، دينها، لغتها وتاريخها، فالفيلسوف منهاج الرشاد المُنقِذ من ضلال التيّه وضياع الفُرقة والتمييز المَقيت.
ويحضُر هذا الاعتقاد عند المُشتغِلة بالفلسفة؛ أيّ الخاصّة في التفكير التي تقرأ فلسفيًا وتكتب فلسفيًا على اختلاف هذه القِراءات والكتابات من ناحية قوّتها وضُعفِها، عُمّقِها وسطّحيتها، إبداعها وتقليدها. في حين نجد أن أغلب الجمهرة من العامة لا يزالون مُتأخّرون عن إنصافه باعتباره صوت التحّريف، أو صوت تمضية أوقات الفراغ والانعزال في بيوت بعيدة عن ضوضاء الحياة اليومية. يُضاف، إلى أن المُنتظر من الفيلسوف أن تكون أفعاله مُطابِقة لأقواله، أن تتجسّد فلسفته في علاقاته المُتعالِقة مع ذاته وغيره والعالَم الذي يتفلّسف فيه، بالتحديد إن كانت طُروحاته تُبشِّر بالقيم الكونية Universall valuesوتدعو إلى العيش المُشتركLive together في توليفة إنسانية.
نعم إنّ هذا المأمول من الفيلسوف هو الحاصِل دومًا وعلى مَدَار التاريخ الإنساني، تَبعًا لقيمته ولإمكاناته التي جاءت عن طريق الاستعداد وأيضًا الاكتساب، لكن أن يتمّ تسطير هذا المُنتظر قالَبًا لا يُكسر، ومِعيارًا لا يتبدّل ولا يُمكن التفكير في غير ما يُعيّره، هُنا نُصبِح أمام إشكال عويص يستدعي مِنّا مُراجعة ما ننتظِرُه وِفق واقعية الأمر؛ إذ بالإمكان أن تكون أفعاله مُغايرة لأقواله في بعض الحالات، وتأتي مواقفه من أحداث مُعيّنة على غير عادة تصريحاته ومضامين تدّويناته، ففي نِهاية المشوار نحن أمام فيلسوف إنسان له من النُقصان ما يجعل منه محلّ نقد تأسيسًا على خُروجه من نَسَق التماثُل الذي لا يُمكن أن يحصُل لأيّ إنسان بمُوجب طبيعته الطامِحة إلى الاكتمال في استحالة تحقُّق الكَمَال. ويستحِق التنبيه في هذا الموضع، إلى أنّنا لا نُبرِّر إطلاقًا لخرجات بعض الفلاسِفة من الحرب في غزّة، ولا نُمرِّر نُقصان الفيلسوف ونُغطّي على مزالِقه خاصّة تِلك الجاحِدة بالحقّ، لكن ما نُريده هو التعامُل بأكثر عقلانية وواقعية مع مواقفه، لأنّنا نحن الذين نُطلِق الأحكام يتجذّر فينا كذلك إنسان النُقصان.
4_ الفيلسوف ليس روحًا سارية في الكون!
لا يأتي الفيلسوف كروح تسري في جميع نِقاط الكون، تضمّ الإنسانية قاطِبة ولا تستثني أحد، تسكُن كلّ العوالِم في لحظة تفكُّرها ونحتها لمفاهيمها وتأسيسها لطُروحاتها ولقواعد مناهجها، لمواقفها وتقديراتها، مَسْكَن الانتماء العابِر لضيّق الهوّيات والالتزام بكلّ شيء، دون إهمال أيّ تفصيلة من تفصيلات الكون. إنّما الفيلسوف له انتماءاته الخاصّة ومرجعياته المُحدّدة، ورؤية العالَم التي يرى بها عالَمه وعالَم غيره والعالَم الذي منه وإليه، تحضُر فيه ذاتيّته وغيّريته. صَحيح أنه يطرح رؤية تتّسِم بالشُمولية والكلّية فهذه هي سِّمات الفلسفة، بيّد أنه مَهْمَا حاول أن يقرأ ويكتُب باسم الكونية، إلاّ أن تضمينات ما يطرحه تحتوي مفاهيم ذات دلالة دينية وثقافية وتاريخية؛ أيّ أنها لا تخلو من مُقوّماته التأصيلية، فَمَثلاً لو نتأمّل في الجدل الهيغلي المبني على القضية، ونقيضها، والتركيب بينهُما، نلحظ أن هذه الأركان الثلاثة تُشير إلى الثالوث المسيحي: الأب، والابن، والروح القدسّ. ولا يُعدّ هذا الأمر عيّبًا أو نُقصًا فلسفيًا نتوجّه إليه بعيّن النقد الناسِف، إنّما نُثمِّنه في كثيرٍ من الأحيان، لأنه يُعبِّر عن قُوّة انتماء، ويُشكِّل دافِعًا من أجل الدِفاع وإنتاج الحُجّة.
ورَبْطًا بقضيتنا المركزية المُتعيّنة في مواقف الفلاسِفة من الحرب داخِل المُعترك الغزّاوي، فإنه لا داع لحملة السخطّ الشديد منها، وكأنّ أصحابها من طينة لا تُخطئ ولا تزيغ عن المبادئ الأولى، أو أنَّ ولاءهُم في الكون ولاءً كونيًّا.
5_ لا شُعورية التفكير داخِل التفكير
يتميّز الفيلسوف بكونه يعتمِد في تفكيره وتأمّلاته وتحليلاته الشكّية والنقدية على حالات من الوعي واليقظة والفِطنة والشُعور، حتى تكون استشكالاته واستدلالاته عَميقة تحترِق وتخترِق موضوعاتها، ولهذا مثلاً من بين صِفات الفيلسوف أن يكون احتجاجيًا مُناهِضًا ضِدّ أشكال التسلّط، داعيًا إلى ضرورة التحلّي بوعي كيّ لا تستغفِل الحُكومات المُستبِدة الشعب ولا تُعلِّب تفكيرهم وضميرهم، فينتُج عن الأول فَسَاد الهمم والثاني فَسَاد الذمم.
غير أنه يحدُث وأن يدخُل اللاشعور من حيث لا يدري الفيلسوف ولا يتحسّس داخِل تفكيره، بل إنه يتداخل مع الشُعور (الوعي)، له وقعه ودفعه. ولا يرتدّ هذا اللاشُعور بالضرورة حصّرًا إلى حالات من اللاوعي والغفلة، وإنّما يعود أيضًا إلى إملاءات الانتماء والأصل التي لا يُمكن التنصّل منها وإنكار تأثيرها، ولا الادّعاء بأنه يُفَكَّر بمعزل عنها؛ إذ حقًا ترتحِل الأفكار وتتعايش، ولكن يبقى لها أصلها وفصلها وعلاماتها الخُصوصية.
ثمّ إنّ بِنية التفكير في حدّ ذاته تتضمّن الشُعور واللاشُعور وكلّ الحالات الأخرى، بما فيها الانفعالات التي لها محلّها في تشكيل المواقف وبناء وجهات النظر، فالإنسان بما هو إنسان له تركيبته المُتشابِكة من أفكار ومشاعر ونوازع، وخيال، ومعرفة. ومن هُنا يُمكن أن يُعبِّر الفيلسوف عن موقفه من حدث ما ويُصرِّح لا شُعوريًا تصريحًا قد يستجلِب ضِدّه موجات المُمانعة والاعتراض، مع أنه بالإمكان أن يكون ما صرّح به في تِلك الحالة صادِقًا ويُمثِّل حقيقة ما يعتقد به.
ما يهُمّ في هذا السياق، أن مواقف الفلاسِفة قد تتبدّل وقد تأتي مُغايرة لما عهدناه عنهم أو لما نصّت عليه فلسفاتهم، ولذلك يجب عدم الإسراع في إطلاق الأحكام وإنّما التريّث وقِراءة الوضع بعيّنٍ لا تُهاجم بُغية الإدانة.
6_ بين إدانة الفيلسوف والفلسفة
نعم إنّ الفيلسوف من الفلسفة وإليها، فهي مذهبه وذهابه، ثمّ إنّ ما يُقدّمه وما يطرحه من مُختلف الأفكار والمناهج يُساهِم في كتابة تاريخها وترسيخ وجودها، ويُعزِّز حُضوره القوي في قِراءة الأحداث والكتابة حولها دور الفلسفة المحوري، ويُؤكِّد على إمداداتها النقدية الخلاّقة التي لا تنضب.
بيد أنه ومن زاوية أخرى، ينبغي الوعي عند إدانة مواقف الفيلسوف إن جاءت مُضلِّلة تشذّ عن الحقّ، مع أنّنا لا نُفضِّل اعتماد إجراء الإدانة إلاّ في حالات استثنائية لها ما يُبرّر استحقاقية ذلك، بأنّ الحديث عن إدانة الفيلسوف لا يتّبعه ضرورة إدانة الفلسفة؛ إذ ينبغي التمييز بين الفلسفة كنمط من التفكير ومنهج في التحليل والنقد، وأمّا الفيلسوف فهو الجانب التطبيقي لهذا النمط ولهذا المنهج، وبالتالي فهي ليست مُلزمة بما سينتُج عن تفلسُفه، وليست محسوبة عليه.
ليس من المشروعية بمكان أن نتحدّث عن كذب الفلسفة مثلاً خاصّة فلسفة الأنوار والحداثة والتقدّم الغربي، قِياسًا على مشاهِد الحُروب والاقتتال التي تعرفها الحياة المعاصرة كمَا عرفتها جميع مراحل التاريخ. لقد وصل الأمر ببعض أساتذة الفلسفة أن قالوا بأنهم أصبحوا يخجلون من تدريس الطلبة مقاييس النقد والتنوير والعالَم تسوده ظلامية حالِكة.
لماذا لا يتمّ انتهاج سبيل آخر، أن نُصرّ على قيمة الفلسفة رُغم ما يحدُث، أن ندعوها إلى إعادة إنتاج طُروحات تُراجِع من خِلالها مضامين العقل الحداثي، وتتمشّى بعقلانية ونقدية مع مُجريات الواقع.
إذا كان علينا الإدانة فإنّ من يستحقها فهو الإنسان في حدّ ذاته بما يُنتِجه وما يستهلكه، لأنّ فلسفة الأنوار ما هي إلاّ تجلّي لتفكير العقل الإنساني وِفق نَسَق مُعيّن، وما نعيشه من حُروب واشتباكات دموية عنيفة، ليست سببها الفلسفة حتى نُدينها، وإنّما الإنسان مرة ثانية وثالثة ودائِمًا، فهل سنظلّ عاكِفين على إدانة الحُقول المعرفية والعُلوم، في حين الإنسان هو المسؤول؛ بمعنى إنسان الفلسفة، إنسان عِلم الاجتماع، إنسان الاقتصاد، إنسان السياسة، إنسان التقنية، إنسان عِلم الأحياء، إنسان العُلوم التجريبية ونحو ذلك.
7_ بين إدانة الفيلسوف المُفكِّر والفيلسوف الإنسان
لا يُمكن للفلسفة أن تسمح بمرور أيّ فكرة هكذا من دون أن تُعرِّضها لمحكّ النظر ولميزان النقد، والحقّ أن هذا من بين مفاتيح تقدّم الفكر الفلسفي وانبثاق الأفكار وتجدُّدِها.
وإيصالاً بقضية النقد اللاذِع لمواقف الفلاسِفة من الحرب في غزّة، يُطرح سُؤال: هل نحن بصدد إدانة الفيلسوف المُفكِّر أم الفيلسوف الإنسان؟
في جوهرية فِعل الإدانة، فإنّنا ندين كُلاًّ منهُما، فالفيلسوف المُفكِّر، العارِف، تتّسِم معرفته بكونها نِسبية، لها رَشادها وأفكارها النيِّرة، كمَا لها ضلالاتها وأوهامها، لها موضوعيتها وذاتيتها، تأتي مُتناسِقة في بِنية واحِدة، مُخلِصة لِمَا ألفنا عن صاحبها من مواقف وتقديرات، وقد تأتي مقطوعة السِلسِلة بالتحديد بين المُنطلق والنتيجة، وبين القول والفِعل. وإنّ هذا لفي أصله مبنيٌّ على الفيلسوف الإنسان، إنسان النُقصان، الذي بدوره له نهضاته ونجاحاته، مِثلَمَا له عثراته ومزالقه، وله انتماؤه وأصلُه الذي يُؤثِّر ولو لا شُعوريًا.
يُضاف في هذا المَقام أن الإدانة إنّمَا هي قِراءة جارِحة لمنطق جدلية الفكر والواقع، تتّصِف ويجب أن تتّصِف بأنها ظرفية فَحَسب، وليست مُطلقة رُغم أن التاريخ يُسجّل ويحفظ؛ حيث بالإمكان أن تُعدَّل تِلك المواقف أو تتغيّر تَبَعًا لعِدّة عوامل؛ منها ما يرتبِط بمُراجعة الحِسابات، ومنها ما يتعلّق بحُصول قناعة جديدة ما يُشترط فيها أن تكون مُؤسَّسة على قوّة الحُجّة وعدّلها، ومنها كذلك ما يتّصِل باستيقاظ الضَمير من مرقد ظُلم الانتماء وعُنف عُجالة إعلان المُتّهم بتفجير الحرب في غزّة، لأن الأصحّ أن أولئك الفلاسِفة الذين قدّموا تصريحات هُم أيضًا قد مارسوا فِعل الإدانة، بالتحديد حينمَا أدانوا حركة حماس باعتبارها عِلّة الحرب، وتعاطفوا مع الكيان الإسرائيلي تحت مُسوّغ النظرة العُنصرية، و"الهُجوم المُضادّ" كردّ دِفاعي.
8_ نَسَفّ مضمون النظر بمُقتضى واقع العَمَل: مسؤولية يتحمّلها الفيلسوف والقارئ له
لابُدّ أن يتكامَل النظري والعَمَلي حتى يكون للأفكار من صدى ويكون لتقديراتنا وتقييماتنا من نفعٍ ونجاعة. أن نهدف إلى تجسيد ما نظّرنا وأسّسنا له في نِطاق حياتنا العَمَلية، خاصّة إنّ كُنّا ندعو إلى التحلّي بفضائل القيم والالتفاف حول الإنسانية. لكن قد يحدُث ويأتي واقع العَمَل مُغايرًا لمضمون النظر، فهل يحقّ لنا بذلك أن نَنّسِف ما احتواه النظر، وما خطّ له مُنذ عُقود؟
فلقد ذهب البعض مثلاً إلى سحب صِفة الفيلسوف من "هابرماس" والتقليل من قيمة نظريته في الفِعل التواصلي Theory of communicative action، على إثر موقفه من الحرب في غزّة.
بالطبع، نحن نُعارض ما ذهب إليه بالأخصّ حينمَا لم يعترف بجُرم الكيان الإسرائيلي في حقّ الشعب الفلسطيني، مِثلمَا نُعارض كلّ الفلاسِفة الذين صرّحوا بالتصريح ذاته. بيد أنه وفي تأكيدٍ مرة ثانية يجب أن نضع في حُسباننا عِدّة اعتبارات كوقع الانتماء. لا يُعقل أن نُهدِّم كلّ ما بناه الفيلسوف وما نظّر له طيلة حياته من أفكار ومبادئ وقيم، وإن كانت خرجاته العَمَلية عكّسية، ولا أن ننزع عنه صِفة الفيلسوف أو غيرها بسبب انزعاجنا وتضايُقنا منه، ينبغي أن نتعامل بأكثر عقلانية مُحّكَمة وأن نضع كلّ شيء في سياقه ونتحرّى عن عِللّه ومُناسَباته، ليس بهدف التبرير له ولكن تجنّبًا لأحكام النَّسف القاتِلة.
وإذا ما أردنا أن نتحدّث بصِدق واقعي عن من يتحمّل مسؤولية وقوع هذا النَّسَف، فإنّنا نُقرّ بأنها مسؤولية مُشتركة بين الفيلسوف والقارئ له الكاتب عنه، الأول في نُزوحه عن مُحتوى نظره، بالضَبط حينمَا تكون مواقفه وتصريحاته مُخالِفة لذلك، والثاني في الأحكام المُتعجِّلة التي تُدين من دون تريُّث، وتُلغي من دون الحِفاظ على استقلالية النظر في تكامُله مع العَمَل، فالاستقلالية ليست هي الانفصالية، بل هي سيادة الأفكار في ضَمَانة قيمتها دون الإخلال بها إن جاء العَمَل على غَيّر سيرتها.
9_ منطق الهُجوم والدفاع في الحرب، معيار لتعيين المُجرم من الضحية
لا تُعدّ حالة الحرب حالة بسيطة جُزئية، يُمكن تحديد أسبابها ونتائجها، مراميها الظاهرة والمُتوارية بسُهولة، إنّما هي حالة مُعقّدة تتداخل ضِمن عديد العناصر من مادية وبشرية، وتتطلّب إمّعان نظر وتحقيق عميق، وإحكام للعقل في تأمّله النقدي لأحداثها. فمِن بين أهمّ ما يُشكِّل تعقيدها هو دُخول الطبيعة البشرية كفاعِل في تفجُّرها، وهذه الطبيعة بدورها لها تعالُقاتها وتشابُكاتها. كمَا يُلاحظ في حالة الحرب كثرة التأويلات وتراشُق الاتهامات، لأنها تقوم على منطق الهُجوم والدفاع، الذي يُستند إليه كمعيار لتعيين المُجرم من الضحية، فالذي يُبادر بالهُجوم والتفجير ويُعبّر عن نزعة إمبريالية تهدِف إلى التوسّع واحتكار الوجود والحُدود؛ حيث يكون له السّبق، يُعيّن كمُجرم. وأمّا الذي يُدافِع لردّ ذلك الهُجوم بهُجوم مُضادّ، ويُبرِز نفسه في حالة حماية ومُقاومة، يُعيّن ضحية.
ونُنوّه إلى أن هذا المنطق الثُنائي معمول به في كافة أنواع الحُروب، سواء كانت حُروب عسكريةMilitary Wars، حُروب اقتصادية Economic Wars، حُروب سيبرانيةCyber Wars، حُروب بيولوجية Biological Wars وغيرها. وبصرف الاهتمام عن صِدق هذا التعيين، فقد يكون كاذِبًا ظالِمًا يُغطّي على الحقّ، إلاّ أنه شكليًا عقيدة تصنيف وتوصيف.
يُضاف إلى منطق الهُجوم والدِفاع، منطق آخر يتمثّل في التعّرية والفَضح؛ حيث تُزيل الحُجب وتكشِف عن حقائق كانت مخْفية في إطار التغطية السائِدة في أوضاع السِّلم والاستقرار، وتُبيّن لنا الأعداء من الحُلفاء، والخونة من الأوفياء، والبائعين لضمائرهم من الثائرين ضِدّ الباطل، ضِدّ قتل الأبرياء. ولا ينحاز الفهم صوب تثمين حالة الحرب بما أنها تنزع براقع التغّطية وتخلع الأقنعة، فلا أجمل من العيش بسَلام وإخاء ومحبة، يحقّ للجميع التمتّع بحُرّياته ويتوجّب عليه احترام نُقطة نِهايتها وبِداية حُرّية الآخرين.
10_ دافِعية رؤية "المَعيّة والضِدّية" في تقدير قيمة المواقف وترتيب العلاقات
وراء تقدير قيمة المواقف ودعمها أو مُعارضتها، وترتيب العلاقات بين من هُم أقرباء، أصدقاء، وبين من هُم أعداء، دافِعية رؤية المَعيّة والضِدّية. إن تكُن معي، ومع أفكاري، ومع تصوّراتي واعتقاداتي، ومع مبادئي وما أريده وأبتغيه، تُقدَّر مواقفك بتقدير إيجابي احتوائي، وتَدخُل في علاقة حيّة توليفية معي. وإن تكُن ضِدّي، وضِدّ أفكاري، وضِدّ تصوّراتي على هذا المِنوال، تُقدَّر مواقفك بتقدير سلبي طرّدي، وتدخُل في علاقة صِدامية معي.
إنها رؤية كامِنة في الطبيعة البشرية، لكن يجب عدم الخُضوع لها والامتثال التامّ لإملاءاتها، لأنها رؤية ضَيّقة الأفُق وذاتية التقدير، تعسُّفية تُقيّم الأقوال والأفعال نِسبة إلى منظورها الخاصّ الموصول بثُنائية المَعيّة والضِدّية.
11_ اختلاف المنظورات إلى العدالة، نِسبية الأخلاق وذاتيتها
إنّ ينظُر كلّ طرف بموجب منطق الهُجوم والدِفاع في الحرب، ووِفق دافِعية المَعيّة والضِدّية، ويُقرّ أن هذا الهُجوم مُضادّ يأتي كدِفاع عن النفس، وأمّا الآخر فهو هُجوم إجرامي مُتسبِّب في تفجير الحرب. وتأسيسًا على هذه التقديرات تختلِف المنظورات إلى العدالة، ونُصبح أمام عدالات، إذا كان كلّ واحد يُقدّر الأمور تَبَعًا لما يراه مُناسبًا لانتمائه، ولما يتّفِق مع تصوّراته ورغباته، فيرى أن هذه القضية عادلة وأخرى ظالِمة، وأن هذا الهُجوم عادل له ما يُشرّعه أخلاقيًا وسياسيًا واجتماعيًا، وذلك الهُجوم توحّشي مِثلمَا ما شهدته مواقف الفلاسِفة من الحرب في غزّة. ونَسلاً من هذا الاختلاف، تكون طبيعة الأخلاق نِسبية مُتغيّرة، ذاتية المنبع عندمَا يختلِف مقياس النظر إلى العدالة.
12_ مصير القيم الكونية في ظلّ فلاسِفة يرتحلون ثمّ يمكُثون
ينبثِق سؤال مصير القيم الكونية من قيم التسامُح Tolerance، التواصل Communication، الاعتراف Recognition، الفهم Understanding، الحقّTruth، الخيرGoodness، الحُرّية، العيش المُشترك والتلاحُم Cohesion، الاختلاف Difference والائتلاف Coalition، التعدّدية الثقافية Cultural pluralism، التي يرتحِل من خِلال التأسيس لها الفيلسوفُ، ويَعبُر ضيّق القارات والجُغرافيات والألوان والأجناس والثقافات واللغات والعقائد، يجوب أنحاء الكون في رِحلة كونية عالَمية تتجاوز الرّقعات المأسورة، في سياق ارتحال فكري للفلاسِفة، لكنهم يمكُثون؛ أيّ ينتصرون لقيم بعيّنها ولثقافات مُحدّدة لجماعات مخصوصة، ويُسجّلون مواقف تتنكّر لتِلك القيم الكونية. إلى أين ستسير هذه القيم؟ هل نحو الانحباس أكثر في أسر النظر؟ أم ستعرِف انفراجًا عن طريق تجّسيدها عَمَليًا؟ لا يُمكن الإقرار بشكلٍ مُطلق جازِم، وإنّما فقط بالإمكان توقّع ما سيحدُث بِناءً على ما يحدُث مع ترك المجال مفتوح أمام اللامُتوقّع.
إنّ الأحداث الجارية ومنها الحرب في غزّة الجريحة، غزّة الكرامة والحُرّية، قد أبانت عن سُقوط رهيب للقيم الكونية ولمبادئ الإخاء والإنسانية والعيش بسلام، في الضِفّة المُقابِلة أبرز تصاعُد كبير للأفعال الإجرامية من تعذيب، وقتل، ونفي وتشريد، وانتهاك للأرض. وكَشفت عن أن العقل الغربي عقل إبادي في الحُروب، منزعه إقصائي، وهدفه الانفراد والمركزية. وبالتالي يبدو أن مصير القيم الكونية هو الانحدار والبقاء في حالة الشعارات.
بيد أنه بما أن الخير موجود دائِمًا على الرُغم من تفاقُم مُعدّلات الشرّ في بعض الفترات، وبما أن الإنسانية قيمة حيّة لن تموت مَهّمَا حاولت شيّطنة الإنسان ذاته قتلها، ستظلّ هذه القيم تُنازع لأجل الانبثاق المُستمر من خِلال التنظير والسّعي عبر إنسانها الإنسان بُغية التجسيد، هي صورة من صُور المُقاومة.
13_ متى نقرأ الحدث؟ ومتى نكتُب عنه؟ ومتى نُطلق الحُكم بشأن مواقف الفلاسِفة؟
في هذا المنْحَى، نجد أنفسُنا أمام قَلَقْ الأسئلة التالية: متى نقرأ الحدث؟ هل نقرأ الحدث قبل حُدوثه؛ بمعنى تكوين نظرة استشرافية مُستقبلية وِفق منطق التنبؤ؟ أم نقرأ الحدث أثناء الحدث؛ أيّ في عزّ تفجّراته وانبثاقاته، في عُمق مُجرياته وتداعياته الحينية؟ أم نترك الحدث حتى يحدُث ويهدأ ثمّ نقرأ ما بعد الحدث؟
متى نكتُب عن الحدث، هل قبل حُدوثه أم أثناء حُدوثه أم بعد ذلك؟
وفيمَا يتعلّق بقضية الحُكم بشأن مواقف الفلاسِفة من الحدث، متى نُطلق الحُكم؟ متى نُصدِر تقديراتنا؟ ومتى نُسجِّل موقفنا من هذه المواقف خاصّة إذا تناولت قضايا نوعية وإشكالات حاسِمة لها مساسّ مُباشرة بالحياة الإنسانية كالحرب؟
إنّ الأنسب والأصوب بحَسَب وجهة نظرنا وزاوية تفكُّرنا، أن يتفاعل الفيلسوف مع الحدث تفاعُلاً مُركّبًا كُلّيًا شامِلاً وِفق ما تقتضيه خاصّية الفلسفة. فيعتمِد في ذلك على استعداداته العقلية ومُكتسباته الخبراتية، وربطًا بالماضي والحاضر، ينسِج نظرة استشرافية للمُستقبل؛ أيّ للحدث، مع الأخذ بالأسباب دون غلق الطريق أمام احتمالية الصُدف. وهذا ما يُدعى بنبوءة الفيلسوف. وأما أثناء الحدث، فيُواكب حركته وما يطرحه، فينظُر إليه من داخله (مكان، زمان، مُجريات الحدث وأطرافه المُباشرة) ومن خارجه (تداعياته ومواقف الأطراف الأخرى). بعدها يقرأ الحدث بعدما ينتهي. ليخلُص إلى إنتاج طرح عَميق ودَقيق لم يُهمِل أيّ مرحلة.
وأمّا عن الكتابة حول ما قرأه، فتكون هي أيضًا على نفس الشاكِلة، وتتزامَن مع فِعل القِراءة؛ بمعنى يقرأ ويكتُب، فالأفكار لا تنتظِر، تتطلّب التدوين في الحين وهي في أوجّ عطائها. ثمّ إنّ الكتابة هي الملمح البارِز للقِراءة، فهي الترسيخ لها، والجسر الممدود بينها وبين القارئ لأنه سيقرأ ما سيُكتَب.
وبالنِسبة للمُشتغِل بالفلسفة من أساتذة وباحثين، فلهم أن ينتهجوا النهج ذاته، فيقرؤا ويكتبوا عن الحدث قبله وحينه وبعده، بمُقتضى قِراءات وكتابات تُبدِعُها الأنا، وأيضًا بالاعتماد على بعض طُروحات الفلاسِفة بتحليلها ونقدها.
وأمّا عن المُناقشة والتعقيب بشأن مواقفهم من حدث ما كالحرب في غزّة، فإنّه لمن أحسن المسالِك، أن يتّخذوا مَسْلَك التريُّث والانتظار لفترة، حتى يكتمِل المشهد وتتّضِح الصورة، ويُصبح بالإمكان إقامة الحُجّة سواء للدّفاع أو للاعتراض. ومَسْلَك نِسبية الحُكم وتعليقه عن المُطلق والرأي النِهائي، بالتنويه إلى أن هذه المواقف مُنفتِحة على التعديل والتغيير، بما أن صاحبها إنسان يُفكِّر، يتفلسف، يطمح للاكتمال ويستحيل أن يُدرِك الكَمَال، يظلّ في نهاية المَسَار إنسان النُقصان.
على سَبيل الخِتام:
في نِهاية هذه المحاولة التفكُّرية النقدية، التي أرادت أن تُوضِّح أن الفيلسوف في جوهريته إنسان النُقصان له نجاحاته كمَا له إخفاقاته، له حِكمَتِه مِثّلَمَا له عثراته، لا يُمكن إدانة مواقفه إدانة قطعية لا عُدول عنها، أو الإقرار بتهافُت مشروعه الفلسفي ككلّ بسبب مزّلَق قد يكون مُتعمّدًا بوعي وشُعور، وقد يكون لا شُعوريًا فرضه تأثير الانتماء مثلاً. وفي خيرة القول علينا أن نُراجع كيفية تفاعُلِنا مع الأحداث ومواقف الفلاسِفة منها كمواقفهم من الحرب في غزّة، بصرف النظر إن جاءت مع رؤيتنا أو ضِدّها، ينبغي مُساءلتها ومُناقشتها بعيّنٍ ناقِدة عقلانية تتحرّى أن تكون حَكيمة ورَصينة بعيدًا عن أغاليط الذاتية العَمياء، ونُركِّز تأكيدنا على لفظة "عَمياء" لأن الذاتية المُهذّبة هي رافِد من روافِد بناء الرأي، تُساهم في سداده، لكن إن تَكُن مُفرِطة، فإنّها تُعمي صاحِبها عن إدراك الحقّ. مع ضرورة الابتعاد عن أحكام النَّسْف الهدّامة التي تقتُل الجُهود ولا تتصيّد إلاّ الأخطاء لتجعلها كلّ الجُهد المبذول.
ونُنوّه خِلال هذا المقام، أنه يجب تغيير ذهنية الانتظار المُنتصِرة لنا، تِلك التي تنتظِر دومًا من الفيلسوف أو المُثقف أن يُناصِر قضايانا وما نعتقِد به ونرغب فيه، لأنه هو ذاته له خلفياته ومقاصِده كتِلك التي لديّنا.
بطبيعة الحال، نحن لا ندعو إلى التبرير لمواقفه إن كانت تعسّفية لعِلّة انبنائها على الأصل والمرجعية، بل نُريد التأسيس لثقافة قِراءة وكتابة مُنفتِحة، عاقِلة وواعية، تُدرِك أن ما تقرأه وما تكتُبه سينال الأحكام ذاتها على مِنوال ما أطلقته من أحكام.
_ قائمة المراجع:
1_ إدغار موران، المنهج، الأفكار: مقامها، حياتها، عاداتها وتنظيمها، تر: جمال شحيّد، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2012م.
2_ للتفصيل في هذه المواقف، راجع: جودي سليم، آراء أربعة فلاسِفة مُعاصرين بشأن الحرب في غزّة
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org
/v/s/www.bbc.com/arabic/articles/c72r8vl850.amp?amp_gsa=1&_js_v=a …
[1]() للتوسّع والاستزادة، راجع المؤلّف التالي: إدغار موران، المنهج، الأفكار: مقامها، حياتها، عاداتها وتنظيمها، تر: جمال شحيّد، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2012م، الجزء الرابع، ص ص 9 _ 10.
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org
/v/s/www.bbc.com/arabic/articles/c72r8vl850.amp?amp_gsa=1&_js_v=a …
تمّ النشر بتاريخ: 5 نوفمبر 2023م، تمّ التصفّح بتاريخ: 27 ديسمبر 2023م، الساعة: 10:48