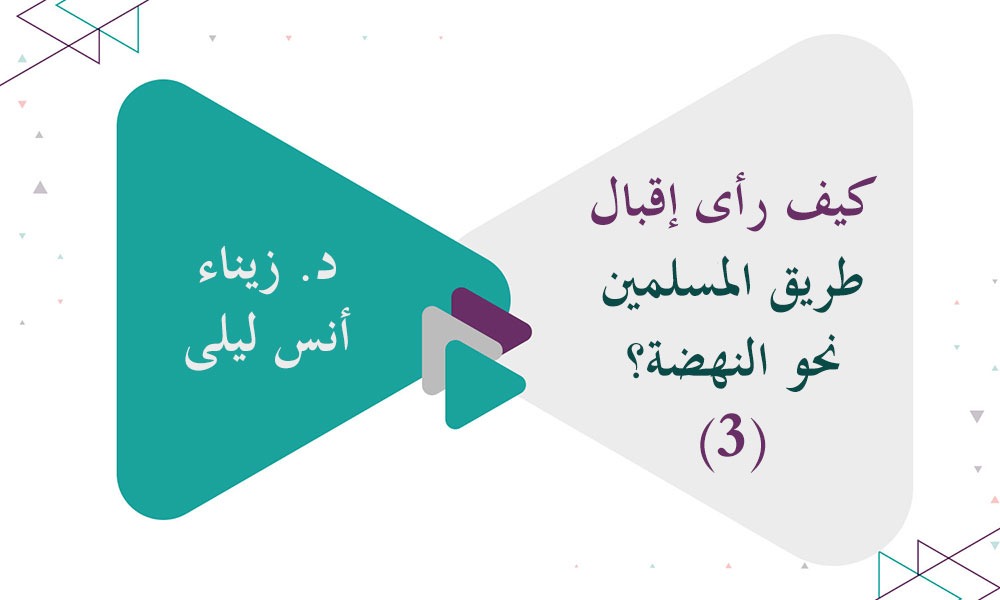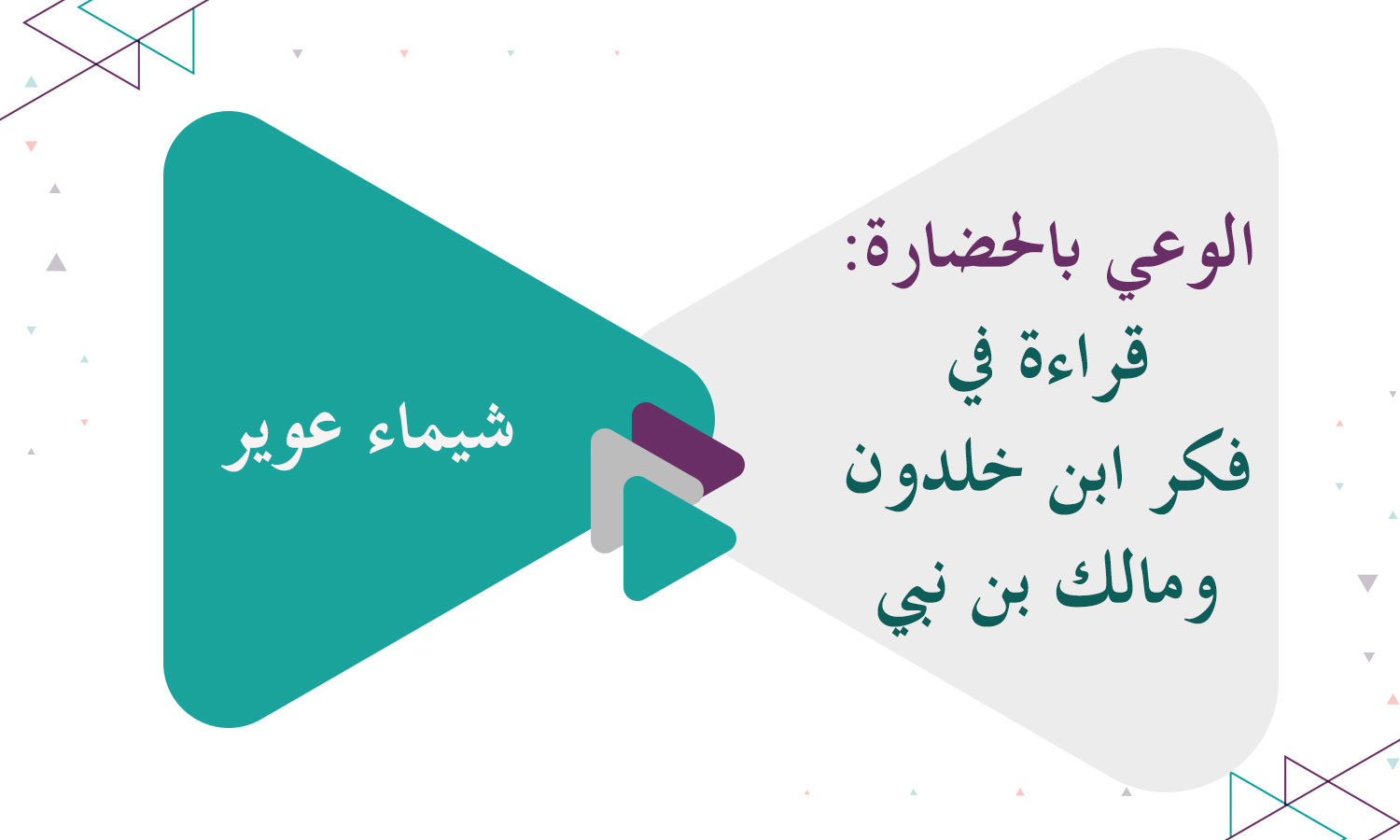الحضارة ليست حجارة تُشيَّد، ولا قصورًا تُبنى، بل هي روح تُنفخ في الإنسان، فإذا دبت فيه استقام عمرانه. فإذا خبت ضعفت دولته وذبل تاريخه. لذلك ظل سؤال الحضارة من أعمق الأسئلة التي تشغل الفكر الإنساني، إذ يطرح الفلاسفة والمؤرخون والمصلحون معًا سؤالًا جوهريًا: ما الذي يصنع الحضارة؟ وكيف تنهار الأمم بعد مجدها؟
وقد انشغل بهذا السؤال عقلان كبيران في تاريخ الفكر الإسلامي: عبد الرحمن بن خلدون، المؤرخ الاجتماعي الذي قرأ التاريخ بلغة العقل والعمران، ومالك بن نبي، المفكر الذي قرأ التاريخ بلغة الروح والفكرة. ورغم البعد الزمني بينهما، إلا أنّ كليهما حاول أن يكشف عن القوانين الداخلية التي تتحكم في ميلاد الحضارات وسقوطها، فكان كلٌّ منهما مرآةً للآخر من زاوية مختلفة.
يرى ابن خلدون أن سرّ قيام الدول والحضارات يكمن في العصبية، وهي ليست مجرد الانتماء القبلي أو الولاء العاطفي، بل الطاقة المعنوية التي توحّد الناس حول غاية مشتركة وتمنحهم إرادة الفعل الجماعي. حين تشتد العصبية في بدايات العمران، تنبعث الهمم ويغدو المجتمع كتلة واحدة متماسكة، فينشئ الدولة ويقيم النظام ويبدع في العمل. لكن ما إن يتذوق الإنسان طعم الرفاه والدعة حتى تتحول العصبية إلى أنانية، فيفقد المجتمع روحه القتالية وقدرته على الاستمرار، وتبدأ دورة الانحطاط.
ولذلك شبّه ابن خلدون الدولة بالإنسان في أطوار حياته: تبدأ بالقوة والطموح، ثم تبلغ أوجها بالعقل والتنظيم، ثم تشيخ بالترف والكسل حتى تموت. إنّها دورة طبيعية، لكنّها ليست قدرًا حتميًا، إذ يمكن للأمم أن تتجدد إذا استعاد الناس عصبيتهم وأصلحوا ما فسد من أخلاقهم. فابن خلدون لم ينظر إلى التاريخ كحكاية ملوك وغزوات، بل كحركة اجتماعية تحكمها قوانين النفس الإنسانية. ومتى ماتت الإرادة مات التاريخ، لأنّ سقوط الحضارة لا يبدأ من الخارج، بل من الداخل حين تذبل الروح وتتلاشى الغاية ويتحوّل الإنسان من فاعل إلى مستهلك.
أما مالك بن نبي فقد ورث من ابن خلدون روح السؤال، لكنه نقل التحليل من ميدان الاجتماع السياسي إلى ميدان الفكرة. لم يكن يبحث عن الدولة بل عن الإنسان الذي تصنعه الفكرة والثقافة. وله عبارته المشهورة: «مشكلتنا ليست في الأشياء، بل في الأفكار.» فالأمم لا تنهض بما تملك من أدوات مادية، بل بما تملك من فكرة حيّة تنظم العلاقة بين الإنسان والتراب والزمن.
ويعتقد بن نبي أنّ الحضارة تمرّ بثلاث مراحل أساسية: مرحلة الروح، ثم مرحلة العقل، ثم مرحلة الغريزة. تبدأ حين تولد في الضمير الإنساني فكرة دينية تهزّ النفس وتوقظها من سباتها، ثم يتحول هذا الإيمان إلى نظام عقلي ومؤسسات وقوانين تعبّر عنه، وهي ذروة النضج الحضاري. لكن ما إن تطغى المادة على الروح حتى تنقلب الطاقة الخلّاقة إلى شهوة استهلاكية، فيسود الترف والأنانية، ويبدأ الانحطاط.
هذا التحليل العميق يجعل من مالك بن نبي فيلسوفًا للنهضة، لا مؤرخًا للماضي، لأنه لا يكتفي بوصف ما جرى، بل يدعو إلى استعادة الشروط الروحية التي تمكّن الأمة من تجديد ذاتها من الداخل. فالاستعمار الأخطر عنده ليس العسكري، بل ما سماه الاستعمار الفكري الذي يشلّ الإرادة ويزرع عقدة العجز في النفس.
وما يجمع بين ابن خلدون ومالك بن نبي هو إدراكهما أنّ التاريخ لا يتحرك بالصدف، بل وفق منطقٍ دقيق تحكمه سنن اجتماعية وروحية. كلاهما يبحث عن القوانين التي تفسّر ولادة الحضارات وسقوطها. غير أنّ ابن خلدون ينطلق من الواقع الاجتماعي فيفسّره بعوامل القوة والضعف، بينما ينطلق مالك بن نبي من الواقع النفسي والثقافي فيفسّره بعوامل الإيمان والفكرة.
فإذا كان ابن خلدون قد اكتشف قانون العصبية الذي يفسّر ولادة الدولة، فإن مالك بن نبي قد اكتشف قانون الفكرة الذي يفسّر ولادة الحضارة. فإذا كان ابن خلدون يدرس العمران من الخارج، فإن بن نبي يدرسه من الداخل. وكأنّ ابن خلدون يصف جسد الحضارة، ومالك بن نبي يصف روحها.
وعند المقارنة بينهما نرى أنّ العصبية التي تحدث عنها ابن خلدون يمكن أن تُفهم اليوم بلغة مالك بن نبي: فهي الطاقة الأخلاقية التي تجعل الناس يتجاوزون ذواتهم نحو هدفٍ أسمى. فحين تغيب الفكرة تموت العصبية، وحين تذبل العصبية تموت الفكرة. بهذا المعنى يكمل كلٌّ منهما الآخر، لأنّ الحضارة في جوهرها توازن بين المادي والروحي، بين التنظيم والإيمان، بين الجسد والروح.
وفي واقعنا المعاصر ما يؤكد صدق تحليلهما معًا؛ فالمجتمعات الحديثة بلغت ذروة التقدّم المادي، لكنها تعاني فراغًا روحيًا جعل الإنسان فيها غريبًا عن ذاته، بينما تعيش مجتمعات أخرى حرارة الإيمان، لكنها تفتقر إلى التنظيم والعقلانية. فالحضارة لا تقوم على الروح وحدها، ولا على المادة وحدها، بل على لقائهما الخلّاق.
أراد ابن خلدون بقوله التاريخي ما أراد مالك بن نبي قوله بفلسفته: أن الحضارة ليست بناءً مؤقتًا، بل وعيًا بالوجود، وأنّ سقوطها يبدأ حين ينسى الإنسان غايته في الوجود. ولذلك فإن تجديد الحضارة الإسلامية اليوم لا يكون باستيراد أدوات الغرب، بل بإحياء روحها الداخلية التي قامت عليها أول مرة، تلك التي عبّر عنها القرآن بكلمة: «اقرأ نفسك والعالم والزمن»، أي اقرأ قراءة تجعل منك شاهدًا لا تابعًا.
الأمم لا تنهزم حين تنهزم عسكريًا، بل حين تفقد معناها، والإنسان لا يكون حضاريًا بقدر ما يملك من مال، بل بقدر ما يحمل من رسالة. لذا يمكن القول إن ابن خلدون ومالك بن نبي التقيا في النهاية عند فكرة واحدة: أنّ الحضارة تُبنى بالإنسان أو لا تُبنى أبدًا.
اختلفت لغتهما، لكن الهدف واحد: أن يُستعاد الإنسان بوصفه صانع التاريخ، لا صنيعة له. بين علم الاجتماع وفلسفة الوعي، المسافة بينهما امتدادٌ للتاريخ نفسه. ولعل أجمل ما نختم به هو أن النهضة لا تبدأ من حيث تُبنى المصانع، بل من حيث يُخلق المعنى في قلوب الناس. فحين تمتلك الأمة فكرة حيّة تتحرك فيها العصبية الخلّاقة، يولد الإنسان من جديد، وتبدأ الدورة الحضارية التي حلم بها مالك بن نبي: دورة توازن بين الروح والعقل، بين الإيمان والفعل، بين الإنسان والتاريخ.