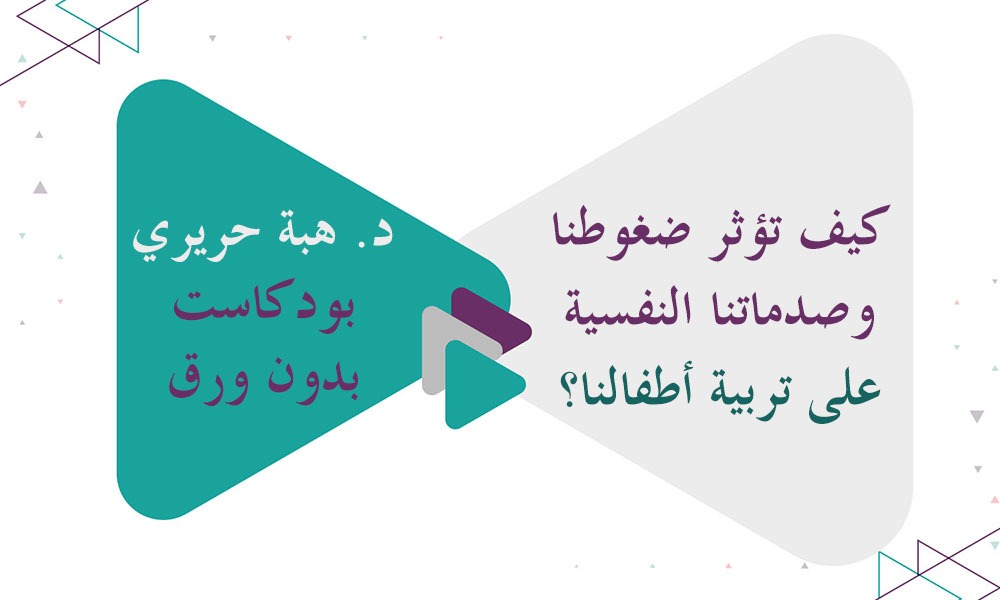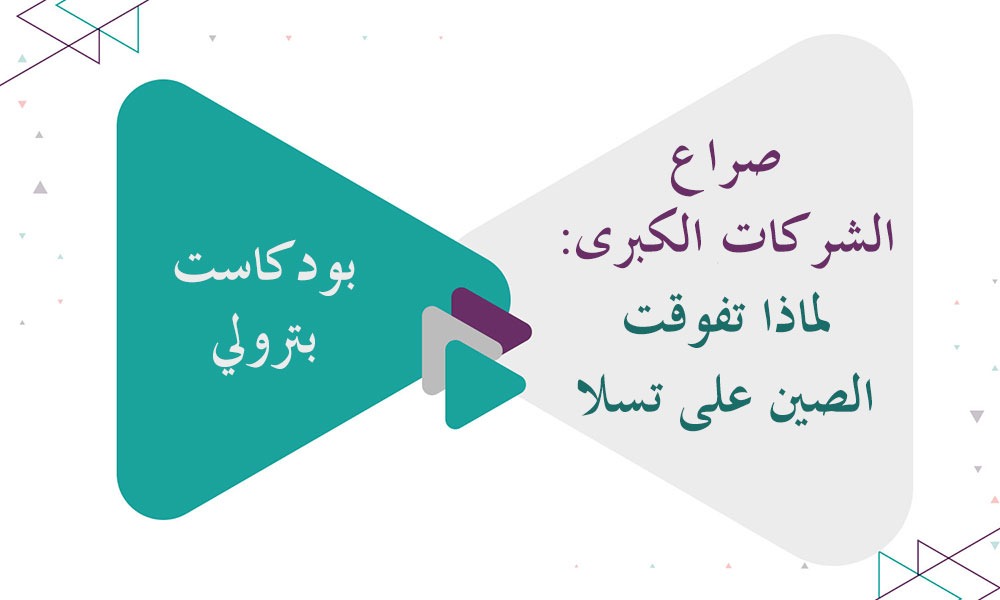إدارة الأداء: كيف تقضي على الهدر في عملك | أصدقاء بترولي
في هذه الحلقة من أصدقاء بترولي، نخوض معكم في حوار ثري وعميق مع الدكتور محمد العامري المدرب والخبير الاستشاري والأستاذ عبد العزيز المالكي المتخصص في بناء الاستراتيجيات وتحسين الأداء، نستعرض معهما كيف يمكن تحويل صراع الأنا بين المدربين والمهنيين إلى تحالفات فكرية تُعلي من قيمة الفكرة وتخفض من مركزية الشخص، ونغوص في مفهوم إدارة الأداء الوظيفي بوصفه "القلب النابض للمنظمة"، وكيف يُعد من أهم أدوات التحسين المستمر لا أداة رقابية فقط.
نقارن بين التقييم التقليدي الذي يعتمد على المراتب والنسب، والتقويم الحديث الذي يركز على التمكين والنمو، ونكشف كيف تسهم إدارة الأداء في القضاء على الهدر بجميع أنواعه – المورا، الموري، المودا – وتحويلها إلى فرص تحسين فعلية.
نفتح النقاش حول مسؤولية المدير تجاه أداء فريقه، وكيف يمكن للتغذية الراجعة الفورية والمبنية على شواهد واقعية أن تُحدث نقلة في جودة العمل. ونتناول تجارب حية وملهمة لتطبيق إدارة الأداء في قطاعات محورية مثل التعليم ووزارة الحج، مع تسليط الضوء على دور إدارة تقنية المعلومات كمحرك خفي لهذا التحول.
نفتح النقاش حول مسؤولية المدير تجاه أداء فريقه، وكيف يمكن للتغذية الراجعة الفورية والمبنية على شواهد واقعية أن تُحدث نقلة في جودة العمل. ونتناول تجارب حية وملهمة لتطبيق إدارة الأداء في قطاعات محورية مثل التعليم ووزارة الحج، مع تسليط الضوء على دور إدارة تقنية المعلومات كمحرك خفي لهذا التحول.
نتعمق في مسار نضج المدرب من مبتدئ إلى منتج معرفة، ونتوقف عند تجربة الأستاذ عبد العزيز في إنشاء قناة على التليجرام أصبحت اليوم مرجعًا عربيًا في إدارة الأداء العالي، ومصدرًا لتحويل الموظفين من مستهلكي محتوى إلى صُنّاع له.
هذه الحلقة ليست فقط حوارًا إداريًا، بل خريطة طريق تساعد كل من يسعى لتطوير ذاته أو فريقه، وتُلهم المدراء والموظفين معًا لتصميم حياة مهنية أكثر كفاءة وتوازنًا، تتماشى مع طموحات رؤية 2030 وتحديات بيئة العمل الحديثة.
محاور الحلقة:
00:00:00 مقدمة الحلقة وتعريف بالضيوف
00:01:17 من هو المسؤول عن انخفاض أداء الموظف؟
00:09:02 نموذج التنسيق في إدارة الأداء
00:12:23 مراحل نضج المدربين حسب نموذج سيبرمان
00:15:15 مفهوم إدارة الأداء الوظيفي
00:19:20 الفرق بين تقييم الأداء وإدارة الأداء
00:22:11 عملية التقويم وتحسين الأداء
00:26:29 مهام المدير في إدارة الأداء
00:37:51 المراحل الأساسية لإدارة الأداء
00:45:30 تطبيق بطاقة الأداء المتوازن
00:52:04 التحديات في تطبيق إدارة الأداء
01:00:04 ربط الأهداف بالتحفيز والإنجاز
01:04:29 نجاح تطبيق إدارة الأداء في بيئة العمل
01:09:10 ختام الحلقة والشكر للضيوف
محاور الحلقة:
00:00:00 مقدمة الحلقة وتعريف بالضيوف
00:01:17 من هو المسؤول عن انخفاض أداء الموظف؟
00:09:02 نموذج التنسيق في إدارة الأداء
00:12:23 مراحل نضج المدربين حسب نموذج سيبرمان
00:15:15 مفهوم إدارة الأداء الوظيفي
00:19:20 الفرق بين تقييم الأداء وإدارة الأداء
00:22:11 عملية التقويم وتحسين الأداء
00:26:29 مهام المدير في إدارة الأداء
00:37:51 المراحل الأساسية لإدارة الأداء
00:45:30 تطبيق بطاقة الأداء المتوازن
00:52:04 التحديات في تطبيق إدارة الأداء
01:00:04 ربط الأهداف بالتحفيز والإنجاز
01:04:29 نجاح تطبيق إدارة الأداء في بيئة العمل
01:09:10 ختام الحلقة والشكر للضيوف
ملخص شامل:
1. من المسؤول عن انخفاض أداء الموظف؟
تدور هذه الفقرة حول سؤال جوهري: هل المسؤول عن ضعف أداء الموظف هو الموظف نفسه أم المدير؟ يرى الضيفان أن المسؤولية تقع أولاً على المدير، لا سيما إذا لم يوفّر البيئة اللازمة التي تُمكّن الموظف من النجاح. يشير الحديث إلى مفارقة شائعة حيث يُعاقب الموظف على الأداء دون وجود توصيف وظيفي واضح، أو أهداف محددة، أو تغذية راجعة بنّاءة. يُطرح نموذج "القرود" كتشبيه لمدير يتحمّل كل المهام دون تفويض أو توزيع منظم، ما يؤدي إلى تراكم الأعباء وانهيار منظومة الأداء. يؤكد الضيفان أن دور المدير المحترف يبدأ من التخطيط ثم التنظيم، فالمتابعة والتوجيه والتقويم، وأن أي خلل في أداء الموظف ينبغي أن يُعالج أولًا بالنظر إلى مدى فاعلية الإدارة، قبل محاسبة الأفراد. في هذا السياق، تُعد إدارة الأداء أداة تمكينية لا رقابية، تهدف إلى إطلاق قدرات الموظفين وتوجيهها بذكاء نحو الأهداف المؤسسية.
1. من المسؤول عن انخفاض أداء الموظف؟
تدور هذه الفقرة حول سؤال جوهري: هل المسؤول عن ضعف أداء الموظف هو الموظف نفسه أم المدير؟ يرى الضيفان أن المسؤولية تقع أولاً على المدير، لا سيما إذا لم يوفّر البيئة اللازمة التي تُمكّن الموظف من النجاح. يشير الحديث إلى مفارقة شائعة حيث يُعاقب الموظف على الأداء دون وجود توصيف وظيفي واضح، أو أهداف محددة، أو تغذية راجعة بنّاءة. يُطرح نموذج "القرود" كتشبيه لمدير يتحمّل كل المهام دون تفويض أو توزيع منظم، ما يؤدي إلى تراكم الأعباء وانهيار منظومة الأداء. يؤكد الضيفان أن دور المدير المحترف يبدأ من التخطيط ثم التنظيم، فالمتابعة والتوجيه والتقويم، وأن أي خلل في أداء الموظف ينبغي أن يُعالج أولًا بالنظر إلى مدى فاعلية الإدارة، قبل محاسبة الأفراد. في هذا السياق، تُعد إدارة الأداء أداة تمكينية لا رقابية، تهدف إلى إطلاق قدرات الموظفين وتوجيهها بذكاء نحو الأهداف المؤسسية.
2. نموذج التنسيق في إدارة الأداء
يعرض المحور فكرة "نموذج التنسيق" في العمل الجماعي، سواء في التدريب أو إدارة الأداء، ويؤكد أن نجاح أي مشروع جماعي يرتبط بالتحضير المسبق والتفاهم حول الأدوار وتوزيع المهام. يتم استحضار تجارب حقيقية مثل التعاون بين الدكتور محمد العامري والدكتور عايض القرني، حيث تم تخصيص ثلاثة أشهر لتحضير أمسية تدريبية ليوم واحد. يؤكد المتحدثان أن غياب التنسيق يؤدي إلى التداخل بين المدربين أو تضارب الرسائل الموجهة للجمهور، مما يضعف الأثر المهني. كما يشير النموذج إلى أهمية الانسجام بين الأسلوب المسرحي والتفاعلي، حيث يدعم كل طرف الآخر أثناء التقديم. في السياق الإداري، يُعتبر التنسيق بين الإدارات (التقنية، الموارد البشرية، الإدارة العليا) أمرًا أساسيًا لضمان سلاسة إدارة الأداء وتكامل الأدوار. يعكس هذا النموذج مبدأ العمل كفريق واحد باتجاه هدف مشترك، ويركز على خلق بيئة تواصلية محترفة ترفع من جودة الأداء التنظيمي وتقلل من الهدر الناتج عن الفوضى التنظيمية.
يعرض المحور فكرة "نموذج التنسيق" في العمل الجماعي، سواء في التدريب أو إدارة الأداء، ويؤكد أن نجاح أي مشروع جماعي يرتبط بالتحضير المسبق والتفاهم حول الأدوار وتوزيع المهام. يتم استحضار تجارب حقيقية مثل التعاون بين الدكتور محمد العامري والدكتور عايض القرني، حيث تم تخصيص ثلاثة أشهر لتحضير أمسية تدريبية ليوم واحد. يؤكد المتحدثان أن غياب التنسيق يؤدي إلى التداخل بين المدربين أو تضارب الرسائل الموجهة للجمهور، مما يضعف الأثر المهني. كما يشير النموذج إلى أهمية الانسجام بين الأسلوب المسرحي والتفاعلي، حيث يدعم كل طرف الآخر أثناء التقديم. في السياق الإداري، يُعتبر التنسيق بين الإدارات (التقنية، الموارد البشرية، الإدارة العليا) أمرًا أساسيًا لضمان سلاسة إدارة الأداء وتكامل الأدوار. يعكس هذا النموذج مبدأ العمل كفريق واحد باتجاه هدف مشترك، ويركز على خلق بيئة تواصلية محترفة ترفع من جودة الأداء التنظيمي وتقلل من الهدر الناتج عن الفوضى التنظيمية.
3. مراحل نضج المدربين حسب نموذج سيبرمان
يستعرض هذا المحور نموذج "سيبرمان" لنضج المدربين عبر خمس مراحل، ويُعد هذا النموذج مفيدًا أيضًا لفهم نضج العاملين في مجالات الأداء عامة.
يستعرض هذا المحور نموذج "سيبرمان" لنضج المدربين عبر خمس مراحل، ويُعد هذا النموذج مفيدًا أيضًا لفهم نضج العاملين في مجالات الأداء عامة.
المرحلة الأولى (المبتدئ): يركز المدرب على الإبهار بالحضور والمظهر والحركة، مع اهتمام محدود بالمحتوى.
المرحلة الثانية (النامي): يبدأ التركيز على المادة العلمية وجودتها، دون الوصول بعد إلى العمق.
المرحلة الثالثة (الماهر): يظهر التركيز على إدارة القاعة والورش والتفاعل التطبيقي.
المرحلة الرابعة (الخبير): ينقل المحتوى بعمق ويُراعي الاحتياج التدريبي للمتلقين.
المرحلة الخامسة (المُثري): يصبح المدرب منتجًا للمعرفة، يكتب وينشر ويؤثر بمنصات متعددة.
يشير النموذج إلى أن النضج المهني لا يقاس بعدد سنوات الخبرة فقط، بل بمستوى الوعي المهني والتركيز على الأفكار وليس الأشخاص. وعندما يبلغ الإنسان هذه المرحلة المتقدمة، يُصبح التنافس الإيجابي هدفًا لا صراعًا شخصيًا، مما يعزز من جودة العمل الجماعي وينقل المؤسسة إلى آفاق جديدة من النضج والكفاءة.
يشير النموذج إلى أن النضج المهني لا يقاس بعدد سنوات الخبرة فقط، بل بمستوى الوعي المهني والتركيز على الأفكار وليس الأشخاص. وعندما يبلغ الإنسان هذه المرحلة المتقدمة، يُصبح التنافس الإيجابي هدفًا لا صراعًا شخصيًا، مما يعزز من جودة العمل الجماعي وينقل المؤسسة إلى آفاق جديدة من النضج والكفاءة.
4. مفهوم إدارة الأداء الوظيفي
إدارة الأداء الوظيفي هي عملية إستراتيجية منظمة تهدف إلى توجيه موارد المؤسسة البشرية نحو تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. يُفصّل المحور الفرق بين مفهومي "الأداء" و"الإدارة":
إدارة الأداء الوظيفي هي عملية إستراتيجية منظمة تهدف إلى توجيه موارد المؤسسة البشرية نحو تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. يُفصّل المحور الفرق بين مفهومي "الأداء" و"الإدارة":
الأداء هو كل نشاط قابل للملاحظة يهدف لتحقيق نتيجة محددة، سواء قام به فرد أو فريق أو قسم.
الإدارة تعني: التخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة.
عند دمج المفهومين، تصبح إدارة الأداء أداة تجمع التخطيط للأداء، قياسه، توجيهه، وتطويره. يؤكد الضيفان على أهمية أن يكون الأداء مرتبطًا بالنتائج وليس بالأنشطة فقط، أي أن لا يكون هناك جهد مبذول دون تحقيق أهداف ملموسة.
تشير الحلقة إلى أن وجود إدارة أداء فعّالة يساهم في اكتشاف الكفاءات، توجيه الجهود، وتحفيز الموظفين عبر وضع مستهدفات واضحة منذ بداية العام، مما يؤدي إلى تحول جذري في طريقة العمل داخل المؤسسة. كما يُطرح مفهوم "التموضع الاستراتيجي"، والذي يُعنى بمواءمة أداء الأفراد مع رؤية المؤسسة ورسالتها الكبرى. وبهذا تتحول إدارة الأداء من نظام إداري روتيني إلى منظومة تمكينية، تعزز المبادرة، وتكشف الفروقات بين الموظف المجتهد والمُتقاعس.
عند دمج المفهومين، تصبح إدارة الأداء أداة تجمع التخطيط للأداء، قياسه، توجيهه، وتطويره. يؤكد الضيفان على أهمية أن يكون الأداء مرتبطًا بالنتائج وليس بالأنشطة فقط، أي أن لا يكون هناك جهد مبذول دون تحقيق أهداف ملموسة.
تشير الحلقة إلى أن وجود إدارة أداء فعّالة يساهم في اكتشاف الكفاءات، توجيه الجهود، وتحفيز الموظفين عبر وضع مستهدفات واضحة منذ بداية العام، مما يؤدي إلى تحول جذري في طريقة العمل داخل المؤسسة. كما يُطرح مفهوم "التموضع الاستراتيجي"، والذي يُعنى بمواءمة أداء الأفراد مع رؤية المؤسسة ورسالتها الكبرى. وبهذا تتحول إدارة الأداء من نظام إداري روتيني إلى منظومة تمكينية، تعزز المبادرة، وتكشف الفروقات بين الموظف المجتهد والمُتقاعس.
5. الفرق بين تقييم الأداء وإدارة الأداء
يوضح هذا المحور التباين الجوهري بين "تقييم الأداء" و"إدارة الأداء".
يوضح هذا المحور التباين الجوهري بين "تقييم الأداء" و"إدارة الأداء".
تقييم الأداء هو عملية لاحقة، تتم في نهاية العام، تعتمد على انطباعات المدير، وغالبًا ما تكون سطحية وتاريخية (ما حصل، لا ما يمكن أن يحصل).
أما إدارة الأداء فهي عملية مستمرة تبدأ من لحظة التخطيط، وتشمل المتابعة، التغذية الراجعة، والتقويم.
تقييم الأداء يُنظر إليه كأداة محاسبة، بينما تُصنّف إدارة الأداء كأداة تطوير وتحسين. يشير الحديث إلى أن التقييم التقليدي يخلق مشكلات: كالمساواة بين المجتهد والمُقصّر، وانعدام الحوافز، مما يُولّد الإحباط. في المقابل، إدارة الأداء تستند إلى بيانات وشواهد، وتُبنى على شراكة بين الموظف والمدير. كما يُبرز المحور التحوّل من العقلية "الرجعية" إلى "الاستباقية"، حيث لا تُترك الأمور للتقديرات الشخصية، بل تُحدد مسبقًا الأهداف والمخرجات المتوقعة، ويُمنح الموظف الأدوات التي تمكّنه من النجاح. في هذا السياق، تصبح إدارة الأداء عنصرًا حاسمًا للعدالة الوظيفية، ولتحقيق النمو الحقيقي داخل المؤسسات.
تقييم الأداء يُنظر إليه كأداة محاسبة، بينما تُصنّف إدارة الأداء كأداة تطوير وتحسين. يشير الحديث إلى أن التقييم التقليدي يخلق مشكلات: كالمساواة بين المجتهد والمُقصّر، وانعدام الحوافز، مما يُولّد الإحباط. في المقابل، إدارة الأداء تستند إلى بيانات وشواهد، وتُبنى على شراكة بين الموظف والمدير. كما يُبرز المحور التحوّل من العقلية "الرجعية" إلى "الاستباقية"، حيث لا تُترك الأمور للتقديرات الشخصية، بل تُحدد مسبقًا الأهداف والمخرجات المتوقعة، ويُمنح الموظف الأدوات التي تمكّنه من النجاح. في هذا السياق، تصبح إدارة الأداء عنصرًا حاسمًا للعدالة الوظيفية، ولتحقيق النمو الحقيقي داخل المؤسسات.
6. عملية التقويم وتحسين الأداء
التقويم يُعد المرحلة الناضجة من إدارة الأداء، ويمثل التحوّل من المحاسبة إلى التطوير. بخلاف التقييم، الذي يكتفي بإعطاء درجات، يركز التقويم على السؤال: "كيف نُحسّن؟". تبدأ العملية بتحديد بيان الأداء—وهو أكثر دقة من الوصف الوظيفي—إذ يوضح المهام الفعلية المرتبطة بكل موظف. يتم تحديد "الجدارات" (المعارف، المهارات، الاتجاهات)، ويُربط الأداء بهذه المعايير.
يركز هذا المحور على أهمية التخطيط الاستباقي، بحيث تتم صياغة المهام وفقًا لإمكانيات الموظف، مما يقلل من الفوضى والاحتكاك، ويقلّص الهدر. كما يناقش المحور النماذج اليابانية في توصيف الهدر مثل:
التقويم يُعد المرحلة الناضجة من إدارة الأداء، ويمثل التحوّل من المحاسبة إلى التطوير. بخلاف التقييم، الذي يكتفي بإعطاء درجات، يركز التقويم على السؤال: "كيف نُحسّن؟". تبدأ العملية بتحديد بيان الأداء—وهو أكثر دقة من الوصف الوظيفي—إذ يوضح المهام الفعلية المرتبطة بكل موظف. يتم تحديد "الجدارات" (المعارف، المهارات، الاتجاهات)، ويُربط الأداء بهذه المعايير.
يركز هذا المحور على أهمية التخطيط الاستباقي، بحيث تتم صياغة المهام وفقًا لإمكانيات الموظف، مما يقلل من الفوضى والاحتكاك، ويقلّص الهدر. كما يناقش المحور النماذج اليابانية في توصيف الهدر مثل:
Mura (عدم التناسق)
Muri (الحمل الزائد)
Muda (الهدر)
ويُشدّد على أن غياب إدارة الأداء يؤدي إلى ترك الموظفين بلا مهام واضحة، ويُثبّت المقصّرين، ويظلم المميزين. التقويم هنا لا يهدف إلى المعاقبة بل إلى رسم خطة تطوير واضحة. وإذا طُبّق المنهج الاستباقي بدقة، فإن أداء المؤسسة يتحول من العشوائية إلى الاحترافية، ويتحول المدير من مجرد رقيب إلى قائد للتطوير والتحسين.
ويُشدّد على أن غياب إدارة الأداء يؤدي إلى ترك الموظفين بلا مهام واضحة، ويُثبّت المقصّرين، ويظلم المميزين. التقويم هنا لا يهدف إلى المعاقبة بل إلى رسم خطة تطوير واضحة. وإذا طُبّق المنهج الاستباقي بدقة، فإن أداء المؤسسة يتحول من العشوائية إلى الاحترافية، ويتحول المدير من مجرد رقيب إلى قائد للتطوير والتحسين.
7. مهام المدير في إدارة الأداء
يركز هذا المحور على الدور الحيوي للمدير في إنجاح إدارة الأداء. إذ أن المدير ليس مجرد مشرف، بل هو "مهندس الأداء" الذي يُحدد المهام، يوزع الموارد، ويضمن التمكين المهني للموظفين. يوضح الحديث أن من مهام المدير الأساسية:
يركز هذا المحور على الدور الحيوي للمدير في إنجاح إدارة الأداء. إذ أن المدير ليس مجرد مشرف، بل هو "مهندس الأداء" الذي يُحدد المهام، يوزع الموارد، ويضمن التمكين المهني للموظفين. يوضح الحديث أن من مهام المدير الأساسية:
إعداد بطاقات الوصف الوظيفي
تحديد الأهداف الذكية (SMART)
صياغة بيان الأداء وجدارات كل موظف
عقد جلسات دورية للتغذية الراجعة
تنظيم جلسات مراجعة الأداء
ويُشير المتحدثان إلى أن بعض المدراء يعمدون إلى احتكار المهام و"تكديس القرود" - في إشارة رمزية إلى الأعباء التي يرفضون تفويضها. هذه السلوكيات تخلق بيئة خانقة تعيق الأداء. بالمقابل، المدير الكفء يُمارس "تفويضًا تمكينيًا"، يمنح من خلاله الموظفين مسؤوليات تناسب مهاراتهم، ويحول الإدارة إلى بيئة إنتاجية قائمة على الثقة.
تُطرح فكرة أن الموظف ضعيف الأداء لا يُلام قبل فحص مسؤولية الإدارة، من حيث وضوح الأدوار، وجود الأدوات، ومدى المتابعة. كما يُبرز المحور العلاقة بين الأداء والتمكين: فحين يُعطى الموظف مهمة فيها نوع من التحدي، تُكتشف قدراته الخفية. وفي حال استمرار تدني الأداء رغم التمكين، حينها فقط يُنظر إلى مسؤولية الموظف. الخلاصة: المدير هو أول من يُسأل عند تدني الأداء، ودوره يجب أن يتحول من مراقب إلى شريك في الإنجاز.
ويُشير المتحدثان إلى أن بعض المدراء يعمدون إلى احتكار المهام و"تكديس القرود" - في إشارة رمزية إلى الأعباء التي يرفضون تفويضها. هذه السلوكيات تخلق بيئة خانقة تعيق الأداء. بالمقابل، المدير الكفء يُمارس "تفويضًا تمكينيًا"، يمنح من خلاله الموظفين مسؤوليات تناسب مهاراتهم، ويحول الإدارة إلى بيئة إنتاجية قائمة على الثقة.
تُطرح فكرة أن الموظف ضعيف الأداء لا يُلام قبل فحص مسؤولية الإدارة، من حيث وضوح الأدوار، وجود الأدوات، ومدى المتابعة. كما يُبرز المحور العلاقة بين الأداء والتمكين: فحين يُعطى الموظف مهمة فيها نوع من التحدي، تُكتشف قدراته الخفية. وفي حال استمرار تدني الأداء رغم التمكين، حينها فقط يُنظر إلى مسؤولية الموظف. الخلاصة: المدير هو أول من يُسأل عند تدني الأداء، ودوره يجب أن يتحول من مراقب إلى شريك في الإنجاز.
8. المراحل الأساسية لإدارة الأداء
تتكوّن إدارة الأداء من ثلاث مراحل مترابطة تمثل دورة مستمرة للتحسين المهني:
تتكوّن إدارة الأداء من ثلاث مراحل مترابطة تمثل دورة مستمرة للتحسين المهني:
المرحلة الأولى: التخطيط
تبدأ هذه المرحلة بوضع أهداف واضحة ومتفق عليها، يتم تحديدها بين المدير والموظف، بحيث تكون ذكية (SMART)، وقابلة للقياس، وترتبط برؤية القسم والمؤسسة.
تبدأ هذه المرحلة بوضع أهداف واضحة ومتفق عليها، يتم تحديدها بين المدير والموظف، بحيث تكون ذكية (SMART)، وقابلة للقياس، وترتبط برؤية القسم والمؤسسة.
المرحلة الثانية: المتابعة والتغذية الراجعة
تتم خلال العام، وتتضمن تقديم ملاحظات دورية للموظف حول التقدم، بهدف التحسين لا المحاسبة. التغذية الراجعة يجب أن تكون فورية، مدعومة بشواهد، وتحمل طابعًا تشاركيًا.
تتم خلال العام، وتتضمن تقديم ملاحظات دورية للموظف حول التقدم، بهدف التحسين لا المحاسبة. التغذية الراجعة يجب أن تكون فورية، مدعومة بشواهد، وتحمل طابعًا تشاركيًا.
المرحلة الثالثة: التقييم
تُقيّم في نهاية الدورة السنوية نتائج الأداء بناء على الأدلة، مع تحليل فجوات الأداء سواء في المهارات أو التنفيذ أو الجهد.
يُشدد الضيفان على أهمية التغذية الراجعة كأداة تطويرية، حيث تُعرض في إطار إيجابي ومحترم. يُذكر نموذج "الساندويتش" لتقديم الملاحظات (مدح – نقد بنّاء – مدح)، وكذلك نموذج SBI (الوضع – السلوك – الأثر) الذي يساعد على إيصال الملاحظات بشكل موضوعي ومهني.
الرسالة الأساسية هنا هي أن الأداء لا يُقاس فقط بالنهاية، بل يُبنى عبر رحلة تشاركية تُدار باحترافية ومتابعة مستمرة. الإدارة الحديثة لا تراقب فقط، بل تُمكّن وتنمي وتطور.
تُقيّم في نهاية الدورة السنوية نتائج الأداء بناء على الأدلة، مع تحليل فجوات الأداء سواء في المهارات أو التنفيذ أو الجهد.
يُشدد الضيفان على أهمية التغذية الراجعة كأداة تطويرية، حيث تُعرض في إطار إيجابي ومحترم. يُذكر نموذج "الساندويتش" لتقديم الملاحظات (مدح – نقد بنّاء – مدح)، وكذلك نموذج SBI (الوضع – السلوك – الأثر) الذي يساعد على إيصال الملاحظات بشكل موضوعي ومهني.
الرسالة الأساسية هنا هي أن الأداء لا يُقاس فقط بالنهاية، بل يُبنى عبر رحلة تشاركية تُدار باحترافية ومتابعة مستمرة. الإدارة الحديثة لا تراقب فقط، بل تُمكّن وتنمي وتطور.
9. تطبيق بطاقة الأداء المتوازن
تُعد "بطاقة الأداء المتوازن" BSC أداة استراتيجية لتوحيد جهود الإدارات والأقسام ضمن رؤية موحدة، تتجاوز الأداء الفردي إلى الأداء التنظيمي الشامل. يقوم هذا النظام على أربعة مناظير رئيسية:
تُعد "بطاقة الأداء المتوازن" BSC أداة استراتيجية لتوحيد جهود الإدارات والأقسام ضمن رؤية موحدة، تتجاوز الأداء الفردي إلى الأداء التنظيمي الشامل. يقوم هذا النظام على أربعة مناظير رئيسية:
المنظور المالي
منظور العملاء
منظور العمليات الداخلية
منظور التعلم والنمو
يبدأ التطبيق برسم الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، ثم تُترجم إلى أهداف تشغيلية لكل إدارة وقسم، ليُربط لاحقًا أداء كل موظف بتلك الأهداف. هذا يضمن أن كل مجهود يصب في المصلحة الكبرى، ويمنع ظاهرة "الصوامع الإدارية" التي يعمل فيها كل قسم بمعزل عن الآخر.
كما ناقش الضيفان فكرة Gamification – تحويل المهام إلى ألعاب تنافسية (مثل الأوسمة، الترتيب، التحديات)، وأوضحا أنها مفيدة فقط في المؤسسات التي تعتمد هيكلًا مصفوفيًا مرنًا، لا تقليديًا بيروقراطيًا. في المؤسسات الحديثة، يُمكن ربط الأداء الفردي بمستويات (مثل أحزمة السيجما) لتحديد مواقع التحسين والتحفيز.
يؤكد المحور أن النجاح في تطبيق بطاقة الأداء المتوازن يتطلب تكاملًا بين التقنية، والموارد البشرية، والتخطيط، والإدارة العليا، ووعي الموظفين. الهدف ليس فقط تحسين الأداء، بل تحقيق تناغم تنظيمي شامل يعزز من فعالية المؤسسة واستدامة نتائجها.
يبدأ التطبيق برسم الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، ثم تُترجم إلى أهداف تشغيلية لكل إدارة وقسم، ليُربط لاحقًا أداء كل موظف بتلك الأهداف. هذا يضمن أن كل مجهود يصب في المصلحة الكبرى، ويمنع ظاهرة "الصوامع الإدارية" التي يعمل فيها كل قسم بمعزل عن الآخر.
كما ناقش الضيفان فكرة Gamification – تحويل المهام إلى ألعاب تنافسية (مثل الأوسمة، الترتيب، التحديات)، وأوضحا أنها مفيدة فقط في المؤسسات التي تعتمد هيكلًا مصفوفيًا مرنًا، لا تقليديًا بيروقراطيًا. في المؤسسات الحديثة، يُمكن ربط الأداء الفردي بمستويات (مثل أحزمة السيجما) لتحديد مواقع التحسين والتحفيز.
يؤكد المحور أن النجاح في تطبيق بطاقة الأداء المتوازن يتطلب تكاملًا بين التقنية، والموارد البشرية، والتخطيط، والإدارة العليا، ووعي الموظفين. الهدف ليس فقط تحسين الأداء، بل تحقيق تناغم تنظيمي شامل يعزز من فعالية المؤسسة واستدامة نتائجها.
10. التحديات في تطبيق إدارة الأداء
يناقش هذا المحور أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات عند تطبيق إدارة الأداء، وخاصة في البيئات التقليدية أو البيروقراطية. يتمثل التحدي الأول في المقاومة الداخلية، إذ قد يواجه المديرون وفرق العمل فكرة إدارة الأداء كأداة رقابية لا تمكينية. ويعود ذلك غالبًا لغياب الوعي بالمفهوم الحقيقي للإدارة الحديثة، الذي يُعزز التمكين والمشاركة لا التسلط.
يناقش هذا المحور أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات عند تطبيق إدارة الأداء، وخاصة في البيئات التقليدية أو البيروقراطية. يتمثل التحدي الأول في المقاومة الداخلية، إذ قد يواجه المديرون وفرق العمل فكرة إدارة الأداء كأداة رقابية لا تمكينية. ويعود ذلك غالبًا لغياب الوعي بالمفهوم الحقيقي للإدارة الحديثة، الذي يُعزز التمكين والمشاركة لا التسلط.
التحدي الثاني هو غياب البنية التقنية والتكامل بين الإدارات، فإدارة الأداء لا يمكن أن تُنفذ بنجاح باستخدام الورق أو ملفات Excel، بل تحتاج إلى نظام تقني متكامل (ERP) يربط بين التخطيط والموارد البشرية والتقنية والإدارة العليا. يُسلط الحديث الضوء على قصور بعض إدارات تقنية المعلومات في فهم دورها كـ"حلول مبتكرة"، مما يعيق التطبيق الفعّال.
التحدي الثالث هو العقلية الفردية والصوامع التنظيمية، حيث تعمل كل إدارة بمعزل عن الأخرى، ما يجعل من الصعب بناء خريطة أداء موحدة ومتكاملة. ويُشير الضيفان إلى أن الهيكل المصفوفي هو الأنسب لتطبيق إدارة الأداء الحديثة، لأنه يشجع على المرونة والتكامل والتعاون الأفقي داخل المؤسسة.
وأخيرًا، يُشدد المتحدثون على أهمية التطبيق التدريجي والمراعاة للسياق، فلا يمكن استنساخ أنظمة الشركات الصغيرة لتطبيقها مباشرة في وزارات ضخمة. فالمؤسسات بحاجة إلى استراتيجية "التروي الذكي" لضمان التدرج، والتثقيف، وبناء ثقافة الأداء تدريجيًا.
11. ربط الأهداف بالتحفيز والإنجاز
يركز هذا المحور على العلاقة الحيوية بين تحديد الأهداف المهنية، وتحقيق التحفيز الداخلي للموظف، مما يؤدي إلى إنجازات فعلية ومستدامة. يعرض المتحدثون فكرة أن غياب الأهداف الدقيقة يُفقد الموظف الشعور بالمعنى، فيما تؤدي الأهداف المبالغ فيها إلى الشعور بالإرهاق والضغط، بينما تؤدي الأهداف السهلة إلى الملل. الحل يكمن في تصميم أهداف تتجاوز قدرات الموظف بـ10% فقط، مما يخلق تحديًا إيجابيًا ومحفزًا.
يركز هذا المحور على العلاقة الحيوية بين تحديد الأهداف المهنية، وتحقيق التحفيز الداخلي للموظف، مما يؤدي إلى إنجازات فعلية ومستدامة. يعرض المتحدثون فكرة أن غياب الأهداف الدقيقة يُفقد الموظف الشعور بالمعنى، فيما تؤدي الأهداف المبالغ فيها إلى الشعور بالإرهاق والضغط، بينما تؤدي الأهداف السهلة إلى الملل. الحل يكمن في تصميم أهداف تتجاوز قدرات الموظف بـ10% فقط، مما يخلق تحديًا إيجابيًا ومحفزًا.
يشير الحديث إلى أن هذا التوازن هو ما يجعل الألعاب الرقمية ممتعة ومحفزة، وأن المفهوم ذاته يمكن نقله إلى بيئة العمل: بمعنى أن "لعبة الأهداف" تصنع الإصرار والمثابرة. كما يُبرز أن التحفيز لا يكون مجديًا دون وضوح المعايير التي يُكافأ عليها الموظف. فعندما يعرف الموظف أنه سيحصل على مكافأة مقابل تحقيق هدف معين، تتضاعف حماسته، ويشعر بالعدالة في التقدير.
تم التطرق أيضًا إلى مفاهيم مثل "موظف الشهر"، وتوضيح أنها قد لا تكون فعالة ما لم ترتبط بمعايير واضحة وموضوعية، وإلا تحوّلت إلى مصدر للغموض أو النزاع. الخلاصة هي أن الأداء المميز لا يُكافأ بالحظ أو التقدير العشوائي، بل من خلال نظام تحفيزي شفاف ومنصف، يجعل من الأداء العالي عادة وثقافة داخل المؤسسة.
12. نجاح تطبيق إدارة الأداء في بيئة العمل
يُختتم البودكاست بعرض نماذج حية لنجاح تطبيق إدارة الأداء، مع التركيز على تجربة وزارة التعليم في السعودية، التي نفّذت نظامًا مؤتمتًا بالكامل، يغطي جميع مراحل الأداء من التخطيط حتى التقييم، دون ورق. هذا التحوّل التقني أدى إلى تعزيز العدالة والشفافية، وتحقيق تكامل بين الإدارات الست الأساسية: الإدارة العليا، الموارد البشرية، التخطيط، تقنية المعلومات، المدير المباشر، والموظف.
يُختتم البودكاست بعرض نماذج حية لنجاح تطبيق إدارة الأداء، مع التركيز على تجربة وزارة التعليم في السعودية، التي نفّذت نظامًا مؤتمتًا بالكامل، يغطي جميع مراحل الأداء من التخطيط حتى التقييم، دون ورق. هذا التحوّل التقني أدى إلى تعزيز العدالة والشفافية، وتحقيق تكامل بين الإدارات الست الأساسية: الإدارة العليا، الموارد البشرية، التخطيط، تقنية المعلومات، المدير المباشر، والموظف.
كما يبرز الحديث تجربة وزارة الحج، حيث تم ربط مستويات الأداء بالمكافآت الوظيفية، مما جعل حتى أصحاب الأداء الأدنى يسعون لتحسين مستوياتهم والانخراط في فعاليات ذات قيمة. يشير الضيوف إلى أن المؤسسات الناجحة في إدارة الأداء تملك سمة مشتركة: العمل الجماعي المتكامل، حيث تشارك إدارات الموارد البشرية والتخطيط والتقنية في بناء النظام، بدلًا من العمل في جزر معزولة.
يصف المتحدثان إدارة الأداء بأنها "الدورة الدموية للمؤسسة"، إذ أن الموارد البشرية تمثل القلب، والإدارة العليا هي العقل، وتقنية المعلومات تمثل الأعصاب، والموظف هو الخلية المُنتجة. فحين تُغذى هذه الخلية بالتحفيز، والتمكين، والتقدير، تنتج بأعلى كفاءة.
الرسالة النهائية: لا يمكن تحسين الأداء إلا عندما تُدار الجهود بشراكة واعية، وتقنية فعالة، ورؤية تُمكّن لا تُراقب، وتُحفّز لا تُقصي. إدارة الأداء ليست أداة إدارية فقط، بل ثقافة وممارسة تحولية تُطلق الطاقات وتُبقي الهدر خارج المعادلة.