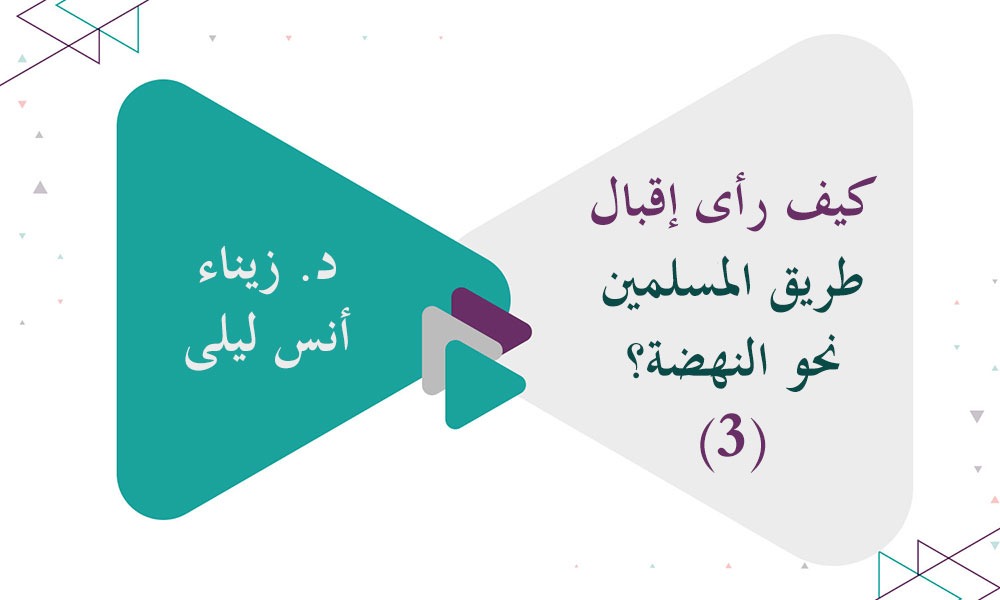لا شكّ أن مسألة الحوار في الفلسفة كانت محور نقاش في وقتنا الحالي، وظلّت إشكالًا مبهَمًا، ولا توجد إلى حدّ الآن إجابة محدّدة، خاصةً في مجال الفلسفة كونها "أمّ العلوم".
فقد كان للحوار سوابق قديمة في العصور الماضية، وأنا أركّز بشكل خاص على اليونان أكثر من العصور الوسطى والحديثة، لأنّ الفلسفة منبتها الأساسي في ذلك المكان - أثينا - وبطبيعة الحال منبت الفلاسفة الذين تعدّدت أفكارهم ونظراتهم.
فقد كان للحوار سوابق قديمة في العصور الماضية، وأنا أركّز بشكل خاص على اليونان أكثر من العصور الوسطى والحديثة، لأنّ الفلسفة منبتها الأساسي في ذلك المكان - أثينا - وبطبيعة الحال منبت الفلاسفة الذين تعدّدت أفكارهم ونظراتهم.
إنّي لا أستطيع أن أقول - أو بالأحرى - من غير المنطقي أن الفلسفة لم تستخدم أسلوب الحوار البتّة، لأنّ هذا الأسلوب يُستخدم عادةً في جميع المجالات، فما بالك بالفلسفة! ومن اليقين جدًّا أن فلاسفة اليونان استخدموا أسلوب الحوار في حياتهم اليومية وفي فلسفتهم القيّمة.
وأوجّه نظري كلّه إلى ذلك الذي أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، إنّه سقراط. ودون إطالة، سأتطرّق في هذا المقال - بحول الله - إلى مفهوم الحوار أوّلًا، ثم مفهوم الفلسفة ثانيًا، ثم مسألة الحوار في الفلسفة التي سأركّز عليها ثالثًا.
فالإشكالية المطروحة هي كالتالي:
إذا كان الحوار شاملًا لكلّ القضايا، فكيف نُفسّر قضية الحوار في الفلسفة؟
ومن هذا الإشكال نطرح مجموعة من الأسئلة، وهي:
هل للحوار شأنٌ فلسفيّ؟ وما دور الحوار في الفلسفة؟ وكيف نُفسّر أن الحوار قضية فلسفية يستخدمها الفلاسفة لمعالجة مسائلهم؟
إذا كان الحوار شاملًا لكلّ القضايا، فكيف نُفسّر قضية الحوار في الفلسفة؟
ومن هذا الإشكال نطرح مجموعة من الأسئلة، وهي:
هل للحوار شأنٌ فلسفيّ؟ وما دور الحوار في الفلسفة؟ وكيف نُفسّر أن الحوار قضية فلسفية يستخدمها الفلاسفة لمعالجة مسائلهم؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة، لا بدّ من أن نعرف مصطلح الحوار.
فالحوار لغةً: «حاور (محاورةً وحِوارًا وحَوارًا)، جادل، ناقش، باحث»(1).
ويقول ابن منظور عن الحوار: «وأصل التَّحوير في اللغة من حار يحور، وهو الرجوع، والتحوير: الترجيع»(2)، أي بمعنى «الرجوع عند الشيء والارتداد عنه»(3).
أما الحوار اصطلاحًا: {فهو لفظ عام يشمل صورًا عديدة، منها المناظرة والمجادلة}(4)، {ويراد به مراجعة الكلام والحديث بين طرفين دون أن يكون بينهما ما يدل بالضرورة على الخصومة}(5).
فالحوار لغةً: «حاور (محاورةً وحِوارًا وحَوارًا)، جادل، ناقش، باحث»(1).
ويقول ابن منظور عن الحوار: «وأصل التَّحوير في اللغة من حار يحور، وهو الرجوع، والتحوير: الترجيع»(2)، أي بمعنى «الرجوع عند الشيء والارتداد عنه»(3).
أما الحوار اصطلاحًا: {فهو لفظ عام يشمل صورًا عديدة، منها المناظرة والمجادلة}(4)، {ويراد به مراجعة الكلام والحديث بين طرفين دون أن يكون بينهما ما يدل بالضرورة على الخصومة}(5).
أما الفلسفة لغةً: {تفلسف تفلسفًا، تعاطى الفلسفة في الأمر: أبدى رأيًا حكيمًا فيه}(1).
وأما اصطلاحًا، فمن المعروف جدًّا، خاصة أننا حفظناه عن ظهر قلب، كلمة «فيلوصوفوص»، وهي كلمة متأصلة من اليونان وتعني حبّ الحكمة.
وأما اصطلاحًا، فمن المعروف جدًّا، خاصة أننا حفظناه عن ظهر قلب، كلمة «فيلوصوفوص»، وهي كلمة متأصلة من اليونان وتعني حبّ الحكمة.
فالتعريف الإجرائي للفلسفة بقولنا: إنها استشكال واستدلال؛ تستشكل المفاهيم وتردّها على شكل إشكالية، أي أزمة ومعضلة، وتجيب على هذا الاستشكال بالاستدلال، أي تستدلّ فكرتها بالحجج والبراهين، وذلك هو فعل التفلسف.
والآن، بعدما عرفنا معنى الحوار والفلسفة، سنباشر بتحديد تعريف الحوار الفلسفي.
فبما أن الفلسفة هدفها البحث عن الحقيقة، والحوار هدفه الاتفاق على رأي واحد، إذن فالتعريف الإجرائي للحوار الفلسفي هو: السعي إلى استكشاف حقيقة متفق عليها، وذلك من خلال التحاور، واستدراج الآخر بالأسئلة، ومحاولة أن يجيب عنها بحكمة، وتقديم نقد فلسفي ذي طابع بنّاء.
فبما أن الفلسفة هدفها البحث عن الحقيقة، والحوار هدفه الاتفاق على رأي واحد، إذن فالتعريف الإجرائي للحوار الفلسفي هو: السعي إلى استكشاف حقيقة متفق عليها، وذلك من خلال التحاور، واستدراج الآخر بالأسئلة، ومحاولة أن يجيب عنها بحكمة، وتقديم نقد فلسفي ذي طابع بنّاء.
وإلى هنا نستنتج أن الحوار له شأن فلسفي مرموق، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الفلسفة، أي بمعنى أن الفلسفة أداة للحوار، لأنها تركز على مقولة ديكارت: العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس.
فلو سلمنا بأن الفلسفة تحتكم إلى العقل السليم، الذي هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس، لخلصنا إلى القول مباشرةً وبلا تردد: إنها أنجع الأدوات لخلق الحوار، ورفع سوء التفاهم، وتوحيد الأفكار، ولمّ الشّتات، وتكريس الائتلاف. (6)
فلو سلمنا بأن الفلسفة تحتكم إلى العقل السليم، الذي هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس، لخلصنا إلى القول مباشرةً وبلا تردد: إنها أنجع الأدوات لخلق الحوار، ورفع سوء التفاهم، وتوحيد الأفكار، ولمّ الشّتات، وتكريس الائتلاف. (6)
فإن غاب عنصرُ التحاور في الفلسفة أفقدها قيمتَها، وانحطّت؛ فالحوار الفلسفي يرتكز على خمس معالم أساسية ورئيسية:
{ أولًا: أنه نسق مفتوح وليس مغلقًا، وبالتالي فهو يسمو بكل ما أوتي من قوة لطلب الحقيقة، وليس خاضعًا لشروط قبلية مسبقة.
ثانيًا: أنه حوار موضوعي غير ذاتي، ينطلق من أرضية ثابتة، وليس من مسلّمات قابلة للقبول والرفض.
ثالثًا: أنه قائم على الحجة والبرهان، وليس على أساس الاعتقادات والعواطف.
رابعًا: أنه إنساني ذو أبعاد عالمية، وليس محصورًا في دائرة المحلي.
خامسًا: قائم على مراعاة تكافؤ المقدرة بين الملقي والمتلقي، حتى لا تكون بسطوة المحاور على المتلقي، فيذعن لسلطان خطابه على حساب قناعته، فيكون بذلك على سبيل الإكراه، وليس على سبيل الاختيار. } (7)
{ أولًا: أنه نسق مفتوح وليس مغلقًا، وبالتالي فهو يسمو بكل ما أوتي من قوة لطلب الحقيقة، وليس خاضعًا لشروط قبلية مسبقة.
ثانيًا: أنه حوار موضوعي غير ذاتي، ينطلق من أرضية ثابتة، وليس من مسلّمات قابلة للقبول والرفض.
ثالثًا: أنه قائم على الحجة والبرهان، وليس على أساس الاعتقادات والعواطف.
رابعًا: أنه إنساني ذو أبعاد عالمية، وليس محصورًا في دائرة المحلي.
خامسًا: قائم على مراعاة تكافؤ المقدرة بين الملقي والمتلقي، حتى لا تكون بسطوة المحاور على المتلقي، فيذعن لسلطان خطابه على حساب قناعته، فيكون بذلك على سبيل الإكراه، وليس على سبيل الاختيار. } (7)
وَلأُقَدِّمَ دليلاً واضحًا على أن الحوار له شأنٌ فلسفيٌّ خاص، أخذتُ شخصية سقراط أنموذجًا، فهذه الشخصية تمتاز بالذكاء والفطنة، كونه فيلسوفًا ينتمي إلى السفسطائية التي تقوم على فنّ الإقناع والخطابة والمحاججة. استخدم سقراط أسلوب المحاورة، فكان كتاب «الجمهورية» لأفلاطون خير دليلٍ على محاوراته، فلقد كانت شفهية فقط، إلا أن تلميذه أفلاطون قام بتدوين محاوراته على شكل كتاب.
فحسب قراءتي لمقتطفات من هذا الكتاب، تبيَّن لي أن سقراط مولع حقًا بالمحاورة مع أي شخصية كانت، ويحاول استدراج خصمه، ويكون دائمًا الفائز في المحاورة، ليس لأنه يودّ المنافسة، بل لأنه يودّ أن يُنبّه الطرف الآخر إلى أشياء كان غافلًا عنها. فيستخدم بعض الأساليب حتى يُقنعه بصحة قوله أو بطلانه.
لقد لاحظتُ في بسيكولوجية سقراط الشهيرة أنه يعتمد على أسلوب التهكم، حتى يرى مستوى وعي الشخص ومحدودية فكره، ثم مباشرةً يعطي له الحجة المناسبة لإقناعه. والشيء الآخر الذي لاحظتُه في أساليبه في الحوار أنه يستخدم أسلوب ردّ السؤال بالسؤال، لا الجواب المباشر.
ومثال ذلك في محاورته مع كلوكون، باستخدامه التهكم، قائلًا:
سقراط: وهنا مقياسٌ آخر للطبيعة الفلسفية التي ستؤخذ بعين الاعتبار أيضًا...
كلوكون: ما هو ذلك؟
سقراط: يجب ألا توجد زاويةٌ للدناءة فيهم، لا شيء يمكن أن يكون أكثر خصامًا من الدناءة للروح التي تتوق لمحاكاة مجمل الأشياء الإلهية والإنسانية.
كلوكون: الأكثر حقيقةً.
سقراط: كيف يقدِر إذن الذي يمتلك دلالةً عقلية، ويكون مُشاهدًا لكل الأزمنة، وكل الوجود، أن يرى الحياة الإنسانية إلا كونها شيئًا عظيمًا؟
كلوكون: إنه لا يستطيع.
سقراط: أو يتمكن واحدٌ كهذا أن يحسب الموت مخيفًا؟
كلوكون: لا، حقًّا.
سقراط: إذن فإن ذا الطبيعة الجبانة والسافلة لا يملك جزءًا في الفلسفة الحقيقية. (8)
إذن، فالحوار في الفلسفة هنا يقوم على استراتيجيات؛ فالمباشرة في الدهشة والجهل بالمعرفة أولى المراحل، وليس سقراط وحده هو الذي استخدم هذا الأسلوب، فحتى تلميذه أفلاطون أيضًا، لكن المؤسس الحقيقي لهذه المحاورات هو العظيم سقراط. ثم الشك كثاني مرحلة، فـ{يُعتبر الشك الفلسفي هو محرّك هذا الحوار، لأن هذا الشك هو الذي يفرض علينا أن نتساءل باستمرار، بغية البحث عن أرضية ثابتة ومنطلق سليم للأشياء، ولولا الشك لتحوّل الحوار إلى دوّامة}(7). ثم التوصل إلى نتيجة متفقٍ عليها كمرحلة ثالثة، ولكن يمكن أن يكون هنالك نوع من الاستمرارية، أي إن الطرفين المتحاورين مهما طال حوارهما لن يتّفقا على حل واحد، {ولذلك فإن الحوار يستمر إلى ما لا نهاية}(7).
وختامًا، أتقدّم ببعض الخلاصات: إن الحوار حقًّا شأنٌ فلسفي، كونه أداة للتفكير النقدي البنّاء، وأيضًا أداة لتبادل المعارف والأفكار وتنمية الوعي وإثراء الرصيد الفلسفي. ولكي نتحاور، يجب أن نختار الخطاب المناسب لذلك، أي الموضوع الذي نود أن نتحاور فيه. ويساهم الحوار في الفلسفة أيضًا في نبذ العنف والتطرّف، وهذا هو الأساس بالذات.
فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمني.
قائمة المصادر والمراجع:
1. قاموس المتقن (عربي-عربي)، دار الرتب الجامعية، بيروت، لبنان، ص 235.
2. ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 1، ص 1044.
3. عماد أبو صالح، فن الحوار.
4. الرافعي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص 156.
5. أحمد بن عبد الرحمن الصويان، الحوار... أصوله المنهجية وآدابه السلوكية، دار الوطن، ص 17.
6. عبد السلام بنعبد العالي، الفلسفة أداة للحوار، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ص 7.
7. أرزقي قاسم ومحمد يحياوي، الحوار والخطاب الفلسفي، مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، المجلد 11، العدد 2 (2023)، ص 1705–1720.
8. أفلاطون، المحاورات الكاملة، الكتاب السادس، المجلد الأول (الجمهورية)، دار الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان (1994)، ص 278.